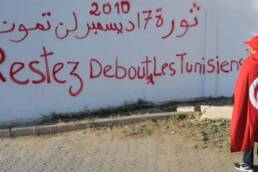المصادر:
(*) نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 451 في أيلول/سبتمبر 2016.
(**) عباس عاصي: باحث أكاديمي – لبنان.
البريد الإلكتروني: a.assilb@gmail.com
[1] أحمد بيضون، لبنان: الإصلاح المنشود والخراب المردود (بيروت: دار الساقي، 2012)، ص 107 – 108 و122.
[2] حاول الباحث إجراء مقابلات مع مروحة واسعة من الشخصيات لاستطلاع آراء مختلف الأطياف السياسية في لبنان، لذلك كانت الشخصيات التي أجرى معها المقابلات متنوعة ولا تمثل طرفاً سياسياً واحداً.
[3] انظر ورقة سليم جريصاتي البحثية المقدمة إلى: ندوة «دور رئاسة الجمهورية ودستور الطائف»، مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، آذار/مارس 2011 <http://www.if-cl.org/Library/Files/uploaded%20Files/Minbar%202011/6%20-Jraysati.pdf>.
[4] مقابلة مع المؤلف، 2 أيار/مايو 2012، بيروت، لبنان.
[5] على الرغم من الصلاحيات التي كانت ممنوحة لموقع الرئاسة في الميثاق الوطني إلا أن الرؤساء الذي حكموا لبنان لم يوظفوا هذه الصلاحيات من أجل حل النزاعات الداخلية. بل على العكس فقد كانوا في كثير من الأحيان يقفون مع طرف ضد طرف آخر.
[6] Marie-Joël Zahar, «Power Sharing in Lebanon: Foreign Protectors, Domestic Peace and Democratic Failure,» in: Philip G. Roeder and Donald S. Rothchild, eds., Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars (Ithaca, NY; London: Cornell University Press, 2005), pp. 219‑240, esp. p. 235.
[7] على سبيل المثال، اعتبر رئيس الحكومة السابق، سليم الحص، «أن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يعتبر منقوصاً أو مختل التوازن»، وذلك لأن مكوناً طائفياً أساسياً من مكونات المجتمع اللبناني مغيَّب عنه. انظر: النهار، 14/11/2006، ص 6.
[8] ورقة جريصاتي، مقدمة إلى: «دور رئاسة الجمهورية ودستور الطائف».
[9] لمناقشة أكثر تفصيـلاً لثغرات اتفاق الطائف، انظر: Nawaf Salam, «Ta’if’s Dysfunctions and the Need for Constitutional Reform,» in: Youssef M Choueiri, ed., Breaking the Cycle – Civil Wars in Lebanon (London: Centre for Lebanese Studies and Stacey International, 2007), pp. 307‑323.
[10] اعتبر اتفاق الطائف أن وجود القوات العسكرية السورية أمر ضروري لمنع نشوب حرب طائفية أخرى، على أن تنسحب هذه القوات إلى منطقة البقاع خلال سنتين من توقيع اتفاق الطائف. أما الانسحاب الكامل للقوات السورية، فقد نص الاتفاق على أن هذا الأمر تبنّته الحكومتان اللبنانية والسورية. انظر: عارف العبد، لبنان والطائف: تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 40 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011).
[11] ألبير منصور، الانقلاب على الطائف (بيروت: دار الجديد، 1993)، ص 176 – 181.
[12] على الرغم من تشكيل الحكومة اللبنانية وزارة المهجرين وصندوق المهجرين لتمويل إعادة إعمار القرى التي هجرها أهلها خلال الحرب، إلا أن الطرف الذي تسلّم هذه الوزارة والصندوق هو الحزب التقدمي الاشتراكي والذي سخّرهما لدعم مناصريه ومحازبيه، ولم يسهم في عودة النازحين المسيحيين. انظر: George Assaf and Rana el-Fil, «Resolving the Issue of War Displacement in Lebanon,» Forced Migration Review, vol. 7 (2000), pp. 31‑33.
انظر أيضاً: Rola el-Husseini, Pax Syriana: Elite Politics in Postwar Lebanon (New York: Syracuse University Press, 2012), pp. 114‑115.
[13] Farid el Khazen, «Lebanon’s First Postwar Parliamentary Election: An Imposed Choice,» Centre for Lebanese Studies (February 1998), p. 14, <http://lebanesestudies.com/wp-content/uploads/2012/04/b23a9af8.-LEBANON-N-FIRST-POSTWAR-PARLEMANTARY-ELECTION-AN-IMPOSED-Farid-el-Khazen.pdf>.
[14] Bassel Salloukh, «The Limits of Electoral Engineering in Divided Societies: Elections in Postwar Lebanon,» Canadian Journal of Political Science, vol. 39, no. 3 (September 2006), pp. 635‑655.
[15] El Khazen, Ibid., p. 14.
[16] مقابلة مع المؤلف، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لبنان.
[17] فريد الخازن، «الأحزاب السياسية في لبنان ما بعد الحرب: أحزاب تبحث عن أنصار،» مجلة الشرق الأوسط، السنة 57، العدد 4 (2003)، ص 605 – 624، خاصة ص 612. أطلق سراح جعجع في عام 2005 بعد أن وقع البرلمان على مشروع قانون عفو وصادق عليه رئيس الجمهورية في حينها، أميل لحود. وقد أعفي سمير جعجع من المحاسبة على الرغم من ارتكابه العديد من الجرائم خلال فترة الحرب الأهلية منها اغتيال الرئيس رشيد كرامي وطوني فرنجية وفرض خوّات على المناطق التي كانت تخضع لسيطرة ميليشياته وتعامله مع العدو الإسرائيلي. أيضاً حزب الكتائب اللبنانية عُرف بتعامله مع العدو الإسرائيلي وبارتكابه العديد من الجرائم خلال الحرب منها مجزرة صبرا وشاتيلا التي ذهب ضحيتها المئات من المدنيين الفلسطينيين.
[18] إن القيادات السياسية اللبنانية التي شاركت في الحرب الأهلية من المسلمين والمسيحيين لم تحاسَب بعد توقيع اتفاق الطائف ولم يكن هناك عدالة انتقالية. بل على العكس من ذلك فإن قيادات الميليشيات الذين شاركوا في الحرب عادوا واستلموا مقاليد الحكم منذ العام 1990 باستثناء بعض المحاسبات الانتقائية مثل سجن سمير جعجع، ونفي أمين الجميل وميشال عون وهذا خلق شعوراً بالغبن لدى شريحة واسعة من الطائفة المسيحية.
[19] لم تستهدف السياسة السورية في لبنان المسيحيين فقط على الرغم من تركيزها عليهم بشكل رئيسي، بل شملت كل من عارض الوجود السوري أو اعترض على السياسية السورية في الشأن اللبناني. على سبيل المثال، حرب حزب الله وحركة أمل في أواخر ثمانينيات القرن الماضي كان من أحد مسبباته الخلاف السوري مع حزب الله وتحالفه الوثيق مع إيران مما أثار مخاوف دمشق من نشوء طرف معارض لها يهدف إلى تقويض وجودها السياسي والعسكري في البلاد. لذلك شجعت ودعمت حليفتها، حركة أمل، بغية مواجهة الحزب عسكرياً وسياسياً. انظر: Raymond Hinnebusch, «Pax-Syriana? The Origins, Causes and Consequences of Syria’s Role in Lebanon,» Mediterranean Politics, vol. 3, no. 1 (1998), pp. 137‑160, esp. pp. 146‑147 and 151.
[20] Bassel Salloukh, «Democracy in Lebanon: The Primacy of the Sectarian System,» in: Nathan Brown and Emad El-Din Shahin, eds., The Struggle over Democracy in the Middle East (London: Routledge Press, 2009), pp. 134‑150, esp. 137‑138.
[21] إن دعوة التيار الوطني الحر لتعديل الدستور قائمة على فرضية أن تحقيق هذا الهدف أمر ممكن. الصحافي والإعلامي اللبناني، خالد صاغية (مقابلة مع المؤلف، 21 نيسان/أبريل 2012، بيروت، لبنان)، يوضح موقف عون، مشيراً إلى أن «هناك رؤية تعتبر أن المسيحيين باستطاعتهم أن يسترجعوا نفوذهم داخل النظام ويحمل هذه الرؤية عون. نسج عون تحالفاً مع الشيعة لأنه تاريخياً لم يصطدم معهم بل كان الصدام دائماً مع السنّة، كان الصراع مع السنّة على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأيضاً للاستفادة من الصراع السني – الشيعي لتحقيق مصالح المسيحيين».
[22] Zahar, «Power Sharing in Lebanon: Foreign Protectors, Domestic Peace and Democratic Failure,» p. 239.
[23] أسهمت عدة عوامل خارجية في إبرام اتفاق الطائف: العامل الأول هو سقوط الاتحاد السوفياتي الذي ترك العديد من حلفائه المحليين والإقليميين من دون دعم سياسي ومالي. هذا أيضاً أسهم في التخفيف من التوترات بين القوى الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) في المنطقة ما عزز إمكان توقيعه. العامل الثاني هو الاتفاق السوري الأمريكي الذي منح دمشق دعماً من المجتمع الدولي كي تفرض سلطتها على لبنان «كمكافأة» لدعمها حرب الخليج في عام 1990 ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة. انظر: عبد الله بوحبيب، الضوء الأصفر: سياسة أميركا تجاه لبنان (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1991)؛ العامل الثالث هو ضعف الحليف الإقليمي لميشال عون، أي نظام صدام حسين، بعد أن شنت عليه الولايات المتحدة الحرب عام 1990. العامل الرابع هو سعي السعودية إلى الحفاظ على نفوذها في البلاد خوفاً من هيمنةٍ سوريةٍ مطلقة عليه. لذلك فإن القمة العربية التي عقدت في الدار البيضاء، المغرب، في عام 1989 شكلت اللجنة الثلاثية العربية العليا التي كانت تتألف من الملك فهد (السعودية)، الملك الحسن الثاني (المغرب)، والرئيس الشاذلي بن جديد (لجزائر)، من أجل إيجاد حل للأزمة اللبنانية. وقد كان جلياً التدخل السعودي بعد توقيع الطائف من خلال وعدها بدعم لبنان بالمساعدات المالية وانخراط حليفها، رفيق الحريري، في الحياة السياسية اللبنانية. انظر: Michael Kerr, Imposing Power-sharing: Conflict and Coexistence in Northern Ireland and Lebanon (Dublin; Portland, OR: Irish Academic Press, 2006), p. 169.
[24] ألبير منصور، موت جمهورية (بيروت: دار الجديد، 1994)، ص 215 – 238.
[25] El-Husseini, Pax Syriana: Elite Politics in Postwar Lebanon.
[26] مقابلة مع المؤلف، 12 نيسان/ابريل2012، بيروت، لبنان.
[27] مقابلة مع المؤلف، 2 أيار/مايو 2012، بيروت، لبنان. حرب الإلغاء هي حرب عون وجعجع، أما حرب التحرير فهي حرب ميشال عون ضد القوات العسكرية السورية.
[28] مقابلة مع المؤلف، 8 و15 أيار/مايو 2012، بيروت، لبنان.
[29] كان حزب الله وحلفاؤه يستحوذون على ثلثي المقاعد في الحكومة التي كان يرأسها تيار المستقبل عام 2011.
[30] مقابلة مع المؤلف، 21 نيسان/أبريل 2012، بيروت، لبنان.
[31] مقابلة مع المؤلف، 8 و15 ايار/مايو 2012، بيروت، لبنان.
[32] بول سالم، «لبنان والأزمة السورية: تداعيات ومخاطر،» مركز كارنيغي للشرق الأوسط (كانون الأول/ديسمبر 2012)، <http://carnegie-mec.org/publications/?fa=50324>.
[33] على سبيل المثال، تم إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009 على أساس قانون انتخابي لم يؤمن تمثيـلاً حقيقياً للشعب اللبناني. فقد تم اعتماد القانون الانتخابي لعام 1960، الذي يستند إلى القضاء كدائرة انتخابية. كان من أبرز مؤيدي هذا القانون الأطراف المسيحية لأن الطائفة المسيحية منتشرة بأعداد صغيرة في العديد من المناطق، وقانون انتخابي على أساس الدوائر الكبيرة، أي المحافظة، قد يجبر المرشحين للانتخابات على الامتثال لمصالح وطلبات الطائفة الأكبر في الدائرة الانتخابية، ما يمنع من إيصال الصوت المسيحي إلى الندوة البرلمانية. إن أغلب الأحزاب السياسية التي كان من المفترض أن تقود عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الانتقال إلى نظام غير طائفي لم تعترض على هذا القانون الانتخابي لأنه يضمن لهم الفوز في الانتخابات. إن اعتماد القضاء كدائرة انتخابية سمح للمرشحين ببناء علاقات زبونية مع الناخبين واعتماد خطاب طائفي لاستقطاب أبناء الطائفة الأكبر في الدائرة الانتخابية. انظر: Simon Haddad, «The Political Consequences of Electoral Laws in Fragmented Societies: Lebanon’s 2009 Elections,» Journal of Social, Political, and Economic Studies, vol. 35, no. 1 (Spring 2010), pp. 45‑78.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.