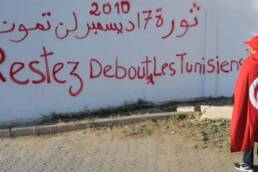مقدمة
في ظلّ هيمنة العولمة الثقافيّة والاقتصاديّة، تتعرّض اللغة العربيّة في لبنان – كما في سائر البلدان العربيّة – لضغوط متزايدة، وخصوصًا في المؤسّسات التعليميّة الخاصّة التي تعتمد على تعدّديّة لغويّة. وتمثّل المدارس نموذجًا صارخًا لهذا الواقع، إذ تُدرَّس فيها ثلاث لغات منذ الحضانة: العربيّة، والفرنسيّة، والإنكليزيّة، في توازن نظريّ لا ينعكس دائمًا على أرض الواقع.
تُطرح في هذا السّياق إشكاليّة جوهريّة: كيف يمكن اللغة العربيّة أن تحافظ على هوّيّة الإنسان في نظام تعليميّ تهيمن عليه اللغات الأجنبيّة؟ وهل يُمكن الإدارات التربويّة أن تنهض بدور فعّال في تعزيز مكانة اللغة العربيّة، عبر سياسات واضحة وخطط تعليميّة حديثة؟ وهل يتمّ إعداد المعلّمين والمؤسّسات التربويّة بما يكفي لمواجهة هذا التحدّي؟
يثير هذا الواقع مجموعة من التساؤلات التي تتعلّق بمكانة اللغة الأمّ في المنظومة التعليميّة، وبدور المدرسة كمؤسّسة تساهم إمّا في حفظ الهوّيّة اللغويّة، وإمّا في إذابتها داخل فضاء تربويّ متعدّد اللغات والثقافات. ولا يخفى أنّ تهميش اللغة العربيّة، سواء عن قصد أو بحكم الواقع، قد يساهم في زعزعة الانتماء الثقافي للتّلميذ، ويفرض قطيعة بينه وبين موروثه الحضاريّ.
من هنا تنبع أهمّيّة هذا المقال، إذ يحاول تقديم قراءة علميّة معمّقة لدور اللغة العربيّة، عبر تحليل السّياسات التربويّة، في الحفاظ على الهوّيّة اللغويّة وتعزيزها. وتسعى كذلك إلى اقتراح توصيات قابلة للتّنفيذ، وتهدف إلى إعادة الاعتبار للّغة العربيّة كلغة حيّة، تعليمًا وتفكيرًا وهوّيّةً.
أولًا: اللغة العربيّة بين التحدّي التربويّ والرّهان الهوّيّاتي
رغم أنّ اللغة العربيّة تحتلّ المرتبة الخامسة عالميًّا من حيث عدد المتحدّثين الأصليّين، بحسب تقرير اليونسكو[1]، فإنّ مكانتها في الأنظمة التعليميّة لا تعكس هذا الحضور الدوليّ، وخصوصًا في البلدان العربيّة التي يشهد نظامها التربويّ تغليبًا للّغات الأجنبيّة. ففي لبنان، حيث تنتشر المدارس الخاصّة، تُدرّس ثلاث لغات منذ الطّفولة المبكرة، وهو ما يخلق ازدواجيّة لغويّة قد تتحوّل إلى صراع هوّيّاتي لا غنى ثقافي.
تُظهر دراسة أعدّها المركز التربويّ للبحوث والإنماء في لبنان[2] أنّ هذه الازدواجيّة غير المتوازنة تؤثّر سلبًا في التحصيل الدراسيّ، إذ يواجه الكثير من التلامذة صعوبة في استيعاب المفاهيم العلميّة عندما تُقدّم بلغة أجنبيّة، لا تتوافق مع بيئتهم اللغويّة المنزليّة التي تعتمد غالبًا العربيّة. كما تؤكد دراسة تربويّة صادرة من الجامعة اللبنانية[3] أنّ 70 بالمئة من تلامذة المدارس الخاصّة يعدّون اللغة الأجنبيّة أداة للنّجاح والانفتاح، في حين ترتبط اللغة العربيّة في وعيهم بالمادّة الصّعبة أو الجامدة، وهو ما يدلّ على خلل في الصّورة الذهنيّة للّغة الأمّ. من جهة أخرى، تشير تقييمات حديثة إلى أنّ أحد أسباب هذا التراجع يعود إلى ضعف تأهيل معلّمي اللغة العربيّة. فبحسب تقرير «عرب تربويون بلا حدود»[4]، فإنّ 40 بالمئة من أساتذة اللغة العربيّة في المدارس الخاصّة لم يتلقّوا تدريبًا متخصّصًا حديثًا، بل يستندون إلى طرائق تقليديّة ترتكز على الإملاء والنّحو، وهو ما يجعل التعلّم أقلّ جاذبيّة مقارنة بأساليب تعليم اللغات الأجنبيّة المبنيّة على التفاعل والتقنيات الحديثة. وإذ نتأمل في التحوّل الرّقميّ الذي اجتاح العمليّة التعليميّة، تبرز مشكلة إضافيّة تتعلّق بـ«الهوّة الرّقميّة اللغويّة»، حيث تُوظَّف التطبيقات الذكيّة والمنصّات التفاعليّة لتدريس الفرنسيّة والإنكليزيّة، في حين تبقى اللغة العربيّة رهينة الوسائل التقليديّة. ويُشير تقرير للبنك الدولي[5] إلى أنّ هذا التفاوت في توظيف التكنولوجيا يساهم في تحديد الفارق بين العربيّة واللغات الأجنبيّة في وجدان المتعلّم.
من هنا، فإنّ تحدّي اللغة العربيّة في المدارس التي تعتمد تدريس اللغات الثلاث لا يتمثل بعدد الحصص أو المناهج فقط، بل بالتمثّل الثقافي والمعرفي الذي تبنيه المدرسة لدى المتعلّم، وبالسّياسات التربويّة التي يجب أن تعيد للعربيّة دورها بوصفها لغة حياة وهوّيّة، لا مجرد أداة تقويم أو ذاكرة ماضٍ.
تُعدّ اللغة إحدى الرّكائز الأساسيّة في تكوين شخصيّة الإنسان، كونها الأداة التي يعبّر بها الفرد عن ذاته ويفهم من خلالها محيطه؛ فاللغة ليست مجرّد وسيلة للتّواصل، بل هي أداة تفكير وتشكيل للهوّيّة الثقافيّة والانتماء الحضاري. وقد أشار عبد القاهر الجرجانيّ، أحد أعلام البلاغة العربيّة، إلى أنّ «النّظم ليس في ترتيب الكلمات وفق النّحو فحسب، بل في حسن وضعها في موضعها المناسب، ممّا يعكس البعد الوظيفيّ للّغة، الذي يتجاوز القواعد نحو المعنى والدلالة»[6].
من هذا المنطلق، تتميّز اللغة العربيّة، لغة الضّادّ، بثرائها المعجميّ والصّرفيّ، وبقدرتها العالية على التعبير عن أدقّ المعاني والانفعالات. غير أنّ هذه اللغة تواجه في العصر الحديث تراجعًا في مكانتها العمليّة، وخصوصًا داخل الأطر التعليميّة المتعدّدة اللغات، حيث تُقصى تدريجًّا عن مواقع الفاعليّة لمصلحة اللغات الأجنبيّة، في ظلّ تصوّرات تربويّة واقتصاديّة ترى في الإنكليزيّة والفرنسيّة بوّابة للنّجاح والتفوّق.
ويُمثّل النّظام التعليمي الثلاثي في المدارس اللبنانيّة نموذجًا واضحًا لهذا التحدّي، فهو يخلق بيئة تعليميّة غنيّة لغويًّا ولكنّها في الوقت نفسه غير متوازنة. ففي كثير من الأحيان، تكون الأولويّة للّغات الأجنبيّة من حيث عدد السّاعات، ونوعيّة الموارد، وأسلوب التقييم، في حين تبقى العربيّة في موقع ثانويّ لا يتناسب مع دورها كلغة وطنيّة ورسميّة.
بيّنت دراسات سابقة[7]، أنّ تراجع العربيّة في مثل هذه البيئات لا يعود إلى التلاميذ أو الأهالي فحسب، بل يرتبط أيضًا بغياب استراتيجيات مؤسّسيّة واضحة تدعم هذه اللغة على المستوى التربويّ والإداري؛ ففي لبنان، رغم أنّ المدارس تنتمي تاريخيًّا إلى البيئة الثقافيّة العربيّة، فإنّها في بعض الحالات تعتمد رؤية تربويّة غربيّة الهدف، تتبنّى اللغة الأجنبيّة كلغة تفكير وأداة ثقافيّة رئيسيّة.
يدفعنا هذا الواقع إلى النّظر بعمق في بنية هذه المدارس، التي تنتشر في مختلف الأقضية اللبنانيّة، وتقدّم نموذجًا تربويًّا يجمع بين التقاليد والبرامج العالميّة، وخصوصًا تلك المستندة إلى اللغة الإنكليزيّة. تخلق هذه البيئة المتعدّدة الثقافات واللغات فرصًا تعليميّة واسعة، لكنّها في الوقت نفسه تُربك التلميذ وتضعه أمام ازدواجيّة لغويّة قد تُضعف انتماءه اللغويّ والثقافي.
تُعدّ التعدّديّة اللغويّة رصيدًا فكريًّا وثقافيًّا مهمًّا، إذ تتيح للمتعلّم الاطلاع على حضارات متعدّدة وتوسّع في أفق معرفي. غير أنّها تتحوّل إلى خطر على اللغة الأمّ إذا لم تُحكم إدارتها ضمن رؤية تربويّة متوازنة. وقد عبّر المهاتما غاندي عن هذا المأزق حين قال: «أفتح نوافذي لكلّ الثقافات، لكنّني أرفض أن أذوب فيها»، مشيرًا بذلك إلى أهمّيّة الانفتاح من دون الذوبان، والحفاظ على الذات اللغويّة والثقافيّة.
إنّ عدم وجود خطّة لغويّة واضحة في المدارس الثلاثيّة اللغة يؤدي إلى ارتباك في وظائف اللغات، ويؤثّر سلبًا في أداء التلميذ وهوّيّته. فالثنائيّة أو الثلاثيّة اللغويّة لا تكون غنًى معرفيًّا إلّا إذا تمّ ضبط استخدام كل لغة بحسب دورها: لغة تفكير، لغة تواصل، أو لغة تخصّص.
في ظلّ هذا المشهد، يبرز دور الإدارة التربويّة كعنصر حاسم في إعادة الاعتبار للّغة العربيّة. فتبنّي سياسة لغويّة واضحة من جانب الإدارة، وتوفير مناهج متكاملة تنمّي المهارات اللغويّة للمتعلّم شفويًّا وكتابيًّا، إضافة إلى دعم التكوين المستمرّ للمعلّمين، وتوفير الوسائل التربويّة الحديثة، كلّها مكوّنات أساسيّة في استعادة مكانة اللغة العربيّة.
كما يُعدّ التنسيق التربوي وسيلة لضمان التناسق الأفقيّ والعموديّ بين المراحل الدراسيّة المختلفة، ويمثّل الإشراف التربويّ رافعة أساسيّة لتحسين الأداء التربويّ وضمان جودة التدريس. وقد أظهرت دراسات تربويّة[8] أنّ الإشراف البنّاء والتشاركيّ يساهم في رفع مستوى تحصيل الطلّاب، شرط أن يكون هدفه تطويريًّا لا رقابيًّا وأن يحفظ هوّيّة الإنسان.
من جهة أخرى، تؤدي الوسائل التعليميّة والتكنولوجيا دورًا محوريًّا في تجديد تعليم اللغة. فاللوحات الذكيّة، والمحتويات الرّقميّة، والتطبيقات التعليميّة الحديثة، تساهم في تحفيز المتعلّمين وزيادة تفاعلهم. غير أنّ اللغة العربيّة غالبًا ما تُحرم من هذه الوسائل، في ظلّ تركيز الاستثمارات التكنولوجيّة على اللغات الأجنبيّة. وتدعو الاتّجاهات التربويّة الحديثة إلى دمج «الوسائط المتعدّدة» في تعليم العربيّة، وتطوير محتوى رقميّ يتمشَّى مع سياقات الحياة اليوميّة، ما يساهم في جعل العربيّة أكثر قربًا إلى عقل المتعلّم ووجدانه.
بناءً عليه، فإنّ النّهوض باللغة العربيّة لا يقتصر على تطوير المنهاج أو تغيير الكتب، بل يتطلّب رؤية مؤسّسيّة متكاملة، تشمل السّياسات، والإدارات، والإشراف، والتقويم، وتسعى إلى بناء علاقة إيجابيّة بين التلميذ ولغته الأمّ، ليس بوصفها أداة تعليم وحسب، بل بوصفها وعاء للهوّيّة والانتماء أيضًا.
ثانيًا: نتائج ميدانيّة: بين الخطاب التربوي والممارسة الفعليّة
كشفت النّتائج من خلال تحليل الاستبيانات والمقابلات الميدانيّة عن فجوة واضحة بين الخطاب التربويّ الرّسميّ الذي يؤكّد المساواة بين اللغات الثلاث، والممارسة التربويّة اليوميّة التي تُهمّش اللغة العربيّة لمصلحة اللغتين الفرنسيّة والإنكليزيّة. وقد شملت العيّنة عددًا من المدارس التي تعتمد اللغات الثلاث موزّعة على عدّة أقضية لبنانيّة، بحيث أُجريت مقابلات مع رؤساء المدارس، ورؤساء الأقسام، ومنسّقي اللغة العربيّة، والمعلّمين العاملين في الحلقة الأولى والثانية من التعليم الأساسيّ. تبيّن من خلال المعالجة الإحصائيّة النّوعيّة والكمّية أنّ اللغة العربيّة لا تحظى بالدعم المؤسّسي نفسه الذي تحظى به اللغات الأجنبيّة، إذ غالبًا ما يُنظر إليها على أنّها مادّة إلزاميّة أكثر منها لغة حياة وتفكير وتعبير. يظهر هذا التوجّه في التوزيع غير العادل للحصص الأسبوعيّة، حيث تحصل اللغة العربيّة في معظم الأحيان على أقلّ عدد من السّاعات مقارنة بالإنكليزيّة والفرنسيّة، وهو ما يحدّ من فرص التعلّم المتراكم ويؤثّر سلبًا في الكفاءة اللغويّة لدى المتعلّمين. كما أظهرت البيانات المستخلصة من الاستبيانات ضعفًا في مستوى التنسيق الإداريّ والبيداغوجيّ الخاصّ باللغة العربيّة. وعلى الرغم من وجود منسّقين للّغة العربيّة في معظم المدارس، فإنّ دورهم غالبًا ما يكون شكليًّا، من دون خطط متابعة أو آليات تقييم فعليّة للأداء اللغويّ أو التربويّ. أضف إلى ذلك أنّ المعلّمين أنفسهم أشاروا في عدد من المقابلات إلى عدم وجود منصّات حقيقيّة للتّدريب المهنيّ المستمرّ في مجال طرائق تدريس اللغة العربيّة، وهو ما يجعل جهودهم متفرّقة، غير مبنيّة على ممارسات علميّة حديثة.
في السّياق نفسه، تمّ تسجيل تباين كبير في توظيف الوسائل التعليميّة؛ فقد تبيّن أنّ أغلب المدارس توظّف الوسائل التكنولوجيّة المتقدّمة في تعليم اللغات الأجنبيّة، مثل اللوحات التفاعليّة، وتطبيقات المحادثة، والألعاب الرّقميّة، بينما يقتصر تعليم اللغة العربيّة في كثير من الأحيان على الكتاب المدرسيّ فقط، من دون توظيف أدوات داعمة أو محتوى متجدّد يواكب حاجات الجيل الرّقميّ. وقد عبّر المعلّمون عن إحباطهم من هذا التفاوت، إذ يؤكّد بعضهم أنّ اللغة العربيّة «تُعامل كعبء» لا كمجال إبداع. أمّا من ناحية المتعلّمين، فقد برز توجّه عام نحو حسبان اللغة العربيّة أقلّ حيويّة وأهمّيّة من اللغات الأجنبيّة، وخصوصًا الإنكليزيّة. وقد ربط بعض التلامذة وأولياء الأمور اللغة الأجنبيّة بمستقبل مهنيّ أفضل، بينما ارتبطت اللغة العربيّة في أذهانهم بالصّعوبة والنّحو والحفظ، لا بالإبداع والانفتاح. هذا التصوّر يعكس أزمة هوّيّة لغويّة، ويعزّز القطيعة مع اللغة الأمّ، وخصوصًا في غياب دعم مجتمعيّ أو إعلاميّ يربط العربيّة بالتقدّم والتكنولوجيا. ومن النّتائج اللافتة للنظر أيضًا، أنّ دور الإشراف التربويّ يكاد يكون غائبًا في ما يتعلّق بتقييم اللغة العربيّة وتطوير تعليمها. فبعض المدارس لا تخصّص مشرفًا فعليًّا لهذا المجال، أو تُسند هذه المهمّة إلى أفراد غير مختصّين، ما يُحرم العمليّة التعليميّة من التوجيه الأكاديميّ المطلوب، ويؤثّر في جودة المخرجات التعليميّة. كما أظهرت النّتائج أنّ العلاقة بين المشرفين والمعلّمين تتسمّ بالبيروقراطيّة أكثر من التفاعل البنّاء، وهو ما يحدّ من فاعليّة المبادرات الداخليّة.
إلى جانب ذلك، تُظهر بعض المقابلات مع المديرين وذوي القرار أنّ هناك فجوة مفاهيميّة في فهم أهمّيّة اللغة العربيّة كمكوّن ثقافيّ واستراتيجيّ، إذ تكرّر في عدد من الإفادات أنّ «العربيّة موجودة لأنّها إلزاميّة من جانب وزارة التربية»، بينما يتوجّه الجهد الأساسيّ إلى دعم اللغات الأجنبيّة التي تُعَدّ «بوابة العالم». تُضعف هذه الرّؤية الإيمان الداخليّ برسالة اللغة العربيّة، وتحوّلها إلى عبء إداريّ لا إلى مشروع تربويّ هوّيّاتي. ومن النّاحية الاجتماعيّة، سجّل عدد من المعلّمين صعوبات في إيصال مضمون اللغة العربيّة إلى المتعلّمين بسبب الفجوة بين اللغة المعياريّة، أي الفصحى، واللغة المحكيّة التي يستخدمها الأطفال في حياتهم اليوميّة. وأشار البعض إلى الحاجة إلى تطوير استراتيجيّات تعليميّة تجعل من العربيّة الفصحى لغة قريبة، مرنة، وحاضرة في سياقات واقعيّة، عوضًا من تقديمها كقالب جامد ومنفصل عن الحياة.
وفي ضوء هذه النّتائج، يمكن القول إنّ ضاد الهوّيّة تعاني تهميشًا مؤسّسيًّا وثقافيًّا في آن. فهي لا تُدرّس كأداة تمكين لغويّ وهوّيّاتي، بل كمادة تُنجز لتلبية متطلّبات رسميّة. ولكي تستعيد العربيّة موقعها الحيويّ، لا بد من مراجعة شاملة للبنية التربويّة: انطلاقًا من رؤية القيادة المدرسيّة، ومرورًا بتأهيل المعلّم، وانتهاءً بمشاركة المتعلّم نفسه في إنتاج لغته والتعبير عنها بطرائق حديثة. إنّ هذه التحديات، وإن بدت بنيويّة، قابلة للتّجاوز عبر خطّة لغويّة متكاملة، تشمل تعزيز تدريب المعلّمين، وتمكين المنسّقين، وتوظيف الوسائل التكنولوجيّة، وإشراك التلاميذ في أنشطة إبداعيّة باللغة العربيّة، وخلق بيئة داعمة تؤمن بأنّ العربيّة ليست فقط لغة ماضٍ بل لغة مستقبل أيضًا. وعليه، فإنّ الاستثمار الحقيقيّ في اللغة العربيّة داخل بعض المدارس يبدأ أوّلًا بالاعتراف بأنّها مكوّن أصيل من مكوّنات الهوّيّة التربويّة اللبنانيّة.
ثالثًا: التوصيات
بعد التحدّث عمّا تواجهه لغة الضّاد مع اللغات الأجنبيّة، لا بدّ من عرض بعض التوصيات.
يسلّط المقال الضّوء على ضرورة إعادة تقييم مكانة العربيّة في المناهج التعليميّة وتعزيز ارتباط الطّلّاب بجذورهم الثقافية. لذا، فإنّ التوصيات الآتية تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربيّة:
– تعزيز الهوّيّة الثقافيّة من خلال إبراز أهمّيّة اللغة العربيّة: يجب أن تُقدّم اللغة العربيّة كجزء أساسي من الهوّيّة الثقافيّة والوطنيّة، وهو ما يعزّز ارتباط الطلّاب بجذورهم وتقاليدهم.
– الأنشطة الثقافيّة: تنظيم فعاليّات مثل أيّام اللغة العربيّة والمسابقات الأدبيّة والشّعريّة لتعزيز الشّعور بالفخر باللغة والهوّيّة.
– مواجهة تأثير اللغات الأجنبيّة: تطوير منهج تعليميّ يوازن بين تعليم اللغات الأجنبيّة، الإنكليزيّة والفرنسيّة، وتعليم اللغة العربيّة، بحيث لا تكون العربيّة في مرتبة ثانويّة.
– التوعية بأهمّيّة العربيّة: تقديم برامج توعية إلى أولياء الأمور والطلّاب حول أهمّيّة الحفاظ على اللغة العربيّة في ظلّ العولمة اللغويّة.
– تحسين جودة التعليم للّغة العربيّة: تحديث المناهج التعليميّة لتكون جذّابة وعصريّة، مع التركيز على استخدام استراتيجيّات حديثة مثل التعلّم التفاعليّ والتكنولوجيا التعليميّة.
– تدريب المعلمين: توفير برامج تدريبيّة مستمرّة للمعلّمين لتطوير مهاراتهم في تدريس اللغة بأساليب مبتكرة.
– دور الإدارة المدرسيّة: يجب أن تتبنّى الإدارة المدرسيّة رؤية واضحة لتعزيز مكانة اللغة العربيّة كجزء من الهوّيّة الثقافيّة للطّلّاب.
– التنسيق والإشراف: تعيين منسّقين متخصّصين ومشرفين تربويّين لدعم تعليم اللغة العربيّة وضمان جودتها.
– تعزيز التخطيط التربويّ: وضع خطط طويلة الأمد للحفاظ على موقع اللغة العربيّة في المدارس، مع متابعة مستمرّة لتحقيق الأهداف المحدّدة. كذلك قياس تقدّم الطّلّاب دوريًّا باستخدام أدوات تقييم متطوّرة لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.
– إشراك المجتمع المحليّ: التعاون مع المؤسّسات الثقافيّة والتعليميّة الأخرى لتعزيز مكانة اللغة العربيّة. وإشراك أولياء الأمور في دعم تعلّم اللغة من خلال توفير موارد تعليميّة تُستخدم في المنزل.
– مواجهة التحدّيات اللغويّة: معالجة الصّعوبات التي تواجه الطّلّاب في تعلّم قواعد النّحو والصّرف بطرائق مبسّطة ومشوّقة، والتغلب على تأثير العولمة اللغويّة عبر تعزيز الهوّيّة الثقافيّة من خلال تعليم اللغة.
– الإفادة من التكنولوجيا: إدخال وسائل تعليميّة رقميّة وتطبيقات مبتكرة لتحفيز الطّلّاب على تعلّم اللغة العربيّة بطريقة ممتعة وفعّالة.
خاتمة
يظلّ مستقبل اللغة العربيّة في العالم بعامّةٍ وفي لبنان بخاصّةٍ مرهونًا بمدى وعي المجتمع بأهمّيّة هذه اللغة، وبقدرة جميع الأطراف المعنيّة على العمل المشترك من أجل صونها وتعزيز حضورها في الحياة اليوميّة والتربويّة. فالمسؤوليّة لا تقع على عاتق الإدارات التربويّة وحدها، بل تتوزّع بين الأسرة، والمعلّم، وصانع القرار، ووسائل الإعلام، وكل من له دور في تكوين الوعيّ للأجيال الصّاعدة. اللغة العربيّة ليست مجرد وسيلة للتّواصل أو مادة دراسيّة عابرة، بل هي الوعاء الذي يحمل ذاكرة الأمّة، ويجسد هوّيّتها، ويمنحها القدرة على التعبير عن ذاتها في عالم سريع التحول. في ظلّ التحدّيات التي تفرضها العولمة، وتنامي حضور اللغات الأجنبيّة في النّظام التربويّ اللبنانيّ، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة الاعتبار للّغة العربيّة، لا بوصفها لغة رسميّة فقط، بل كونها ركيزة أساسيّة للهوّيّة الثقافيّة والوطنيّة أيضًا.
الحفاظ على «ضادّ الهوّيّة» يتجاوز حدود الواجب التربويّ، ليصبح ضرورة وجوديّة وثقافيّة، تفرض علينا جميعًا أن نغرس في نفوس أبنائنا حبّ اللغة العربيّة، ونشجّعهم على استخدامها في مختلف جوانب حياتهم، سواء في المدرسة أو في البيت أو في الفضاء الرّقميّ. فالعربيّة ليست لغة الماضي فحسب، بل هي لغة الحاضر والمستقبل، القادرة على مواكبة التطوّر والانفتاح، إذا ما أُحسن تعليمها وتقديمها للأجيال الجديدة بروح معاصرة. يمثل تطوير المناهج التعليميّة لتكون أكثر جاذبيّة وارتباطًا بواقع المتعلّمين، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدريس العربيّة، مدخلًا أساسيًّا لاستعادة مكانة هذه اللغة في النّظام التربويّ. فحين تصبح العربيّة لغة تفاعل وإبداع، لا مجرد مادّة للحفظ والتلقين، يزداد ارتباط الطلّاب بها، ويشعرون بأنّها تعبّر عن هوّيّتهم وتلبي حاجاتهم الفكريّة والثقافيّة. كما أنّ تعزيز دور الإدارة التربويّة في رسم سياسات لغويّة واضحة، وتوفير بيئة تعليميّة داعمة، يساهم في ترسيخ مكانة العربيّة كلغة حياة وهوّيّة، لا مجرد أداة تقويم أو ذاكرة ماضٍ. ولا يمكن إغفال أهمّيّة المعلّم في هذه المعادلة، إذ يبقى هو العنصر المحوريّ في نقل حبّ اللغة إلى الطلّاب، وفي بناء علاقة إيجابيّة بينهم وبين لغتهم الأمّ. فالمعلّم الذي يؤمن برسالة العربيّة، ويجدد أدواته باستمرار، ويبتكر في أساليب تدريسه، قادر على أن يجعل من العربيّة لغة قريبة من وجدان الطلّاب، ووسيلة للتّعبير عن أفكارهم وأحلامهم. كما أنّ إشراك الطلّاب في أنشطة إبداعيّة وثقافيّة باللغة العربيّة، وتنظيم فعاليّات ومسابقات أدبيّة وشعريّة، يعزّز شعورهم بالفخر والانتماء، ويجعل من العربيّة جزءًا حيًّا من حياتهم اليوميّة.
تتطلّب استعادة مكانة اللغة العربيّة في لبنان أيضًا تغيير الصّورة الذهنيّة السّائدة عنها، التي غالبًا ما تربطها بالصّعوبة أو الجمود، في مقابل ربط اللغات الأجنبيّة بالنّجاح والانفتاح. تحتاج هذه الصّورة إلى تصحيح عبر جهود إعلاميّة وثقافيّة متكاملة، تبرز العربيّة كلغة علم وإبداع، قادرة على مواكبة العصر والانفتاح على العالم من دون أن تذوب فيه. فالعربيّة لغة الحضارة والتاريخ، وهي في الوقت نفسه لغة المستقبل، إذا ما أُحسن استثمار طاقاتها وتطوير محتواها الرّقميّ والتعليميّ. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التعدّديّة اللغويّة في لبنان، رغم ما تطرحه من تحدّيات، يمكن أن تكون مصدر غنى إذا أُديرت بحكمة ورؤية متوازنة. فليس المطلوب إقصاء اللغات الأجنبيّة أو التقليل من أهمّيّتها، بل المطلوب هو تحقيق توازن حقيقيّ يضمن لكل لغة دورها ووظيفتها، من دون أن يكون ذلك على حساب اللغة الأمّ. الانفتاح على العالم لا يعني التخلي عن الذات، بل يتطلّب تعزيز الجذور والانطلاق منها بثقة نحو آفاق أرحب. إنّ تعزيز اللغة العربيّة في النّظام التربويّ اللبنانيّ هو استثمار في مستقبل لبنان، وفي مستقبل الأمة العربيّة بأكملها. إنّه استثمار في الهوّيّة، وفي الثقافة، وفي المعرفة، وفي التقدم؛ فحين نمنح العربية مكانتها اللائقة في المدرسة والمجتمع، نمنح أبناءنا القدرة على التفكير الحرّ، والتعبير الأصيل، والانتماء الواعي إلى وطنهم وأمّتهم. وحين نغرس فيهم حبّ العربيّة، نغرس فيهم روح الإبداع، ونفتح أمامهم أبواب المستقبل بثقة واعتزاز. ولعلّ كلمات وديع عقل الذي تغنّى باللغة العربيّة وأكدّ أهمّيّتها، تلهمنا جميعًا لنواصل هذا الجهد، ونجعل من العربيّة لغة حياة وإبداع، لا مجرد ذكرى أو واجب رسميّ.
الحفاظ على العربيّة هو التزام مستمرّ ودائم، يتطلّب رؤية استشرافيّة تتجاوز النّظرة التقليديّة للّغة، وتؤسّس لجيل جديد يقدّر لغته ويعتزّ بها، ويستخدمها كأداة للتّعبير والتواصل الحضاري. فالمدارس، بما تملكه من إرث تعليميّ عريق، مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتبني استراتيجيات مبتكرة تضمن للّغة العربيّة مكانة مرموقة في صرحها التعليميّ، وتعيد إليها دورها كجسر بين الماضي والمستقبل. الطّريق إلى استعادة مكانة العربيّة ليس سهلاً، لكنّه ليس مستحيلاً. إنّه يتطلّب إرادة جماعيّة، وإيمانًا عميقًا بأنّ اللغة هي جوهر الهوّيّة وروح الأمّة.
فلنعمل جميعًا، كلّ من موقعه، على أن تبقى العربيّة حيّة في عقول أجيالنا وقلوبهم، لغة علم وإبداع، لغة انتماء وانفتاح، لغة الماضي والمستقبل معًا. فبهذا الجهد المشترك، نصون «ضادّ الهوّيّة» ونحفظ للبنان وجهه الثقافيّ الأصيل، ونمنح أبناءنا حقهم في لغة تعبّر عنهم وتجمعهم وتفتح أمامهم آفاق التقدّم والتميّز في عالم متعدّد الثقافات واللغات.
المصادر:
نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 560 في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
ندين الشايب: دكتوراه في العلوم التربويّة وماجستير في اللغة العربيّة وآدابها – لبنان.
[1] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Arabic Language: Global Report on its Presence and Teaching (Beirut: UNESCO, 2021).
[2] Centre for Educational Research and Development (CRDP), Language Use in Lebanese Schools: A Comparative Study (Beirut: CRDP, 2019).
[3] Université Libanaise, Étude sur la langue maternelle et la langue d’enseignement au Liban (Beirut: UL Publications, 2020).
[4] Arab Educators without Borders, Challenges of Arabic Language Teaching in Private Schools in the Arab World (AEWB Reports, 2022).
[5] World Bank, Education Sector Review – Lebanon (2022), <https://www.worldbank.org>.
[6] عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز (بيروت: دار المعرفة، 1994).
[7] منها دراسة: صالح النّصّار، ضعف الطّلبة في اللغة العربيّة: قراءة في أسباب الضّعف وآثاره في ضوء نتائج البحوث والدراسات العلميّة (بيروت: مركز البحوث، 2012).
[8] Jeffrey Glanz, Vivian Shulman and Susan Sullivan, «Impact of Instructional Supervision on Student Achievement,» Educational Leadership Review, vol. 8, no. 1 (2007), pp. 22–35.
مراجع أخرى
زغيب، هـنري. مداخلات في تطوير اللغة العربيّة. بيروت: دار النهار، [د. ت.].
الشّرتوني، كمال. سلسلة عقود الكلام. بيروت: دار السّراج، [د. ت.].
العبد الجبار، عبد الرحمن. الإشراف التربوي الحديث. الرياض: دار الزهراء، 2008.
العتابي، جمال حسن. الوسائل التربويّة: المفاهيم والتقنيات. بغداد: دار الإشعاع، 2009.
غوش، طوني. سلسلة السّراج. بيروت: دار السّراج، [د. ت.]
القحطاني، فاطمة محمد. الإدارة التربويّة. الرياض: مكتبة العبيكان، 2003.
القرعان، ع. وحراشة، أ. الإدارة التعليمية: أسسها وتطبيقاتها. عمّان: دار الفكر، 2004.
كلّاب البساط إ. دراسات حول استعمال الأرقام بدل الحروف. منشورات فردية.
مكتب العلاقات العامة في جامعة اللويزة. اللغة العربيّة.. إلى أين؟ مشكلة تعلّم أم مشكلة إيصال؟ حلقة دراسيّة، 2003.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.