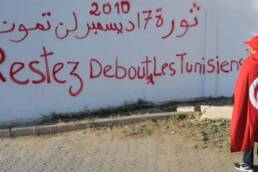المصادر:
نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 559 في أيلول/سبتمبر 2025.
الصورة من وكالة الأنباء العراقية.
الحسين شكراني: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة القاضي عياض، مراكش – المغرب، ومدير الكتاب العربي للقانون الدولي (ARJIL).
[1] عبد الله القصيمي، العرب ظاهرة صوتية (بيروت: منشورات الجمل، 2006).
[2] للمزيد عن متابعة مؤتمرت الأطراف (COP)، انظر: الحسين شكراني وخالد القضاوي، «المفاوضات المناخية العالمية: تنمية فـي النصوص وشكوك فـــي التطبيق،» سياسات عربية، السنة 4، العدد 21 (تموز/يوليو 2016)؛ الحسين شكراني، «الصين والمُفاوضات المُناخية العالمية :بين تعزيز النمو الاقتصادي ومحدودية التّفاعل السياسي مع الدول النامية،» المستقبل العربي، السنة 39، العدد 452 (تشرين الأول/أكتوبر 2016)؛ الحسين شكراني، «تقرير عن: قمة كوبنهاغن حول المناخ: تكريس للفشل أم بداية اتفاق شامل؟،» المستقبل العربي، السنة 33، العدد 383 (كانون الثاني/يناير 2011)؛ شكراني الحسين، «تقرير عن: مؤتمر ديربان حول تغيرات المناخ، جنوب أفريقيا 28 تشرين الثاني/نوفمبر – 9 كانون الأول/ديسمبر 2011،» المستقبل العربي، السنة 34، العدد 397 (آذار/مارس 2012)؛ شكراني الحسين وحلمي كمال، «مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: ريو+20، ريو دي جانيرو، 20 – 22 حزيران/يونيو 2012،» المستقبل العربي، السنة 35، العدد 404 (تشرين الأول/أكتوبر 2012)، و«على هامش مؤتمر الأطراف (COP 22) بشأن التغير المناخي: من تناقض المصالح إلى تعدد المقاربات،» المستقبل العـــربي، السنة 39، العـــدد 457 (آذار/مارس 2017).
[3] في المجال البيئي، ولا سيّما في حقل المعدلات الوراثية (OGM) أو مجالات التأمين في شأن التغيرات المناخية أو الطّاقات الأحفورية أو الفلاحة البيوتكنولوجية، ترفض اللوبيات المنشغلة بهذه الحقول كل ما من شأنه أن يضبط حركيتها. كما تبحث هذه اللوبيات (باستمرار) على التأثير في السياسات البيئية العالمية. انظر: Amandine Orsini, Les Lobbies environnementaux: Intérêt d’une approche pluraliste, Sous la direction de François Gemenne L’enjeu mondial: L’environnement (Paris: Sciences Po Les Expresses, 2015), pp. 124-125.
[4] كصعوبة التركيز على الفرد والجماعات دون الدولة. وأن المفهوم يعبّر بالدرجة الأولى عن خلفية ليبرالية قد تؤسس للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وخرق سيادتها بحجة حماية السكان وحقوق الإثنيات المحلية. كما ترد انتقادات كثيرة على المفهوم كــ «تداخل مستويات التحليل الأساسية بين أفراد ودول ونظام دولي ونظام كوني». انظر: أحمد محمد أبو زيد، «التنمية والأمن: ارتباطات نظرية،» في: مجموعة مؤلفين، النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية: الأبعاد السياسية والاجتماعية (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 262.
[5] تحدث كوفـــي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن وجود مفهومين للسيادة: سيادة الدولة وسيادة الفرد. انظر: Kofi Annan, «Two Concepts of Sovereignty,» The Economist (16 September 1999), <https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty>, (accessed on 21 January 2022).
[6] انظر: Jean-François Rioux (dir.). Coll. Raoul-Dandurand, Montréal, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 2001, <https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2003-v34-n2-ei775/009187ar.pdf> (accessed 22 March 2022).
[7] ففي الحقبة بــين عامي 2006 و2012، شهدت سورية واحدة من أسوأ حالات الجفاف طويلة الأجل، وأشد حالات تراجع المحاصيل وتدمير الماشية في تاريخها الحديث. وقد أدى التصحر إلى التأثير في مليون ونصف مليون مزارع، وبالتالي تسجيل الهجرات الكثيفة للمزارعين ومربي الماشية وذويهم إلى المدن. انظر: Caitlin E. Werrell [et al.], «Did We See It Coming? State Fragility, Climate Vulnerability, and the Uprisings in Syria and Egypt,» SAIS Review of International Affairs, vol. 35, no. 1 (Winter-Spring 2015), p. 32, and Agnès Sinaï, «Aux origines climatiques des conflits,» Le Monde diplomatique (août 2015), p. 2.
[8] المنتدى العربي للبيئة والتنمية، تغير المناخ: أثر تغير المناخ على البلدان العربية (بيروت: أفد، 2009)، ص 14.
[9] المصدر نفسه، ص 15.
[10] التكيف: عملية التكيف مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته. وفي النظم البشرية يكون الهدف من عملية التكيف هو التّخفيف من الضرر أو استغلال الفرص المفيدة. وفي بعض النظم الطبيعية، قد ييسر التدخل البشري التكيف مع المناخ المتوقع وتأثيراته. انظر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تغير المناخ 2014: آثاره التكيف معه، ومدى التأثر به. الملخصات، والأسئلة المتواترة، والأطر المشتركة بين الفصول (بيروت: برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 2014)، ص 5.
[11] Le Conseil National de l’Environnement, Rapport sur l’opérationnalisation de la charte nationale de l’environnement et du développement durable (Rabat, 2011), p. 31.
[12] Emily Meierding, «Climate Change and Conflict: A Critical Overview,» Die Friedens-Warte, vol. 84 (2010), p. 188, and Jürgen Scheffran [et al.], «Link and Janpeter Schilling. Climate Change and Violent Conflict,» Science, New Serie, vol. 336, no. 6083 (18 May 2012), pp. 869-971.
[13] Barry S. Levy and Victor W. Sidel. «Collective Violence Caused by Climate Change and How It Threatens Health and Human Rights,» Health and Human Rights, vol. 16, no. 1 (June 2014), pp. 34-35.
[14] «Le Climat est un facteur d’injustice sociale,» Entretien avec Nicolas Hulot, Revue Française des Affaires Sociales, nos. 1-2 (janvier-juin 2015), p. 200.
[15] رازميغ كوشيان، «المناخ، الطبيعة، الموارد الطبيعية: ساحات المعارك الجديدة،» في: أوضاع العالم 2015: الحروب الجديدة، تحت إشراف برتران بادي ودومينيك فيدال؛ ترجمة نصير مروّة (بيروت: مؤسسة الفكر العربي، 2015)، ص 74.
[16] «Le Climat est un facteur d’injustice sociale,» p. 200.
[17] هشاشة الأوضاع/القابلية للتأثر: الميل أو النزوع إلى التأثر تأثرًا سلبيًا. وتشمل هشاشة الأوضاع جملة متنوعة من المفاهيم والعناصر من بينها الحساسية أو القابلية للتعرض لأذى وانعدام القدرة على التأقلم وعلى التكيف. انظر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تغير المناخ 2014: آثاره التكيف معه، ومدى التأثر به. الملخصات، والأسئلة المتواترة، والأطر المشتركة بين الفصول.
[18] François Gemenne, Géopolitique du climat: Négociations, Stratégies, Impacts (Paris: Ed. Armand Colin, 2010), p. 68.
[19] Sergio Luiz Cruz Aguilar, «Regional Conflict System in Africa: An Option for Analysis,» in: Sara Hasnaa Mokaddem, ed., Stability and Security in Africa: The Role of Hard and Soft Power (Morocco: Policy Center for the New South and Al Akhawayn University, 2019), p.83.
[20] بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1994) يتكون الأمن الإنساني من الأمن الاقتصادي والأمن الصحي، والأمن الغذائي، والأمن البيئي، والأمن الشخصي، والأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
[21] مي جردي، ريم فياض، وعباس الزين، «التدهور البيئي: التحدي لاستدامة الحياة،» في: الصحة العامة في الوطن العربي، المحررون سامر جبور [وآخرون] (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ الجامعة الأميركية في بيروت، 2013)، ص 151.
[22] عمومًا يعني الصّمود قدرة مجتمع ما على مقاومة الكرب، وهو يرتبط، بــ (1) حجم الصّدمة التي يمكن المجتمع أو النظام امتصاصها للمحافظة على حالة معيّنة، (2) درجة التّنظيم الذاتي التي يقدر المجتمع أن يصل إليها، (3) درجة إمكانية المجتمع على بناء القدرة على التعلم والتكيف. كما وُصف صمود المجتمع بأنه «مركب التكيف… الذي يستفيد من جوانب القوة المادية والاجتماعية للأمة». انظر: إيمان نويهض [وآخرون]، «حرب صيف عام 2006 على لبنان: درس في صمود المجتمع،» في: الصحة العامة في الوطن العربي، ص 811 – 812.
[23] المنتدى العربي للبيئة والتنمية، تغير المناخ: أثر تغير المناخ على البلدان العربية، ص 9.
[24] جردي، فياض والزين، «التدهور البيئي: التحدي لاستدامة الحياة،» ص 155.
[25] المنتدى العربي للبيئة والتنمية، تغير المناخ: أثر تغير المناخ على البلدان العربية، ص 13.
[26] Paul Gilding, «The Mother of All Conflicts,» The Brown Journal of World Affairs, vol. 18, no. 2 (Spring – Summer 2012), p. 169.
[27] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009: تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية (بيروت: البرنامج، المكتب الاقليمي للدول العربية، 2009) ص 33.
[28] Paul J. Sullivan and Natalie Nasrallah, «Improving Natural Resource Management in Sudan: A Strategy for Effective State Building and Conflict Resolution,» US Institute of Peace (2010) p. 2.
[29] Mohamed Abdel Raouf Abdel Hamid, «Climate Change in the Arab World: Threats and Responses,» in: David Michel and Amit Pandya, eds., Troubled Waters, Climate Change, Hydropolitics, and Transboundary Resources (Washington, DC: Stimson Center, 2009), p. 49.
[30] عبد الرحيم مصيقر [وآخرون]، «التغذية والأمن الغذائي: الوطن العربي في المرحلة الانتقالية،» في: الصحة العامة في الوطن العربي، ص 321.
[31] La Commission spéciale sur le modèle de développement: Le Nouveau modèle de développement, Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous, Rapport General (avril 2021), p. 45.
[32] Ibid., p. 42.
[33] أخذًا عن: جردي، فياض والزين، «التدهور البيئي: التحدي لاستدامة الحياة،» ص 161.
[34] Manfred Wiebelt [et al.], «Who Bears the Costs of Climate Change? Evidence from Tunisia,» The Journal of Developing Areas, vol. 49, no. 2 (Spring 2015), p. 17.
[35] Lelia Croitoru and Maria Sarraf, eds., Le Coût de la Dégradation de l’Environnement au Maroc, Environment and Natural Resources Global Practice Discussion Paper; no. 5 Executive Summary (Washington, DC: World Bank Group, 2017), p. vii.
[36] Ibid., p. iv.
[37] Ibid, p. vi.
[38] عبد الحميد العبيدي، «محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة،» عمران، العدد 31 (شتاء 2020)، ص 118.
[39] المصدر نفسه، ص 132.
[40] United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (New York: UNDP, 2020), Forword, p. iii.
[41] Ibid., p. iii.
[42] Ibid., p. 106.
[43] Ibid., p. 119.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.