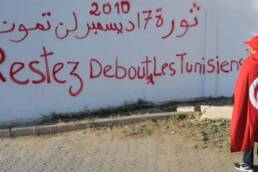يصحّ قبل القراءة أن يلقي المرء نظرة طائر على علاقات القوى الدولية، والتي لكلها شديدُ ارتباط بما في الإقليم من قوىً وما بينها من علائق.
والحال أن القوة الكونية الوحيدة – الولايات المتحدة – قد استطاعت بنجاح ملحوظ إبطاء مفاعيل الأفول الذي ولجت رحابه خريف 2008، مع نهاية 2013؛ عبر انتهاج الشريحة المتنفذة من مؤسستها الحاكمة سبيل التخفف من أثقال حربَي أفغانستان والعراق، وبواسطة تمكّنها من حصر آثار الأزمة المالية الكبرى – خريف 2008، بل وحسرها عبر أعوام خمسة تالية، بما تضمنه الحصر والحسر من طبخ اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وتجمع جنوب شرق آسيا، واقتراب الولايات المتحدة من الاستقلال الطاقي، ناهيك بتمكينها استدامة دولرة الطاقة.
بذلك كله أضحى الأفول من نوع الوزن الخفيف، أي المؤقت، والذي أشهر عام 2014 انتهاءه بتحقيق الولايات المتحدة نسبة 4 بالمئة من النمو.
لكن انحسار الأفول لم يَعْنِ ولن يعني، عودةً إلى وحدانية التسيّد، التي امتدت لعقدين أعقبا سقوط حائط برلين، بل عنت تنظيم انحسار مضبوط يلائم ما بين القدرة والرغبة، ويحفظ لواشنطن قدْرها كصانع القرار العالمي الرئيس، والممسك بالكمِّ الأكبر من أوراق التميز في صراعات القوى الدولية.
الشاهد أن كون كلٍّ من روسيا والصين قوةً تحت كونية – فوق إقليمية تجعلهما – وحتى مجتمعتين – أضعف، لجهة القدرة الشاملة، من الولايات المتحدة إلى حين أن يلحقا بها في سباق السيطرة على البحار والمحيطات، وارتياد استيطان الفضاء، وغزو القطبين، وعلو كعب التقانة، وفي استيلاد عملة عالمية موازية.
طيب، كيف ترى الولايات المتحدة دورها في الحوض العربي وغرب آسيا في ضوء ترشيقها سبلَ سعيها للهيمنة الكونية الشاملة؟
أولويتها الأولى، ترويض كل من روسيا والصين، طلباً لإيصالهما حد التسليم بهيمنة الولايات المتحدة القارية. من هنا أهمية غرب آسيا المركزية كموطىء لتلك البُغية، سواء لجهة الطاقة أو الموقع أو الدين.
أولويتها الثانية، التفاعل «المرجعي» مع قوى إقليمية رئيسة أربع تمسك بأعنّة الإقليم.. هي: إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية، معطوفاً على التخلي عن دور الاندخال العضوي المباشر، والعودة إلى نهج «ما وراء الأفق»، والذي ساد ما بين 1945 – 1990 (مع استثناء عابر هو نزول المارينز بلبنان صيف 1958).
طيب، كيف تتفاعل القوى الإقليمية الرئيسة الأربع في ما بينها من جهة، وكلٌّ منها مع الولايات المتحدة من جهة ثانية:
إسرائيل، أولاً، تتناسب عكساً، لجهة النفوذ والقدرة، مع كل من إيران وتركيا، أي أن هناك علاقة طردية بين ازدياد قوة كل منهما وبين تراجع قوتها. لكن ما يقيها جزئياً من مفاعيل تلك المعادلة هو تنابذ تركيا وإيران في الإقليم، نسبة لرغائب كلٍ منهما في «سوراقيا العربية» بالذات. وطالما قد فشلتا في التوفّر على شراكة إقليمية – لن تستقيم إلا بضلع عربي – فإن إسرائيل تبقى رصيداً وظيفياً من نوع ما للولايات المتحدة، والتي لا تريد لأيهما أن تكون المتنفذة الرئيسة في الإقليم، وإن كانت إمكانية تسليمها بتنفّذ تركي أكبر من تلك لجهة مناظرٍ إيراني، طالما النظام في طهران ليس من صنف ما تشتهي وترغب.
إسرائيل قبل ذلك وبعده – في منظور المؤسسة – جزء عضوي من النسيج الأمريكي، كلّ ما يمايزه عن جذعه كونه امتداداً متقدماً مغروساً في قلب العالم: الشام.
أمنه إذاً، أول الأولويات، لكن توسعه ليس بالضرورة ما يتوجب تأبيده، ولا سيَّما بعد أن يصل العرب إلى التسليم المطلق بـ «حقه» في الوجود (وهو المضمون الكوديّ لمقولة «الدولة اليهودية»، بما تعنيه من «إنهاء الصراع» وإسقاط حق العودة).
ولعل استفادة إسرائيل القصوى من الصراع التركي – الإيراني في الشام قد بدأت في الخفوت بعد أن تعرطل التنشؤ الجهادي، أكان تنظيم الدولة أم حتى من تجاور مع زمرهم في الجولان من نصرة خراسان، أمرٌ يكاد يساوي في همّه تطاول حزب الله إلى جيرة كتلك.. وفي ذلك مثال على فعالية قانون «النتائج غير المتوقعة» في أوضاع ذات سيولة شديدة.
السعودية ثانياً، هي القوة العربية الأوزن، بالمعطى النسبي، لجملة أسبابٍ في الطليعة منها أنها تحت جناح الحماية الكاملة من الولايات المتحدة سلالةً ونظاماً وطاقةً ودوراً، ناهيك بتوفرها على كنز ثروة يجب ألّا تنضب – إلا بفعل فاعل – وباستثمار حوزها الحرَمين الشريفين، وبتسخيرها العقيدة الوهابية أداة امتداد جيو – ديني في طول عالم الإسلام وعرضه.
هي الآن في يد الجيل الثالث من الأسرة المالكة، والذي لم يعد يكتفي بأحابيل ما وراء الستار وإنما يريد استعراض القوة (Projection of Power) ملحوقاً باستعمال القوة (Use of Power) نهجاً للتعامل مع المحيط، طلباً للهيمنة على القرار العربي من جهة ولمناطحة الطرفين الإقليميين المسلمَين الآخرين – فرادى أم حتى معاً إن اضطر – من جهة أخرى.
ولعل تقييم سياستين تبنتهما السعودية مؤخراً تؤشر إلى كيفية ممارسة النهج وإلامَ أودى: الأولى، هي إغراق سوق النفط منذ أيلول/سبتمبر 2014، بما هبط بسعره إلى حوالى ثلث ذروته صيف 2008، أي ± 50 دولار، وبهدف تكسيح شركات النفط الصخري الأمريكية من جهة وتفليس روسيا وإيران من جهة أخرى.
الآن، نرى أن المبتغى الأول لم يجد لتَحققه سبيلاً، فثورة الثروة الصخرية قد تجذرت وجعلت من اللحاق بمفاعيلها خبطاً في العتمة، بل وقلّصت موارد السعودية إلى حدود مهدِّدة لقدرتها على الإنفاق، الداخلي منه أو الخارجي، في غضون سنوات قليلة.
أما لجهة المبتغى الثاني، فقد تكفل الاتفاق النووي مع إيران بإنقاذها من غائلة العقوبات وإعادتها لسوق الطاقة، فيما تكيَّفت روسيا مع العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ عام ونصف، وإن بعسرة مؤلمة، بل واستطاعت مؤخراً ثنْي السعودية عن المضي في «الإغراق» والعودة إلى منسوب واقعي لحجم التصدير.
السياسة الثانية هي «عاصفة الحزم» اليمنية: لم تمانع واشنطن في استعمال السعودية للقوة العسكرية المباشرة، من باب أن التصدي للتمدد الإيراني جنوب الجزيرة هو أمر اليوم، وتحت سقف أن تقييماً دورياً للحملة يكفل استمراراً أو تصعيداً أو ضبطاً لها وفق ظروف المعوقات ووفرة المردود من عدمه.
الآن، نرى أن المراد قد تعقد واختلط بما هو غير مرغوب، إن لم يكن مرذولاً: إذ ما تمخض عنه جبل الحملة هو ذئب الانفصال الجنوبي المسلح، ناهيك باضطراد القاعدة في حضرموت.
ثم هناك اضطرار السعودية إلى أن تراجع مسارها في الشام بعد أن أمضت سنوات أربعاً وهي تقاتل بالواسطة نظاماً حليفاً لخصمها الإقليمي الألدّ، إيران، ومن دون كثير نجاح إن احتسبنا «كونتراها» المرعية في الجنوب وحول دمشق، فضلاً عن استرابتها من «كونترا» اللدود التركي، المترامية من باب الهوى إلى الزبداني.
الاضطرار ذلك ليس مردّه إلى قلة النجاح بمقدار ما إن الرعب المقيم من تبارز تنظيم الدولة عبر «سوراقيا العربية» بل وفي قلب الجزيرة، ناهيك بسيناء، هو الذي يمثل التهديد الوجودي الأخطر على الأسرة المالكة.
وبرغم كل تلك الأنواء تبقى السعودية القوة العربية الأبرز إلى حين يحدد مداه تماسك أوضاع الأسرة من عدمه، وتواصل توفرها على وفير المال من نضبه، وتخففها من سياسات مكلفة أو عقيمة – سواء جيو – اقتصادية أم جيو – سياسية أم حتى جيو – دينية من ندرته، وتوصلها إلى تفاهمات وظيفية معقولة مع خصومها في الإقليم، الألد فيهم أو اللدود، من غيابه.
تركيا ثالثاً، تعيش فترة وصلِ ماضٍ، انقطع منذ قرن، بمستقبل تريده على صورته، بحداثوية العصر. والحال أن الطموح ذلك، وبأيدي إسلامييها – لايت، جعل، ويجعل، دولة حليفة للولايات المتحدة، بحكم انتمائها للناتو لعقود ستة إلى حين يومنا هذا، محكومة من نظام تعتبره «غير صديق»، وبتناسب طردي مع وزن طموحه النوعي.
ولأن قوة بحرية في الأساس تنظر أول ما تنظر إلى عمق بري في محيطها، فالشام والعراق شطرا الإقليم المطلوب استتباعه، ومن ثم كان سعي أنقرة حثيثاً لتذويب – إذا لم يكن إزالة – النفوذ الإيراني في كليهما، وإعلاء كلمة الإخوان المسلمين في الشام إما عبر شراكة وازنة مع نظامها، معطوفة على انتزاعه من فلك طهران أو – إن تمنّع – بواسطة شن حرب بالوكالة عليه تدع لأجلها حدودها مفتوحة على مصراعيها لكل من تاقت نفسه إلى قتاله، من داخلٍ كان أو من خارج. وبذا تتخفف أنقرة، لصالحها ولحساب حلفائها في الناتو وخارجه، من جماعات تؤرق الجميع، وتطرح في الوقت ذاته نظام دمشق أرضاً لتقيم مكانه نظاماً على مقاس ما ترغب وتريد.
تخادمت أنقرة لهذا الغرض مع قاعدة خراسان تخادم الإيجاب، أي ما عكس تفاهماً تكتيكياً على أجندة مشتركة عنوانها إسقاط النظام، ومن بعده ينفرط دف العشاق. ومع انشطار القاعدة إلى خراسانية وعراقية، ربيع 2013، ورغم اختلاف تلك الأخيرة نهجاً وهدفاً عن الأولى (الخلافة مقابل الدولة القطْرية) فلم يثن ذلك تركيا عن التخادم معها وإن اقتصر على نموذج السلب، أي الذي يكتفي فيه المتلقي بقبول الممنوح لقاء الامتناع عن الاعتداء على المانح (فعل التسخير!).
طيب، ماذا حصدت تركيا في الشام والعراق بعد قرابة نصف عقد من استعارة نظام المُلك وياوز؟
في خانة النجاح ترويضها كرد الشمال العراقي حد الاستتباع، وفي باب الفشل توفيرها شرائط انفجار جهادية تفلتت من كل ضابط وأضحت خطراً حتى على من تغاضوا عن نشاطها في ديارهم وعبرها، معطوفة على ميليشيا كردية في الشام تتمثل خطى قرينتها التركية في السعي لحكم ذاتي سرعان ما يتفدرل ليلمس بعدها عتبة الانفصال، ومصحوبة بتوترات إثنية ومذهبية في الداخل التركي تضغط على أوردة اقتصاد يتكل في حيز كبير منه على موارد السياحة.
إيران رابعاً، تثابر على محاولة وصل قزوين بالخليج بالأحمر بالمتوسط دونما كلل، وفي ذهن نخبها أن قوة أرضية في الأساس لا ينبغي إلا أن تنشد البحر موطئاً ومدىً (أي الشام). ولا منجاة لها من عقابيل الزمان إلا بتدجين جار العراق كياناً طيِّعاً تدين شرائحه الحاكمة لها بولاء ينزل من ضرورات الجيوستراتيجيا الجوارية إلى ما تحت تحت قاع التمذهب السياسي، ولا يعرف للحكم غاية إلا تكسب المال الحرام ونهب ثروة الكيان.
شرق المتوسط عنى لها، بالضرورة، الارتطام بوزن إسرائيل النوعي فيه والسعي إلى تقليصه إلى أقصى المستطاع، ومنه رعايتها مقاومتي الشام مكافئاً دفاعياً ورادعاً لتساحال، وعليه التشبث بسورية النظام مهما غلا الثمن، وبعلم أن الخروج منها يعني الخروج من شرق المتوسط برمته.
لكن تبني طهران لزمر الحكم في العراق عبر دزينة من السنين، أظهر اختلالاً جسيماً في حسن تقدير المشهد وعلائق قواه وتراضي عناصره مما وصل بالعراق إلى حيث أصبح نصفه مهدِّداً لإيران ذاتها بدلاً من أن يكون كله خير جار.
ثم مضت إيران بعدها إلى تزيّد في تقدير أوزان القوى ظنت به أن الوقت قد أزف للوثوب إلى ركن الجزيرة الجنوب – غربي، محاصراً السعودية من خاصرتها الأضعف، ومخففاً بذلك ضغطها على «سوراقيا العربية». وإذ بالسعودية تنطلق في رد فعل يفوق الفعل أعلاه في شدة الخطل ويعاكسه في الاتجاه. إن دل ذلك على أمر فعلى تهوين طهران من قدْر خصومها كما جرى عراقياً ولبنانياً خريف وشتاء 2010، بل عراقياً طيلة ما بعد الاحتلال، ويمنياً في العام الأخير.
أما حالها في سورية فسمته العجز عن اجتذاب الناس ليس لقصورٍ فحسب بل لهول ما نجحت في دمغها به «إعلامات» الخصوم.
في عموم، يرينا حساب الأرباح والخسائر أن رصيد إيران واظب على التناقص بعد حرب تموز/يوليو 2006، وسيما منذ 2011، فهي في العراق في «تساكن تسابقي» مع الولايات المتحدة في نصف العراق، فيما عدوها الألد: تنظيم الدولة يبسط سيطرته على نصفه الآخر.
في سوريا، حليفها نظام يسيطر على ثلث الجغرافيا وثلثي الديمغرافيا فيما قرابة نصف الأولى بيد تنظيم الدولة ومعه موارد الطاقة والزراعة الثمينة في حين يواجه جيشها عدداً من الجيوش الميليشياوية، بينها التنظيم، على اتساع 500 نقطة مواجهة وعلى مدى أربع سنوات ونصف.
في فلسطين، تَنَادى عنها حليفٌ تحت ضغط التنابذ المذهب – سياسي هو حماس، وفترت نحوها همة الثاني، أي الجهاد الإسلامي.
أما في لبنان فقد وجد حليفها الرئيس: حزب الله لزاماً عليه أن يهرع لقتال خصومه على الأرض السورية عن أن ينازلهم تلواً في لبنان، فاحتدمت فاعلية الفالق المذهبي واستعر لهيبه في طول عالم الإسلام وعرضه.
كيف هي محصلة توازن القوى بين تلك الأربع؟
كلها بتفاوتٍ ما بين اضطرام واضطراب، لكن أكثرها ارتياحاً على المدى المنظور، 2 – 4 سنوات، هي إسرائيل، وهي في اضطرام لاحتمال انفجار انتفاضة فلسطينية ثالثة ولاقتراب تنظيم الدولة من حدودها الشمالية والجنوبية.
والثابت أن كلاً من الأربع تقيس فعلها ورد فعلها على خلفية تأثره وتأثيره بالموقف الأمريكي، إما كمكونٍ من مكونات بنيانه: إسرائيل… كمرجعيةٍ لكونه الضامن والحامي… كحليفٍ نسبي يتململ من ضوابطه: تركيا… وكخصم يتقن فن التقاطع والتنافع: إيران.
والحاصل أن ما تكتفي به واشنطن هو دور ضابط الإيقاع والمرجع الناظم، فإن لحظت أن المكون قد تهدد مباشرة أو بالواسطة، هرعت لتجليس وضعه بما في الوسع، وإن أحست أن المحميّ قد اهتز سارعت لدعمه أو حتى تأنيبه، وإن شعرت أن الحليف النسبي قد جاوز سقفاً غير مرئي له حاصرت مفاعيله وحايلته بما يفيد بعدم الرضا ليفهم، وإن تلمَّست أن الخصم قد طمح إلى ما يخرج عن احتمالها سارعت لنزاله بوسائل شتى حتى يفيء إلى … تقاطع، إن لم تقدر على فوز مبين.
من تراه المستفيد الجانبي من صراعات الأربع، ولأي حد؟
هما اثنان لا واحد: البيشماركا الكردية في سورية، وتنظيم الدولة في «سوراقيا». الأولى لن ترى تركيا طريقها إلى مرادها في فدرالية في حكم ذاتي، على غرار رائدها العراقي، إلا بتدجينها و«برزنتها» على غراره ذاته، ولتكون مثالاً تتماهى معه شقيقتها الكبرى أي الكردية السياسية في تركيا عينها. لكن الأهم من ذلك العامل التركي هو أن السوريين – و91 بالمئة منهم عرب – لن يدعوا 6 بالمئة من مواطنيهم يقيمون انفصالاً مغلفاً بدعوى الحكم الذاتي والفدرالية وخلافه مهما كان الثمن. إذاً، فالرعاية الأمريكية لبيشماركا كُرد سورية لا تكفي لاستقامتها على الأرض كينونةً مفدرلة ومنصَّبة وصياً على الكيان السوري طالما لم تُدجَّن تركياً ولا تُقَبل من عرب سورية.
أما تنظيم الدولة، فهو القوي الضعيف في آن: يقاتله الجميع بتفاوت، ذلك منبع جاذبيته، لكن تطور الوضع السوري إلى تسوية «الاضطرار»، بهدف تفرغ الجميع لقتاله، سيؤدي إلى حصاره، وإضعافه وتحجيمه على الأرض السورية. أما عراقياً فتلك مسألة أخرى.
هل يبدو الجميع الآن مضطراً لعقد تسوية اضطرار سورية؟
المحاور الثلاثة: سورية وإيران – تركيا وقطر – السعودية والإمارات والأردن – وصلت بالفعل ورد الفعل، إلى نقطة استحالة حسم الصراع بالفوز لأي منها في الشام.. وبرغم أن ذلك بحد ذاته ليس مدعاة إلى وقف الصراع، لا سيما وأن استنزاف المحور الإيراني – السوري هو مبتغى الاثنَين الآخرَين – وهما على عميق ما بينهما من تباين يتفقان على خصومة الأول – لكن مغيّر المعادلة الذي يتكفل بوقف استدامة الصراع هو تنظيم الدولة وخطره على الجميع… من هنا الحاجة إلى تسوية الاضطرار.
في المحصلة، ما زالت الولايات المتحدة القوة الأهم، بل والمقرِّرة، في غرب آسيا وشمال أفريقيا، أي بلاد العرب… ومن يشاركها، من الأجانب، في التأثير والنفوذ هي روسيا وإيران وتركيا، أي ليست هناك من قوة عربية مرجعية لها التأثير الأوزن في مصائر الوطن الأكبر – كما كان الحال ما بين 1955 – 1970، وما لم تُعد الأمة إنتاج مرجعيتها سيبقى وطنها الأكبر مِزقاً تتناتشُها قوى الخارج.
الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو مرجعية عربية هي: وقف الحرب السورية.
كتب ذات صلة:
سوريا قوة الفكرة: المشروع الوطني والهندسات الدستورية للأنظمة السياسية
المصادر:
كمال خلف الطويل: كاتب وباحث عربي.
نُشرت هذه المقالة في مجلة المستقبل العربي العدد 439 في أيلول/سبتمبر 2015.
كمال خلف الطويل
طبيب أشعة زاول مهنته لثلث قرن في الولايات المتحدة، وساكنٌ في التاريـخ ومسكونٌ به قبل وبعد. ولد في 16 أيار/ مايو 1952 في بيت لحم، على كونه من البيرة - فلسطين، ثم عاش ودرس في دمشق منذ عام 1956، وتخرج فـي كليتها الطبية عام 1975، ليغادر بعدها للاختصاص في الولايات المتحـدة. تقلد هناك مناصب ذات صلة: رئاسة الجمعية الطبية العربية الأمريكية؛ رئاسة جمعيـة الخريجين العرب الأمريكيين؛ رئاسة جمعية البيرة - فلسطين؛ وعضو مجلـس أمنـاء اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز العنصري. انضم لعضوية المؤتمر القومي العربـي عام 2000 وانتخب عضوًا فـي أمانته العامـة 2003-2010. وهو عضو اللجنة التنفيذيـة لمركز دراسات الوحدة العربية وعمل مديرًا له في عام 2015. الشغف بالتاريـخ والسكنى في إهابه باتا نصًا من أقانيم ثلاثة، أراد منه صاحبه أن يكون صلة وصل لأجيال بازغة مع ماض ليس ببعيد كان فيه العرب ذوي شأو... أو هكذا بدا...
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.