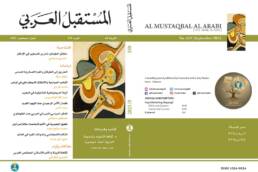أولًا: الجذور التاريخية للرؤية المؤسِّسة لاقتصاد لبنان السياسي
احتدم الصراع في أوائل القرن التاسع عشر على مختلف الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الدول الأوروبية الكبرى على وراثة الرجل المريض (السلطنة العثمانية) في المشرق العربي. وفي خضم هذا الصراع، كان للبنان، وتحديدًا لجبل لبنان وبيروت، أهمية خاصة كمنصة ينطلق منها الغرب الاستعماري للنفاذ إلى الداخل العربي واستتباعه سياسيًا واقتصاديًا. وقد تلازم دور لبنان الوظيفي الإقليمي هذا، مع نشوء نظام الطائفية السياسية في جبل لبنان ونمو اقتصاد الوساطة (إنتاج الخدمات لحساب الخارج) في بيروت. ومنذ ذلك الحين، بقي الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي قائمًا على هاتين الركيزتين[1].
المهم هنا هو الإشارة إلى أنه في تلك المرحلة ستتكون، في كنف رأس المال الغربي، برجوازية محلية تدربت وتمرَّست على مزاولة أعمال الوساطة في العلاقات التي قامت بين الغرب الاستعماري والداخل العربي. وكانت هذه البرجوازية بمعظمها، إن لم تكن جميعها، مسيحية، تألفت من تجار كبار، مُستوردين ومُصدّرين، ومصرفيين، ممثلين لشركات أجنبية، ووكلاء بحريين، وأصحاب مصانع، ومهن حرة ارتبطت بقطاعات الوساطة التجارية والمالية والخدمات الأخرى.
عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس – بيكو، أنشأ الانتداب الفرنسي «لبنان الكبير» بحدوده الحالية، برغبة من أغلبية المسيحيين وعدم قبول من أغلبية المسلمين، وكرّس في الوقت نفسه الدور الوظيفي للكيان الجديد بالتلازم مع نظام الطائفية السياسية على صعيد الحكم المحلي، وتعزيز اقتصاد الوساطة في بيروت. أبقت سلطة الانتداب الفرنسي لبنان الكبير كناية عن مجال جغرافي يجمع مناطق وطوائف، متفاوتة كثيرًا في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومنقسمة حول هويتها الوطنية وتمارس النخب (البرجوازية) المسيحية هيمنة على المستويين السياسي والاقتصادي. رأى التيار الغالب عند هذه النخب المسيحية، أن الاقتصاد اللبناني يجب أن يقوم بصورة رئيسية على إنتاج الخدمات وبخاصة منها السياحية؛ حتى إن البعض منهم ذهب إلى حد وصف السياحة جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية اللبنانية. في هذا السياق، أخذت تظهر عند أصحاب وجهة النظر هذه، مقولة لبنان «سويسرا الشرق»[2]. أما في المقابل فكانت النخب المسلمة أصلًا رافضة الانفصال عن سورية، ولم يكن، على وجه الإجمال، يعنيها تكوين فكرة عن مستقبل لبنان الاقتصادي[3]. أضف إلى ذلك أن بعض النخب المسيحية ذاتها أخذ، في الوقت نفسه، يجهد لإعطاء الكيان اللبناني، المتكوّن تحت الانتداب، هوية حضارية بعيدة عن هويته العربية. فمنحت الكيان الجديد بُعدًا تاريخيًا يمتد إلى آلاف السنين، وجعلت من الفينيقيين أجدادًا للبنانيين أورثوهم خصائص جوهرية صاروا بموجبها تجارًا بالفطرة، مغامرين، منفتحين على العالم ويعشقون الحرية[4].
ثانيًا: بلورة الرؤية المُؤسِّسَة لاقتصاد لبنان السياسي في الجمهورية الأولى
أبقى «رجال الاستقلال» على النص الدستوري، الذي يقول بالصفة الموقتة لنظام الطائفية السياسية، وتوافقوا على «ميثاق وطني» غير مكتوب يعالج مسألة الهوية بتسوية شكلية يتخلى بموجبها المسلمون عن المطالبة بالانضمام إلى المحيط العربي (سورية) مقابل تخلّي المسيحيين عن اللجوء إلى الحماية الغربية. وجاء البيان الوزاري لحكومة الاستقلال الأولى، من جهته، متضمنّا التزامًا بالقيام بسلسلة طويلة من الإجراءات التي من شأنها وضع لبنان على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة.
بقيت هذه الوعود حبرًا على ورق، وأُعيد إنتاج النظام السياسي الطائفي نفسه واقتصاد الوساطة عينه، في ظل منسوب عالٍ من الليبرالية. ذلك أن رؤية مغايرة للنظام السياسي والاقتصادي في لبنان المستقل، فرضت نفسها، وجعلت من هذا النظام نموذجًا يكاد يكون فريدًا في العالم لناحية المزيج الذي قام عليه من الطائفية السياسية والاقتصاد الحر غير المنتج.
هذه الرؤية هي التي تكونت في مرحلة الانتداب وأصبحت في السنوات الأولى للجمهورية الأولى مهيمنة لدى النخب الفكرية المسيحية التي اختلط فيها المثقف والصحافي والتكنوقراطي ورجل الأعمال، وأخذت تعبِّر عن توجهاتها من خلال عدد من الجمعيات والمنتديات منها: مجموعة «الفينيقيون الجدد»، و«جمعية البحر الأبيض المتوسط»، و«جمعية الاقتصاد السياسي»، و«الندوة اللبنانية». ويُعَدّ ميشال شيحا المبلور الرئيسي لهذه الرؤية.
1 – الرؤية الشيحية لمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي
انطلق شيحا[5] في رؤيته هذه من خلفية فكرية زعمت ان لـ«الإنسان اللبناني» و«الكيان اللبناني» و«دور لبنان في العالم» و«دور الدولة في لبنان»، خصائص جوهرية لا تتغير، لأن هنالك نوعًا من الحتمية الجغرافية والتاريخية التي تتحكم بمصير لبنان. فالتاريخ (منذ الفينيقيين حتى اليوم) والجغرافيا (امتداد لبنان على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط)، عملا على أن يكون العنصر البشري في لبنان فريدًا، ويحتّم على اللبنانيين أن يكونوا تجارًا ومقدمي خدمات للعالم. و«فينيقيا» هي رمز مزدوج، كياني واقتصادي. «لقد كنّا تجارًا وسنبقى كما كان فينيقيو الأمس» و«الطبيعة (الموقع الجغرافي) هي التي اختارت لبنان اليوم ليكون بلدًا تجاريًا». وقَدَر اللبنانيين «أن يكونوا تجارًا ويبيعوا خدمات أكثر مما يبيعوا سلعًا…». قاد هذا التصور إلى القول إن لبنان لا يمكن أن يصبح بلدًا صناعيًا أو زراعيًا، وأن نظامه الاقتصادي يجب أن يبقى حرًا. فالاقتصاد الحر ولبنان توأمان. إنّ «بلدًا كبلدنا هذا الذي يقدم الخدمات لا بد بكل بداهة، من أن تحكمه الحرية بأوسع مجالاتها». والاقتصاد الحر مُعطى طبيعي يستمد شرعيته من طبيعة الشعب اللبناني الذي هو تقريبًا وحيد من نوعه، فـ «الاقتصاد الحر ووجود الكيان اللبناني نفسه أمران متلازمان ولا يمكن لأي سياسة أن تزيل هذا التلازم بل عليها أن تحافظ عليه».
فضلًا عن هذا فإن لبنان هو شعب من التجار، وبحسب ميشال شيحا أيضًا فإنه: «ملجأ الأقليات والمضطهدين». يجب أن تكون الدولة في لبنان مجرد تعبير عن التعددية الطائفية، وبخاصة مجلس النواب الذي يجب أن يبقى مكان «اللقاء بين الجماعات الطائفية المتشاركة» و«مجمع وجهاء»؛ مهمته الحفاظ على «التوازن بين الطوائف والمناطق اللبنانية». وعلى الدولة في لبنان أن تبقى أيضًا بعيدة عن التدخل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. فـ«كل التشريع اللبناني وكل السياسة الاقتصادية يجب أن يأخذا في الحسبان عاملًا أساسيًا، عاملًا تكوينيًا، هو أن النشاط اللبناني هو في الخارج ومع الخارج» و«ليعيش لبنان يجب أن يذهب عنه مرض الغرب التشريعي ومرضه الضرائبي».
في مقابل هذه الرؤية، كان هنالك قسم آخر من النخب[6]، أغلبيتهم من أساتذة الجامعة الأمريكية وخريجيها، انطلقوا من معاينة واقعية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورأوا الأبعاد الخطيرة التي تأخذها المشاكل والاختلالات على هذا الصعيد، وضرورة معالجتها من خلال وضع الخطط والبرامج القطاعية التي ترمي إلى تنمية القطاعات الإنتاجية المُولّدة فرص العمل، واستغلال الموارد الطبيعية، ولا سيَّما المياه، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وإصلاح النظام الضريبي ومعالجة المشاكل السكانية… إلخ.
غير أن هذه النخب في معظمها لم تربط بين نظرتها إلى الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي وإصلاح النظام السياسي. حتى إنها لم ترَ أن الدور المحوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعود إلى الدولة. ونشير في هذا الخصوص إلى أن هشام صفي الدين قد لاحظ تأثير النظرية الاقتصادية المُؤسسّية الأمريكية على هذا القسم من النخب. فقد كان رهانهم على إصلاح المؤسسات كدافع رئيسي للتنمية ولجأوا من ناحية ثانية، إلى اعتماد أساليب التحليل الكمّي والاستقصاء الإحصائي في دراساتهم[7].
هكذا ظلت الرؤية التي سترسم المعالم الرئيسية للنظام اللبناني في ظل الجمهورية الأولى هي رؤية ميشال شيحا التي ترى هذا النظام من الناحية السياسية، قائمًا على التوازنات الطائفية، ومن الناحية الاقتصادية، قائمًا على أقانيم ثلاثة هي:
– أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يكون إلا اقتصاد تجارة وخدمات.
– أن النشاط الاقتصادي للبنانيين لا يمكن أن يكون إلا مع الخارج وفي الخارج.
– أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا في ظل أعلى درجات الليبرالية وامتناع الدولة عن ممارسة أي دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا يصب في مصلحة المبادرة الفردية والقطاع الخاص.
2 – لماذا كانت الغلبة للرؤية «الشيحية»؟
بات معروفًا أن معظم البلدان التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت قيام سلطات مركزية قوية نسبيًا، أدّت الدور الرئيسي في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لبلادها. يعود ذلك إلى عاملين رئيسيين: ضعف القطاع الخاص الوطني وهامشيته من جهة، وكون الثروات الطبيعية هي الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي (إنتاج وتصدير الموارد الأولية) من جهة ثانية. وفي لبنان، لم تكن الحال كذلك من الجهتين المذكورتين. كان لبنان يفتقر إلى الموارد الطبيعية القابلة للتصنيع المحلي أو التصدير إلى المراكز الرأسمالية المتقدمة، وقد ورث من مرحلة الانتداب، طبقة رأسمالية محلية على جانب كبير من الدينامية، توّاقة للتفلت من القيود والحدود التي فرضتها عليها سلطة الانتداب، ومُتعطّشة للعمل بمنتهى الحرية. غير أن نشاطها ظل محصورًا أساسًا في دائرة التجارة والخدمات. وعليه، فإن الرؤية التي جاء بها التيار الفكري الشيحي، للنظام الطائفي سياسيًا، والليبرالي غير المنتج، اقتصاديًا، لم تكن في الواقع سوى ترجمة لتطلعات هذه الطبقة، المسيحية الانتماء، لأن فئة كبار رجال الأعمال من تجار ومصرفيين ألّفت النواة الصلبة للتيار المذكور، وكانت هي المُمسكة بالسلطة الاقتصادية في البلاد المكوَّنة من نحو ثلاثين أسرة، وكان فواز طرابلسي يسميها «الأوليغارشية» المالية والتجارية[8] وهي على علاقة عضوية بالسلطة السياسية الفعلية، بحيث تولّدت من هذا الاندماج مجموعة مُتضامنة أمسكت بزمام النظام السياسي والاقتصادي.
في المقابل، لم تظهر قوى اجتماعية وازنة قادرة على أن تأخذ النظام السياسي والاقتصادي لدولة الاستقلال في مسار مغاير لمسار «الرؤية الشيحية». فخارج النخب الفكرية، الأكاديمية بمعظمها، لم تجد الرؤية المُهيمنة معارضة وازنة من جانب تنظيمات تعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية، الأكثر عددًا، لإقامة نظام يُؤمّن العدالة والمساواة بين المواطنين. بقي الطرف المسلم في لبنان حتى أواخر الخمسينيات في موقع ضعيف، من دون وزن يذكر في رأس المال المُسيطِر والسلطة الاقتصادية، واقتصر تمثيله في السلطة السياسية على زعامات تقليدية ظل معظمها ملتحقًا بالقيادات المسيحية، يرضى بالفتات من السلطة التي تُتيح له تعزيز مواقعه داخل طائفته. وإذا كان للبعض من هذه الزعامات من دعم خارجي، فقد استمده من بعض الأنظمة العربية التي تسبب عجزها بنكبة فلسطين، وكانت بدورها خاضعة لنفوذ الغرب الذي كان يعمل جاهدًا على توطيد دعائم نظام الطائفية السياسية والاقتصاد الليبرالي القائم. فقد رأى الغرب في إبقاء هذا النظام ضمانة لاستمرار لبنان كمنصة لإحكام سيطرته على الداخل العربي. ومن جهة ثانية، كانت الأحزاب العلمانية، غير الطائفية العاملة في لبنان، نخبوية محدودة التأثير بوجه عام. وكان معظمها قوميًّا عربيّا أو سوري التوجه، يرى أن النظام اللبناني هو من نتيجة الاستعمار وتقسيمه للمنطقة، وبالتالي لا يمكن تغييره إلا من خلال تحرير المنطقة من النفوذ الأجنبي وإعادة توحيدها. أما اليسار الماركسي فكان، بدوره، يعدّ الطائفية أداة تستخدمها البرجوازية اللبنانية لإحكام سيطرتها على السلطة السياسية، وتختفي تلقائيًا عندما يتمكن الصراع الطبقي من إزاحة هذه البرجوازية عن الحكم. علمًا أن التنظيمات النقابية العمالية كانت في حينه شديدة الضعف.
ما كان للرؤية الشيحية أن تبقى متحكمة في المسار العام للنظام اللبناني السياسي والاقتصادي لولا سلسلة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي حصلت على الصعيدين الدولي والإقليمي بعد الحرب العالمية الثانية، والتي جاءت بنظام دولي ونظام إقليمي جديدين، وجعلت من النظام اللبناني هذا، حاجة ماسة إلى البلدان الغربية الرأسمالية في سعيها لتعزيز هيمنتها على المنطقة العربية واستتباعها اقتصاديًا وسياسيًا.
من أهم هذه المتغيرات التي كان لها أهمية بالغة في تعزيز النظام اللبناني بصيغته الطائفية سياسيًا، والليبرالية المتطرفة غير المنتجة اقتصاديًا، كان صعود الولايات المتحدة واحتلالها موقع قيادة للنظام الرأسمالي العالمي وغلبة نفوذها في العالم وفي المنطقة العربية على النفوذ البريطاني والفرنسي. هذا في وقت أخذت فيه أهمية هذه المنطقة الاقتصادية والجيوسياسية تتعاظم من جراء تحوًلها إلى أغنى مناطق العالم بالنفط الخام. وإلى ذلك، أضف الاحتلال الصهيوني لفلسطين وقيام «دولة إسرائيل» واحتدام الصراع (الحرب الباردة) بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، الذي كانت المنطقة العربية إحدى ساحاته الرئيسية. ثم صعود حركات التحرر الوطني من الاستعمار التي كانت المنطقة العربية أيضًا من ساحاتها الرئيسية.
3 – الحصيلة العامة للرؤية الشيحية في الجمهورية الأولى
لم تعمل هذه المتغيرات، وبخاصة منها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رافقتها في أقطار المشرق العربي، على تجديد الدور الوظيفي الإقليمي الاقتصادي والجيوسياسي للبنان وحسب، وإنما عملت على تعزيزه وتوسيع نطاق عمله، فأخرجته من إطار خدمة مصالح رأس المال الفرنسي إلى خدمة مصالح رأس المال الغربي ككل، والأمريكي بوجه خاص. وفي هذا السياق أصبح لبنان، وبيروت على وجه الخصوص، القناة الرئيسية التي تعبر منها حركة البضائع والرساميل المتنامية بين البلدان الرأسمالية المتقدمة وبلدان المنطقة العربية، وفي الوقت نفسه أصبح لبنان مركزًا لما يرتبط بهذه الحركة من نشاطات لوجستية واقتصادية أخرى. وكانت النتيجة أن انطلقت مرحلة من النمو الاقتصادي الملحوظ، امتدت على أكثر من ربع قرن من الزمن، في مناخ من الاستقرار المالي والنقدي، وتحسُّن ملموس في مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الوطني. وهذا ما حدا بكثير من اللبنانيين، إلى اليوم، على وصف تلك المرحلة بمرحلة «ازدهار اقتصادي منقطع النظير». ولم يلتفتوا في المقابل إلى الاختلالات العميقة التي لحقت بالبنى الاقتصادية والاجتماعية. ذلك أن قطاع الخدمات مثّل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومارس من خلال القوى الاجتماعية التي وقفت خلفه، هيمنة كاسحة داخل الاقتصاد، أدت إلى سوء استخدام الموارد المالية والبشرية والطبيعية، وحدًت من نمو قطاعات الإنتاج السلعي (الزراعة والصناعة، على وجه الخصوص)، وتركت الاقتصاد اللبناني بمجمله على درجة عالية من التبعية للخارج، ناهيك بعدم توزع مصادر النمو وثماره على المواطنين بصورة عادلة. هكذا، إذًا، أُعيد إنتاج التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، الموروثة من مرحلة ما قبل الاستقلال، بين مختلف المناطق والطبقات والطوائف.
أظهر تقرير بعثة إيرفد عمق هذه التفاوتات ومدى ما تمثله من مخاطر تهدد «التماسك الوطني». فالنتائج الإيجابية المُحقّقة «لا يمكن اعتبارها مُكتسبة دائمًا. وهي ما كانت لتحصل لولا الثمن المقابل والمتمثل بالتفاوت الخطير في توزيع الدخل والسكان والخلل بين قطاعات النشاط الاقتصادي». كانت الخلاصة التي خرج بها التقرير أن «لبنان لا يمكن أن يستمر في وضعه الحالي، المتفائل في الظاهر والهش في العمق»[9]. لكن اللافت هنا، هو أن هذه التفاوتات الاقتصادية الاجتماعية الحادة التي رافقت «الازدهار الاقتصادي لم تكن السبب المباشر لاندلاع الحرب الأهلية الخاطفة في عام 1958»، وإنما النزاع، الذي جاء بطابعه الغالب طائفيًّا، على موقع لبنان في الصراع الذي أخذ يحتدم بين حركة التحرر الوطني العربية بقيادة مصر الناصرية من جهة، والغرب الاستعماري وحليفته إسرائيل من جهة ثانية.
ثالثًا: التجربة التنموية الشهابية غير المكتملة
مثّل مجيء الجنرال فؤاد شهاب إلى رئاسة الجمهورية حدثًا استثنائيًّا في تاريخ لبنان المستقل، إذ كان، استنادًا إلى الخلاصات التي خرج بها تقرير بعثة إيرفد، أول من وضع مسألة التنمية الاقتصادبة والاجتماعية، فعليًا، على جدول أعمال الحكم في لبنان.
جاءت إنجازات العهد الشهابي على قدر كبير من الأهمية في مجال استحداث الأطر المؤسسية، التشريعية والإدارية، التي تُمكّن الدولة من القيام بدور تدخلي فاعل في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ورافق ذلك جهود ملحوظة بُذلت في مجال إقامة البنى التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية لمصلحة الأرياف والمناطق الطرفية. فجرى تزويد معظمها بالكهرباء ومياه الشرب والمدارس الرسمية والمستوصفات الحكومية والطرق المُعبّدة، إضافة إلى مشاريع استصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية وتشجيع الحرف اليدوية.
لكن هذه الإنجازات والجهود لم تصل إلى حد التصدي الجدّي لمعالجة الأسباب الفعلية للمسألة الاقتصادية الاجتماعية التي كانت مطروحة في لبنان والمُتمثلة، على ما نرى، بالنظام السياسي الطائفي ونموذج النمو الاقتصادي القائم على خلل عميق في البنية الإنتاجية، لمصلحة قطاع الخدمات، وعلى تركز شديد للنشاطات الاقتصادية غير الزراعية في العاصمة ومحيطها القريب من جبل لبنان، إضافة إلى توزيع غير عادل، بل ظالم، للثروة والدخل على مختلف الطبقات الاجتماعية والطوائف. لم تضع الشهابية خططًا قطاعية وسياسات فعلية للنهوض بقطاعَي الزراعة والصناعة. ولم تُدخِل تعديلات نوعية على نظام الحرية المفرطة التي كان يتمتع بها القطاع الخاص؛ تعديلات من شأنها أن تدفع هذا القطاع، ولا سيَّما المُكوّن المصرفي منه، للاستثمار في القطاعات المُنتجة والمُولّدة لفرص العمل في الريف والحواضر، أو حتى إشراكه في تحمل جزء من الأعباء التي يمكن أن تترتب في مجال تمويل الخطط التنموية. فبقي النظام الضريبي على حاله المحابية للأغنياء. لذلك لم يخرج المشروع الشهابي عن كونه، في نهاية الأمر، محاولة لجعل النظام القائم قابلًا للاستمرار/الحياة، من طريق القيام بإصلاحات لا تمس جوهر هذا النظام (بركيزتيه الطائفية السياسية والاقتصادية) غير المنتج. لكن حتى هذا المشروع، بمحدودية أهدافه، لم يكن قابلًا للاستمرار طويلًا بعد خروج فؤاد شهاب من رئاسة الجمهورية. فقد عادت الدولة العميقة، المتمثلة بالأوليغارشية التقليدية، للإمساك شيئًا فشيئًا بزمام الشأنين السياسي والاقتصادي، ولتُعيد تدوير المنجزات الشهابية في مطحنة مصالحها الخاصة. فصاحب المشروع المذكور، لم يأتِ إلى الحكم كممثل لقوى سياسية اجتماعية جديدة وازنة وإنما، نتيجة لتفاهم خارجي، بوصفه قائدًا للجيش من خارج «الطبقة السياسية». ولم يجد سبيلًا للسير في مشروعه الإصلاحي إلا الاعتماد على الدعم الخارجي والأجهزة الأمنية والبيروقراطية التكنوقراطية.
باختصار، لم يتأسس المشروع الشهابي «التنموي» على أرضية صلبة لا سياسيًا ولا اجتماعيًا، وهو ما جعله يذوي مع تغيُّر الظروف الخارجية التي جاءت بصاحبه إلى الحكم.
هكذا عادت الرؤية الشيحية لتفرض هيمنتها مجددًا، ليس في أوساط النخب السياسية والاقتصادية وحسب، وإنما أيضًا في أوساط الفواعل الفكرية والأكاديمية والثقافية والإعلامية، إلى حد رفعت معه هذه النخب النمط المتطرف من الليبرالية الاقتصادية إلى مرتبة القداسة. فأصبح هذا النمط محاطًا بسياج أيديولوجي منيع، يحسب أية محاولة للمسّ به، من قريب أو بعيد، من قبيل المحرَّمات.
رابعًا: الحرب الأهلية (1975 – 1989) وتَكوّن المعالم الرئيسة لاقتصاد لبنان السياسي في الجمهورية الثانية
شهدت السنوات الأولى من سبعينيات القرن العشرين موجة عالية من التضخم وارتفاع الأسعار في لبنان. تسببت هذه الموجة في تردّي مستويات العيش للأكثرية الساحقة من المواطنين، فانطلقت حركة احتجاجية ناشطة وواسعة النطاق (إضرابات، وتظاهرات، واعتصامات)، شملت مختلف فئات العاملين بأجر والمزارعين. لم تقتصر مطالب هذه الحركة على زيادة الأجور والرواتب بوجه عام، بل شملت أيضًا المطالبة بإقامة نظام حماية اجتماعية شاملة وتحسين ظروف العمل وضمان الحريات النقابية. وعلى خط موازٍ قامت حركة احتجاجية طالبية لا تقل نشاطًا، رفعت شعار ديمقراطية التعليم وتعزيز الجامعة اللبنانية. لم تلقَ هذه الحركات الاجتماعية من جانب الأوليغارشية الحاكمة سوى ضروب مختلفة من القمع البوليسي والتسريح الكيفي، وصولًا في بعض الأحيان إلى استخدام العنف القاتل. بالرغم من هذا لم تكن القضية الاقتصادية الاجتماعية هي السبب الرئيسي المباشر لاندلاع الحرب الأهلية المديدة والمُدمّرة التي عصفت بلبنان (1975 – 1989)، وإنما صعود المقاومة الفلسطينية المسلحة التي أخذت لبنان قاعدة لها، واستقوى بها أحد طرفي الحرب في لبنان (الحركة الوطنية) فرفع شعار إقامة الدولة الديمقراطية المدنية. لكن هذا الشعار لم يرفق بتصور محدد لمستقبل لبنان على الصعيد الاقتصادي. ولم يعمر شعار الدولة المدنية هذا أكثر من سنتين، وسُحب من التداول بعد الضعف الذي لحق بالحركة الوطنية عقب الدخول السوري إلى لبنان في أواخر عام 1976. تجدد الصراع بين طرفَي الحرب، وخصوصًا بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، ليأخذ الطابع الطائفي (التزامن مع الصراعات داخل الطائفة الواحدة) ويتمحور حول الموقع في السلطة السياسية، وفي الوقت نفسه حول موقع لبنان في الاصطفافات الدولية والإقليمية.
إذا وضعنا جانبًا الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب برأسمال لبنان البشري والمادي والاجتماعي، فتقتضي الإشارة، بوجه خاص، إلى متغيرَين رئيسين جاءت بهما الحرب الأهلية، وكان لهما دور حاسم في إعادة إنتاج رؤية شيحية «جديدة» في الجمهورية الثانية وهما: حلول قادة الميليشيات (أمراء الحرب) محل القيادات السياسية التقليدية للطوائف وتلاشي الدور الوظيفي للاقتصاد اللبناني في المنطقة (اقتصاد الوساطة).
خامسًا: الرؤية الشيحية المتجددة لاقتصاد لبنان السياسي في الجمهورية الثانية
ذهبت «وثيقة الوفاق الوطني»، التي أنهت الحرب الأهلية، والتي أُدرِج معظم بنودها في صلب دستور الجمهورية الثانية، بوعودها الإصلاحية أبعد ممّا ذهبت إليه وعود الجمهورية الأولى. ففي الجانب السياسي، نصت الوثيقة على الالتزام بإلغاء الطائفية السياسية وفقًا لخطة مرحلية محددة. وفي الجانب الاقتصادي الاجتماعي، تضمنت عددًا من المندرجات التي توحي بأننا بتنا أمام صيغة تنموية من الشهابية أكثر تطورًا. ولكن نصيب هذه الوعود من التنفيذ لم يكن بأفضل من الوعود التي قُدِمت في مطلع الاستقلال. فأعيد إنتاج النظام السياسي والاقتصادي نفسه، لكن على نحو جعله أكثر تغوّلًا في طابعه السياسي الطائفي وفي طابعه الاقتصادي غير المنتج. وسبب إعادة الإنتاج المزدوجة هذه، هو ذاته من حيث الجوهر. نعني خصائص المنظومة السياسية والاقتصادية التي أمسكت بزمام السلطة بعد اتفاق الطائف، من جهة، والظروف الدولية والإقليمية التي أحاطت بهذا الإمساك من جهة ثانية.
نلاحظ في هذا الخصوص أولًا، أن الحرب الأهلية لم تنتهِ بانتصار فريق يحمل مشروعًا لتغيير جذري في النظام الذي كان قائمًا قبل هذه الحرب. وبعد دخول اتفاق الطائف مرحلة التنفيذ، لم ترَ مراكز القوى الطائفية، التي تولت السلطة السياسية، مصلحة لها في إنهاء المرحلة الانتقالية والعبور إلى نظام سياسي لاطائفي. وكذلك الأمر من جهة رعاة هذا الاتفاق الدوليين والإقليميين. فبعد أن عُهِد إلى سورية القيام بدور الضابط للخلافات والصراعات التي بقيت كامنة بين مختلف مراكز القوى الطائفية اللبنانية، دخل لبنان عمليًا تحت الوصاية السورية. ولم تترك هذه الأخيرة للسلطة المحلية من مهمة رئيسية، سوى أمر معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب. وفي هذا السياق، تحولت السلطة السياسية اللبنانية إلى سلطة متعددة الرؤوس الطائفية. توزعت مؤسسات الحكم التشريعية والإجرائية والإدارات والمؤسسات العامة، حصصًا فيما بينها. وهذه الحصص من السلطة باتت، في نظر مراكز القوى السياسية الطائفية الرئيسية، مصدرًا للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المال العام وتوظيفها له في اتجاهين: مراكمة ثرواتها الخاصة وتعزيز مواقعها القيادية في طوائفها. لذلك بات قادة الطوائف يرون أن بقاءهم في السلطة السياسية وتعزيز مواقعهم فيها يرتبط إلى حد بعيد باستمرار النظام السياسي الطائفي. أما رعاة اتفاق الطائف، من جهتهم، فلم يروا أن هنالك حاجة إلى تسريع العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والعبور إلى الدولة المدنية. فالنظام السوري كان يعتقد أن استمرار وجوده في لبنان يصبّ في تعزيز نفوذه الإقليمي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التي كان همها الرئيسي في لبنان هو خروجه من الحرب الأهلية وانخراطه، بمختلف مكوناته السياسية والطائفية، في «عمليه السلام» التي كان يُحضّر لها مع إسرائيل.
بعد خروج سورية من لبنان، بات إنهاء المرحلة الانتقالية أيضًا، مستبعدًا. لأن الصراعات بين مراكز القوى السياسية الطائفية عادت لتحتدم من جديد على وقع احتدام الصراعات الدولية والإقليمية في المنطقة وعليها.
أما توغل النظام الاقتصادي في طابعه الليبرالي غير المنتج، فقد جاء نتيجة للمدى البعيد الذي بلغه الاندماج بين السلطتين السياسية والاقتصادية اللتين لم تغادرا، مصلحة وفكرًا، الرؤية الشيحية. هذا في وقت اجتاحت فيه العولمة النيوليبرالية مختلف أرجاء العالم.
إذا نظرنا إلى القوى التي أمسكت بزمام السلطة السياسية بعد الطائف، من زاوية مواقعها الاقتصادية الاجتماعية، نلاحظ أنها جاءت معبرة عن اندماج غير مسبوق بين مجموعتين: مجموعة من أمراء الحرب الذين كانوا قد أصبحوا خلالها أيضًا، رجال أعمال راكموا الثروات من مصادرتهم الأموال والأملاك العامة، ومجموعة أخرى، هي أصلًا من رجال الأعمال يجمع بينهم السعي وراء الربح السريع والفاحش ومراكمة الثروات في الداخل و/أو في الخارج، من ممارسة أنشطة خارج دائرة الإنتاج الحقيقي: مصرفيون، مقاولون، محتكرون للتجارة الخارجية، سماسرة. وقد وصل هذا الاندماج إلى درجة صار معها رأس المال الكبير ممثلًا برفيق الحريري على رأس السلطة التنفيذية، ويمسك في الوقت نفسه، بزمام القرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
1 – شيحية رفيق الحريري
من يقرأ الكتيِّب الذي وضعه الحريري الأب[10]، يكتشف أن رؤيته لمستقبل لبنان الاقتصادي بعد اتفاق الطائف، لا تختلف من حيث الجوهر، عن الرؤيه الشيحية. لذلك حظي الرئيس رفيق الحريري بتأييد البرجوازية المسيحية الكبرى التقليدية، بالرغم من غياب القيادات المسيحية الوازنة عن مسرح السلطة السياسية. ولم تعترض، كذلك، القيادات السياسية الشيعية والدرزية التي دخلت الحكم على إعادة إنتاج النظام الاقتصادي القديم، بالرغم من أنها كانت في السابق من الأيام، تشكو من نتائج هذا النظام على الصعيد الاجتماعي. كل ما في الأمر، أن هذه القيادات كانت، بين الحين والآخر، تعترض على بعض الإجراءات التي كان الحريري يقوم بها أو ينوي القيام بها، بسبب مسّ هذه الإجراءات بمصالحها الخاصة السياسية والاقتصادية.
وهكذا لم يتأسس مشروع النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار الذي تبنّاه الحريري على المندرجات التنموية التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، ولا على المقتضيات التي انطلقت منها. بل تأسس على الاعتقاد بأن الحرب الطويلة والمدمرة التي شهدها لبنان، كانت من قبيل كارثة طبيعية حلت بالاقتصاد اللبناني، وأن المهمة الرئيسية المطروحة على مشروع النهوض، هي إعادة إحياء النموذج القديم القائم على إنتاج الخدمات لحساب الخارج وفي الإطار الليبرالي نفسه، مع بعض التعديلات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية. لم يعر هذا المشروع أيضًا أي اهتمام بقطاعَي الزراعة والصناعة ولا بمسألة التفاوتات العميقة بين المناطق وبين الفئات الاجتماعية. كان هدفه الرئيسي إزالة العوائق أمام القطاع الخاص لكي يقوم بمهمة استئناف مسيرة النمو التي أوقفتها الحرب. كان ذلك يتم من خلال اقتصار دور الدولة على إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي إضافة إلى وضع الأطر القانونية والتنظيمية المُسهّلة والمُحفّزة لنشاط القطاع الخاص.
راهن الحريري لنجاح مشروعه، من جهة على تدفق المساعدات السخية من البلدان الشقيقة والصديقة ومن جهة ثانية، على حلول سريعة للسلام في المنطقة. ولما كان نصيب الرهان الأول هو الفشل، جرى تأمين التمويل من خلال الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية ومن الأسواق المالية بإصدار سندات خزينة بأسعار فائدة عالية جدًا. إضافة إلى زيادة الضرائب غير المباشرة، بحجة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، جرى خفض الضرائب غير المباشرة على الأرباح ورؤوس الأموال العائدة للشركات والأفراد.
2 – فشل مشروع النهوض الاقتصادي والتحول إلى نموذج اقتصادي جديد
بعد مضي نحو ثلاث سنوات (1993 – 1995) على انطلاق مشروع النهوض الاقتصادي، كانت النتيجة انخفاض معدل التضخم وتحسُن سعر صرف الليرة، إلى جانب إنجازات في مجال البنى التحتية، متفاوتة الأهمية، تركز معظمها في العاصمة ومحيطها. في المقابل، جاء الفشل مدويًا لناحية معالجة عجز المالية العامة. فبالرغم من الزيادات المتكررة في الضرائب غير المباشرة، لم تستطع الحكومة لجم الإنفاق المنفلت من عقاله، بسبب تعطش المنظومة السياسية المالية المتزايد لنهب المال العام والذي بات مرادفًا لوجودها في الحكم (ما سماه الحريري عملية شراء السلم الأهلي). هذا في وقت جاء فشل استعادة الدور الاقتصادي الإقليمي الوظيفي، مؤكدًا.
مع حلول عام 1996، بات مشروع النهوض الاقتصادي بحكم المتعثر، حيث وصل العجز في الموازنة إلى نحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى نحو 100 بالمئة منه. وهبط المعدل السنوي لنمو هذا الناتج إلى 3 بالمئة بعد أن كان في حدود 7 بالمئة. لكن لم يدفع ذلك إلى إعادة النظر في جوهر مشروع النهوض وصوغه على أسس جديدة، بحيث يتضمن خطةً للنهوض بالقطاعات عالية الإنتاجية، المُولّدة لفرص عمل كافية، كمًا ونوعًا، لاستيعاب أفواج الوافدين الجدد إلى سوق العمل، وتعمل في الوقت نفسه على ردم التفاوتات الاجتماعية والمناطقية. عوضًا من ذلك، مضت المنظومة الحاكمة في الأخذ في سياسات نقدية ومالية تقوم على مرتكزات ثلاثة: أولًا، التقيد بالرؤية التقليدية للاقتصاد اللبناني كاقتصاد وساطة يقوم على انتاج الخدمات لحساب الخارج؛ ثانيًا، الاستجابة للمبادئ النيوليبرالية بالقدر الذي لا يمس بمصالحها الخاصة؛ وثالثًا، تمكنها من الاستمرار في تحصيل الريوع اللازمة لتعزيز مواقعها المالية الخاصة ومواقعها السلطوية داخل طوائفها.
في هذا السياق، تم اتخاذ قرار بتثبيت سعر صرف الليرة على مستوى مبالغ بارتفاعه، وآخر يسمح بالاستدانة بالعملات الأجنبية. مثّل هذان القراران، إلى جانب الاستمرار بسياسة منح أسعار فائدة مرتفعة، العوامل الرئيسية لانطلاق نموذج اقتصادي جديد، يقوم على التدفقات المالية الخارجية، التي لم تُستخدم للاستثمار في تنمية القطاعات المنتجة، وإنما لتمويل استيراد الجزء الأكبر من حاجات الاستهلاك المحلي، إضافة إلى تمويل الإنفاق العام الجاري المنفلت من عقاله. وهو ما جعل الحاجة دائمة إلى المزيد من الاستدانة من أجل تغطية العجوزات المالية الداخلية والخارجية المتفاقمة. وهذا يعني أن الاستدانة باتت هي الداء والدواء في آن معًا. وبذلك أصبحنا إزاء نموذج مالي من النوع «البونزي».
جاءت حكومة سليم الحص (1999 – 2000) لتحاول كسر هذه الحلقة الجهنمية، لكنها لم تفلح. ومع عودة رفيق الحريري إلى الحكم عاد النموذج الجديد إلى مساره الذي أوصله أحيانًا إلى حافة الانهيار، نتيجة لضمور التدفقات المالية الخارجية. فكانت سلسلة مؤتمرات باريس 1 و2 و3 التي عقدتها الجهات المانحة لمساعدة لبنان، والتي لم تكن سوى مسكّنات تعمل على التخفيف من وطأة المرض الذي كان يعود ليتفاقم من جديد، فيتطلب جرعة أخرى من المساعدات. وفي كل مرة كانت الجهات المانحة تشترط أن يتعهد لبنان بتنفيذ لائحة الوصفات النيوليبرالية المعروفة. لكن معظم هذه الوصفات، ولعل أهمها، لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ، بسبب تعارضه مع مصالح أطراف في المنظومة الحاكمة. وكانت الجهات المانحة تغض الطرف لأسباب سياسية. غير أن هذا النموذج سيتلقى، وبالرغم من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيد المحلي، دفعًا قويًا في السنوات 2007 – 2010، بدعوى الارتفاع الكبير في حجم التدفقات المالية من الخارج، الذي تسبب به، أساسًا، استدراج القطاع المصرفي اللبناني، بواسطة أسعار الفائدة العالية التي كان يمنحها، لجزء من الرساميل الهاربة من الأسواق المالية العالمية من جراء الأزمة المالية التي اجتاحت، في هذه الأثناء، العالم الرأسمالي المتقدم.
3 – تَعطُّل النموذج الاقتصادي الجديد والدخول في أزمة نظامية عامة
تلا السنوات السمان الأربع سنوات عجاف عشرٌ، تضافر وتفاعل فيها عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الدولي والإقليمي: انتهاء الأزمة المالية العالمية، انخفاض سعر النفط، احتدام الصراعات بين القوى السياسية اللبنانية، والأهم كان احتدام الصراعات الإقليمية والدولية العنيفة في المنطقة العربية وعليها، وبخاصة في سورية. وكانت النتيجة، جفاف منابع التدفقات المالية الوافدة إلى لبنان، فبات لعجز الخزينة المالي توأم تمثل بعجز ميزان المدفوعات. وبهدف إعادة تكوين الاحتياطي من العملات الأجنبية عمد حاكم مصرف لبنان إلى إجراء هندسات مالية بهلوانية، عادت إلى المصارف التجارية بفوائد باهظة. ولمّا لم يتحقق هذا الهدف، توسلت الحكومة اللبنانية انعقاد مؤتمر رابع للمانحين في باريس تحت مسمى «سيدر». ولأن الأغلبية في هذه الحكومة كانت هذه المرة لفريق 8 آذار المساند لـ«محور المقاومة»، فإن الجهات المانحة لم تبدِ تساهلًا إزاء التردد في تنفيذ «الإصلاحات» المطلوبة. فأخذت تظهر بوادر أزمة مصرفية، جاءت في سياقها انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2019. وبدلًا من أن تؤدي هذه الانتفاضة إلى تغيير على الصعيد السياسي، يتدارك تفاعل الأزمة المالية والاقتصادية، ويحوّل مسارها الانحداري إلى النهوض على أساس رؤية بديلة لمستقبل لبنان الاقتصادي، وجدت المنظومة السياسية الحاكمة فيها فرصة لترك القطاع المصرفي يذهب بالأزمة المصرفية إلى مداها، الأمر الذي أغرق البلاد في أزمة نظامية عامة: سياسية، مالية، نقدية، مصرفية اقتصادية واجتماعية. أزمة وصفها خبراء البنك الدولي، بجانبها المالي الاقتصادي، واحدة من أسوأ/أشد ثلاث أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر[11].
بقيت هذه الأزمة النظامية تتفاعل نتيجة لتضافر عوامل ثلاثة:
(1) زيادة استعصاء الأزمة السياسية على الحل، بسبب حادثة انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020، وتقاذف المسؤوليات عن التسبب به وبالأزمة المصرفية. – قيام القطاع المصرفي وأجنحته السياسية بإجهاض خطتين «للتعافي المالي» حازتا رضى صندوق النقد الدولي.
(2) تولي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معالجة الذيول الاجتماعية للأزمة، مستخدمًا لذلك المال العام وأموال المودعين، على نحو يصب بالدرجة الأولى لمصلحة الأوليغارشية السياسية والمالية.
هنا نقف لنتساءل عمّا يمكن أن تؤول إليه هذه الأزمة النظامية العامة التي ما برح لبنان يعاني ارتداداتها حتى الآن. فهل ستنتهي، مرة أخرى، بإعادة إنتاج ثنائي الطائفية السياسية والاقتصاد الحر غير المنتج، بأشكال أخرى؟ أم أن الظروف قد نضجت لمجيء جمهورية ثالثة تخرج فيها، إلى حيز الواقع، الوعود العرقوبية للجمهوريتين الأولى والثانية بإقامة الدولة المدنية ووضع لبنان على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة؟
سادسًا: حول مسألة الخروج من الأزمة الحالية
يتطلب البحث في هذه المسألة، بادئ ذي بدء، التفتيش عن السبب الرئيسي الذي كان حتى الآن وراء عدم تحقيق تلك الوعود.
نرى، من جانبنا، أن هذا السبب يكمن في عدم قيام قوة سياسية اجتماعية جديدة، وازنة، قادرة على الوصول إلى الحكم، ومُصمّمة على الوفاء بالوعود المذكورة. ولكن ما الذي أعاق قيام مثل هذه القوة؟
تظهر لنا عناصر الجواب عن هذا السؤال من خلال رصدنا المسار التاريخي الذي أخذه الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي، والذي تحكّم به لقاء وتفاعل العوامل الثلاثة: الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج[12]. فهذا التفاعل بين العوامل المذكورة، بأشكاله وأبعاده المختلفة التي أخذها في الجمهوريتين الأولى والثانية، جعل الانقسامات والتناقضات العمودية في المجتمع اللبناني تطغى، إلى حد بعيد، على الانقسامات والتناقضات الأفقية، ولا سيَّما الطبقية منها. لذلك بقي الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي على قدر كبير من الهشاشة، يعيش حالة دائمة من الانقسام، تبقيه، ليس فقط، عاجزًا عن توليد دينامية وطنية ذاتية دافعة لتغيير نوعي/بنيوي، وإنما أيضًا، عاجزًا عن فرز آليات لضبط التناقضات التي كانت تعتمل داخله. وهذا ما جعل الوجهة التي يأخذها الاجتماع اللبناني، ولا سيَّما عند المنعطفات الرئيسية التي مر بها، لا تتحدد، بوجه رئيسي، نتيجة متغيرات في موازين القوى بين الفئات الاجتماعية المحلية، وإنما بفعل العامل الخارجي، وعلى وجه الخصوص المتغيرات في العلاقات التي قامت بين الداخل العربي والمراكز الرأسمالية الغربية وحليفتها إسرائيل.
ويُلاحظ المتتبع لمسلسل الأزمات التي مر بها لبنان منذ حصوله على الاستقلال، أنها بدأت مع صعود حركة التحرر الوطني في المنطقة العربية، وأنها كانت تأتي باستمرار نتيجة للصراع المزدوج بين مراكز القوى السياسية الطائفية المحلية: صراع على مواقع القرار في السلطة السياسية وفي الوقت نفسه صراع على موقع لبنان في الاصطفاف بين حركة التحرر الوطني العربية من جهة، والغرب الاستعماري وحليفته إسرائيل من جهة ثانية. ويُلاحظ المتتبع نفسه، أن مراحل الاستقرار النسبي التي كانت تفصل بين أزمة وأخرى، كانت تأتي نتيجة لدخول الأطراف الدولية والإقليمية المتصارعة في المنطقة وعليها، في مرحلة من التسويات المؤقتة التي تقضي بعقد تسويات مشابهة بين الأطراف اللبنانية المتصارعة؛ من دون أن تؤدي هذه التسويات، في لبنان، إلى تغيير جوهري في نظام الطائفية السياسية والاقتصاد الحر غير المنتج. في هذا السياق بات «الخارج» بمنزلة عامل داخلي، يؤدي دورًا مفصليًّا في تحديد الوجهة التي تأخذها حركة الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي. وهذا ما يقودنا إلى التساؤل: هل الأزمة التي تعصف بلبنان في الوقت الحاضر، عملت وتعمل على تكوين قوة اجتماعية قادرة على فرض رؤية مغايرة لمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، أم أن مآل هذه الأزمة يبقى في عهدة الخارج، وكيف؟
ما يمكننا قوله في الإجابة عن هذا السؤال، وباختصار شديد، هو أن الفشل التغييري لانتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 2019، واستمرار الصراع، لا بل بلوغه الحدود القصوى، بين القوى السياسية اللبنانية على موقع لبنان في الاصطفافات الدولية والاقليمية، لا يؤشر بأي حال، إلى أن التغيير المنشود في لبنان سيأتي، في المدى المنظور، على يد قوى محلية، بل إن مآل الأزمة بات، كما كان مآل الأزمات السابقة، في عهدة الخارج؛ إنما في ظروف إقليمية ودولية جديدة تجعلها تختلف عمّا سبقها من أزمات. ليس فقط لناحية الأبعاد السياسية والاقتصادية التي تأخذها على الصعيد المحلي، وإنما أيضًا لناحية الدور الذي صار يؤديه الخارج في تقرير مصيرها.
باتت الأزمة اللبنانية الحالية، في الواقع، جزءًا لا يتجزأ من الأزمات النظامية/البنيوية التي أخذت تعصف ببلدان المنطقة منذ عام 2011. فالعوامل التي كانت وراءها هي، بوجه عام، العوامل نفسها التي كانت وراء الأزمات العربية. وكذلك في ما يتعلق بالأبعاد التي أخذتها. وهذا ما يجعلنا نرى أن المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة في الوقت الحاضر هي مرحلة مصيرية شبيهة بالمرحلة التي مرَّا بها بعد سقوط السلطنة العثمانية (تقسيم المنطقة ودخولها في دائرة التبعية للنفوذ الغربي). وهذا ما يجعلنا نخرج بنتيجة رئيسية مفادها؛ أن أزمة الاجتماع اللبناني السياسية والاقتصادية الحالية ترتبط عضويًا، على نحو وثيق، بعجز حركة التحرر الوطني في المنطقة عن إنجاز مهمتها التاريخية المتمثلة بالتخلص من الهيمنة الاستعمارية/الإمبريالية الغربية والاحتلال الصهيوني لفلسطين، والسير قُدُمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستقلة ودولة المواطنة الديمقراطية. وعليه، فإن مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي بات، أكثر من أي وقت مضى، يتوقف على مدى تمكن حركة التحرر الوطني هذه من الخروج من أزمتها التاريخية.
إلى أن يتحقق هذا الأمر، لا نتوقع، أن تقوم في المدى المنظور، جمهورية ثالثة في لبنان على مرتكزات مغايرة، من حيث الجوهر، لمرتكزَي الطائفية السياسية والاقتصاد الحر غير المنتج. فمن ناحية، لا تزال الرؤية الشيحية لمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي راسخة الجذور لدى القوى السياسية والنخب النافذة من مختلف الطوائف. ومن ناحية ثانية، فإن هذه القوى لا ترى مخرجًا من الأزمة إلا على يد مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية العاملة لمصلحة الهيمنة الغربية.
كتب ذات صلة:
اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية: جدلية الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج
دولة المصارف : تاريخ لبنان المالي
أفكار في الدولة اللبنانية: وقائع في الفشل وتطلعات إلى البناء
المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 556 في حزيران/يونيو 2025.
نجيب عيسى: أستاذ سابق في الجامعة اللبنانية وباحث اقتصادي.
[1] تمثّل هذه الدراسة خلاصة الكتاب الذي صدر حديثًا عن مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان: اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية: جدلية الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج.
للحصول على الكتاب الرجاء الضغط على الرابط:
اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية: جدلية الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج
تضمن هذا المقال ثلاثة مصطلحات مفتاحية هي «الخارج» و«الطائفية السياسية» و«الاقتصاد غير المنتج» واقتضى منا توضيحها على النحو التالي:
– الخارج: نقصد به: المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية المؤثرة في حركة الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي. ومن ضمنها المتغيرات في العلاقة بين المراكز الرأسمالية المتقدمة وبلدان المنطقة العربية على الصعيدين المذكورين، ولا سيَّما ما يتعلق منها بموازين القوى في الصراع بين حركة التحرر الوطني في المنطقة والغرب الاستعماري – الإمبريالي وحليفته إسرائيل.
– الطائفية السياسية: نقصد بها: النظام السياسي الذي أخذ فيه لبنان والقاضي بتوزيع المناصب في مؤسسات الحكم السياسية (التشريعية والتنفيذية) والإدارية على أساس حصة معيَّنة منها، لكل من مكوناته الطائفية.
– الاقتصاد غير المنتج: نقصد به: الاقتصاد الذي لا يقوم أساسًا على قاعدة محلية من الإنتاج المادي (الزراعي والصناعي) والخدمات (التجارة ضمنًا) المرتبط نموها، مباشرة، بنمو هذا الإنتاج المادي المحلي. وعليه، فإن الاقتصاد غير المنتج في الحالة اللبنانية هو الذي كان محرك نموه الرئيسي في الجمهورية الأولى، إنتاج الخدمات لحساب الخارج، وبات محرك نموه الرئيسي في الجمهورية الثانية التدفقات المالية من الخارج التي تصب في تمويل قطاعات إنتاج غير قابل للتبادل مع الخارج.
[2] انظر: جانينا سانتر، «نشأة القطاع السياحي ونموذج «لبنان سويسرا الشرق»،» (ملف مئوية لبنان 1920 – 2020)، بدايات، العددان 28 – 29 (2020).
[3] انظر: مروان بحيري، «دور بيروت في الاقتصاد السياسي للانتداب الفرنسي 1919 – 1939،» بدايات، العددان 28 – 29 (2020).
[4] انظر: بول سالم، «أفكار حول القومية اللبنانية،» أبعاد، العدد 1 (أيار/مايو 1994).
[5] بالاستناد إلى المصادر والمراجع التالية: Michel Chiha: Propos d’économie libanaise (Beyrouth Éditions du Trident, 1965), et Visage et présence du Liban (Beyrouth: Cénacle Libanais, 1984).
انظر أيضًا: جورج قرم، «الاقتصاد في محاضرات الندوة اللبنانية،» في: عهد الندوة اللبنانية (خمسون سنة من المحاضرة) (بيروت: دار النهار، 1997)، وفواز طرابلسي، صلات بلا وصل: ميشال شيحا والأيديولوجيا اللبنانية (بيروت: رياض نجيب الريس للكتب والنشر، 1999).
[6] انظر على سبيل المثال: سعيد حمادة، «مشاكلنا الاقتصادية وكيف نعالجها: محاضرة ألقيت في 6 ك 2 سنة 1947،» محاضرات الندوة اللبنانية = Les conférences du cénacle libanais: السنة 1، العدد 6 (تشرين الأول/أكتوبر 1947)؛ ألبير بدر، «نحو آفاق اقتصادية جديدة،» محاضرات الندوة اللبنانية، السنة 14، العددان 3 – 4 (1960)، وNaim Amyouni, «Transmitting a Survey of the Economic Problems of Lebanon,» Address delievered at American Junior Collège FSOUSA, No. 1258, Beirut, 3 July 1946.
[7] انظر: هشام صفي الدين، دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2021).
[8] انظر: فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف (بيروت: رياض الريس للكتاب والنشر، 2008).
[9] Répubilique Libanaises, Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban; étude préliminaire, 2 tomes (Beyrouth: Mission IRFED, 1960-1961), tome 1.
[10] رفيق بهاء الدين الحريري، الحكم والمسؤولية: الخروج من الحرب والدخول في المستقبل، ط 2 (بيروت: منشورات الشركة العربية المتحدة للصحافة، 1999).
[11] The World Bank, «Lebanon Sinking (to the Top 3),» Lebanon Economic Monitor (Spring 2021).
[12] Ibid.
نجيب عيسى
باحث اقتصادي عربي من لبنان، من مواليد عام 1944. حائز شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ودبلوم في علم السكان من جامعة باريس الأولى. درّس في الجامعة اللبنانية وحاز رتبة الأستاذية. تولّى سابقًا في الجامعة نفسها إدارة معهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول، وعمادة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال. عمل بصفة استشاري لدى عدة منظمات دولية. له الكثير من المؤلفات (كتب ودراسات ومقالات) تتناول مختلف قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان والبلدان العربية، منها: سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان: اقتصاد المعرفة كمدخل لاستراتيجية الخروج من الأزمة (2018)؛ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان (2003)؛ النفط والمجال الاقتصادي العربي: دراسة في الأبعاد التكاملية لأنماط التنمية في الأقطار العربية (1991)؛ قضايا التشغيل والتنمية البشرية في البلاد العربية (1977)؛ نموذج التنمية في الخليج والتكامل الاقتصادي العربي (1976).
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.