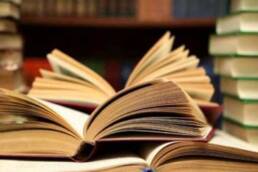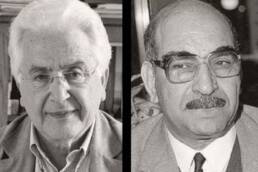مقدمة
تعالج هذه الدراسة أزمة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. ونحن نزعم أن موضوع أزمة هذا الفكر هو موضوع شديد الأهمية، لم ينل في اعتقادنا ما يستحقه من الدراسات التحليلية النقدية، ولم يحظَ بما يكفي من النقاش العلمي والأكاديمي المطلوب[1]، رغم كثرة الكتابات وسيل النقاشات في قضايا الفكر الإسلامي، وبخاصة ما يتعلق بالفكر الإسلامي السياسي، التي يغلب عليها طابع البحث التاريخي الذي يتتبع النشأة والمراحل والسياقات التاريخية. وغني عن البيان القول إن هذا الفكر تأثر بمحيطه الاجتماعي والسياسي والثقافي، لكنه في الوقت نفسه مارس هو كذلك تأثيرًا في هذا المحيط، ويبرز تأثره وتأثيره بصورة واضحة في توظيفه المكثف لرأس المال الرمزي الأول للمجتمعات العربية، ألا وهو الدين الإسلامي. ونحن نعرف أن الدين هو قدس الأقداس في مجتمعات كهذه، وتلك مسألة خطرة جدًّا.
تعالج هذه الدراسة أسباب نزول نشأة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، وبعبارة أخرى، الظرفية التاريخية، وبالأخص منها السياقات السياسية، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، التي ولد وترعرع في كنفها خطاب الإحيائية الإسلامية، إضافة إلى كشف وفهم البيئة السياسية المحلية التي تأزم فيها. ندخل بعد ذلك في صلب الموضوع، وهو عرض أزمة هذا الفكر وتشخيصها وتحليل أزمته البنيوية التي تتمظهر بخاصة في صدامه الدائم مع العصر ومع العالم واشتباكه الذي لا يهدأ مع القوى الوطنية. باختصار، نحاول أن نفهم كيف تأزم الفكر السياسي الإسلامي، ولماذا كان يزداد تأزمًا، وبخاصة ما يسمى الإسلام الحزبي؛ نقصد الأحزاب السياسية التي توظف الدين لأغراض سياسية، والتي خرج الإسلام المسلح من رحمها، أي الجماعات والتنظيمات الأيديولوجية المتطرفة التي خرجت على المجتمعات العربية شاهرة سيفها. ونسعى في هذه الأسطر للإمساك بحقيقة بداية تكوّن الفكر السياسي الإسلامي المعاصر أولًا، وتشخيص أزمته ثانيًا، من طريق قراءة الأسباب والعوامل التي أفرزت هذا التسييس المفرط للدين من ناحية، وهذا التديين المُفرط للسياسة من ناحية أخرى، بدءًا بالرائد الشيخ محمد رشيد رضا ومرورًا بكل من مؤسس الإسلام الحزبي حسن البنا وبالأب الروحي لخطاب تكفير المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية سيد قطب. والسؤال: هل كانت الظرفية التاريخية التي نشأ في ظلها الفكر السياسي الإسلامي المعاصر عاملًا حاسمًا في تأزمه، أم أن تأزمه نتاج تشوّه خِلْقي وبسبب تركيبته الأيديولوجية – الدوغمائية؟
أولًا: نهاية نظام الخلافة
الأمر المؤكد اليوم، أن تأسيس حركة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا عام 1928 في مدينة الإسماعيلية في مصر هو بداية ما يعرف اليوم باسم الإسلام السياسي السنِّي. أي بداية القول في العصر الحديث، وعند السنَّة، الدولة ركن من أركان الدين. كما تجدر الإشارة إلى أنه من رحم هذه الجماعة الأم، خرجت كل حركات الإسلام السياسي، ومن جوف الإسلام السياسي ولدت التنظيمات المسلحة التي أطلقت الرصاص على الجميع، تنظيمات مثل التنظيم المعروف إعلاميًا باسم «التكفير والهجرة» بزعامة شكري مصطفى، وتنظيم الفنية العسكرية بقيادة صالح سرية، وتنظيم الجهاد، والجماعة الإسلامية وغيرها من التنظيمات، هذه الجماعات التكفيرية التي أعلنت عن نفسها بعمليات استعراضية في الثمانينيات، رافعةً رايةَ «الجهاد» ليس في دار الحرب هذه المرة، بل في دار الإسلام، بدعوى «جاهلية القرن العشرين» وضد حكام «الطاغوت». ومع مرور الوقت، ارتفع منسوب القتل ضد شرائح وفئات اجتماعية كثيرة، بالتوازي مع ارتفاع منسوب التطرف، وفي الوقت نفسه مع تزايد معدلات الفقر والجهل في المجتمعات العربية، من دون أن ننسى أن كل ذلك كان يجري في مناخ سياسي استبدادي وتحت الظلال الوارفة للدولة التسلطية. ومن نافلة القول أن العنف هو نتاج أيديولوجيا متطرفة، فالعنف المادي هو تعبير عن العنف الفكري، وخطاب العنف يعكس فكرًا يعاني اضطرابات نفسية وعقلية حادة.
لهذا لم تتوانَ جماعات الإسلام السياسي بمختلف التيارات السياسية في الانتقال من الدعوة إلى الإرهاب[2] والدخول في صراع قاتل مع القوى السياسية الوطنية. كما دخلت في مواجهة غير مبررة مع العصر. ليس هذا فحسب، بل سوَّغت هذه الجماعات ممارسة العنف المُنفَلت من كل عُقال، مستخدمة ألفاظًا وكلمات قرآنية، لها رنين خاص عند المسلمين من قبيل الجهاد والقتال والغزو. وبسبب العنف والعنف المضاد، بين الجماعات السياسية – الدينية والأجهزة الأمنية، منذ سبعينيات القرن العشرين، أقول إن هذا العنف الأعمى، كان سببًا رئيسيًا في وقوع تحولات سياسية كبرى، وساهم في ظهور تشققات اجتماعية عميقة، إضافة إلى التمزقات الفكرية والشروخ الثقافية شديدة الخطورة في الوطن العربي. مثلت هذه الجماعات الجهادية، بالفعل وبالقوة، تهديدًا للسلم الاجتماعي وخطرًا على الوحدة الوطنية للكثير من البلدان العربية، وكانت عاملًا من عوامل تفكك المجتمعات[3]. وكما أشرنا آنفًا، ظهر الفكر السياسي الإسلامي في عشرينيات القرن الماضي، وتكوَّن في مرحلة ما بين الحربين. أي أنه وُلد وشبّ في حقبة حافلة بتحولات الفكر والسياسة في المشرق العربي[4]. أفرزت هذه التحولات قضايا وآراء وأيديولوجيات. ووجهت تفكير الإنتليجنسيا إلى موضوعات وقضايا بعينها، بالنظر إلى الظرفية التاريخية المعقدة، وفي منطقة تعج بـ«المِلل والنحل»، وكذلك بسبب تزايد شدة الاختراق الأوروبي/الإمبريالي، وما أحدثه من تفكك للبنى الاجتماعية/الفكرية والثقافية؛ فعلى المستوى السياسي يعدّ قرار إلغاء الخلافة بمنزلة الرجّة التي أفقدت النخب العربية/الإسلامية توازنها. رحَّب البعض بالقرار وصفق للدولة الوطنية الناشئة، والبعض الآخر لم يرحب لا بالقرار ولا بنشوء نظام الدولة الوطنية.
وكان الشيخ رشيد رضا من الذين صدمهم قرار الإلغاء، وما كتابه الخلافة والإمامة العظمى إلا دليل قاطع على صدمة بدايات انفصال السلطان عن القرآن، ومفارقة الخلافة للسلطنة. وعلى النقيض من ذلك يعدّ صدور كتاب الإسلام وأصول الحكم ضربة موجعة لمقولة الإسلام دين ودولة، فقد زعزع هذا الكُتيّب الكثير من اليقينيات وأحدث رجّة في الكثير من القناعات. ولا يجادلن أحد بأن الفكر السياسي الإسلامي المعاصر هو أحد مُخرجات إلغاء الخلافة العثمانية السنية، إذ أصيبت النخبة الإسلامية بالصدمة وشعرت بالضياع بعد سقوط الخلافة، لأنه، ما كان لأحد أن يتصور وجودًا للأمة من دون مظلة الخلافة. كما ذكرنا سابقًا، عرفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحداثًا عاصفة غيرت تمامًا ليس فقط الخريطة الجيوسياسية، بل غيرت الخريطة الثقافية – الفكرية وموازين القوى لمصلحة القوى الاجتماعية الجديدة. كانت الهزة الكبرى، أو، إن صح التعبير، مركز الزلزال، هو السقوط المدوي للإمبراطورية العثمانية، بعد الهزيمة القاسية التي تعرضت لها في الحرب الكونية الأولى، التي في إثرها اقتسم الحلفاء الكثير من أراضيها، بل وصل الأمر إلى دخول عاصمة الخلافة السنية، كما تم الاستيلاء على الولايات العربية التابعة لها على يد القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك، بأسماء لها قدر كبير من المكر والخديعة، من قبيل الحماية والانتداب، طبقًا لسياسات القوى الاستعمارية والإمبريالية لاتفاقية سايكس – بيكو عام 1916[5].
ولكن في المقابل، من الآثار الإيجابية، إن صح هذا التعبير، لهذا القرار، عودة السجالات الفكرية في موضوع العلاقة الشائكة بين السلطان والقران، كما تجدد النقاش بين الفصائل السياسية – الفكرية حول دور الدين ووظيفته في الدولة الوطنية الناشئة، كما عاد السجال إلى نقطة الصفر في موضوعات الإسلام والغرب وقضايا التاريخ والتراث، ومسائل الفقه والاجتهاد. والأمر الملاحَظ أن جذوة المناقشات اشتعل أوارها مباشرة بعد قرار الجمعية الوطنية التركية بالفصل بين الخلافة والسلطنة، أي الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية، وازداد النقاش حدةً بعد قرار الإلغاء. وقد أنفق الفكر العربي – الإسلامي الكثير من الوقت والجهد في محاولة استعادة الخلافة سواءٌ بصيغتها القديمة أو بصيغتها المعدلة أو بأي صيغة أخرى. ومن هذه المحاولات التي تُنسب إلى الإسلام الحزبي، محاولة حزب التحرير الإسلامي الذي أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني في القدس عام 1952 تحقيق هدف استراتيجي هو عودة الخلافة الإسلامية بأي شكل وبأية صيغة[6]! وما يلفت الانتباه، أن قطاعًا واسعًا من الإسلاميين، ما زال يعتقد اعتقادًا راسخًا بأن عودة الخلافة ضرورة حتمية، وما إعلان أبو بكر البغدادي من على منبر أحد مساجد الموصل عن قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عام 2014 إلا دليل على ذلك.
ثانيًا: خطوةٌ إلى الأمام وعشرٌ إلى الوراء
نتفق مع دارسي الفكر الإسلامي، الذين يَعدّون صدور كتاب الشيخ محمد رشيد رضا الخلافة أو الإمامة العظمى عام 1922 بمنزلة الميلاد الرسمي للفكر السياسي الإسلامي المعاصر، الذي أفرز فيما بعد جماعات الإسلام الحزبي – الصحوي، وفي الوقت نفسه كانت بداية الفكر السياسي هي نهاية خطاب الإصلاحية العربية، خطاب جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي وقاسم أمين. وشاءت الظروف أن يكون أول من دشن القول في خطاب الإصلاحية العربية بعد قرار الفصل هو الشيخ محمد رشيد رضا (1865 – 1935)، وذلك في سلسلة مقالات بدأها عام 1922، وجمعها في كتاب بعنوان الخلافة أو الإمامة العظمى. والغريب في الأمر أن الشيخ محمد رشيد رضا لم يكن يدري أن كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى الصادر عام 1922 سيكون الخط الفاصل بين الخطاب السياسي العربي النهضوي وخطاب الإسلام السياسي[7].
تجدر الإشارة هنا إلى أن خطاب الإصلاحية العربية، هو خطاب متصالح مع الدولة الحديثة والتنظيم السياسي الديمقراطي ويؤمن بالمواطَنة والدستور والبرلمان والعقد الاجتماعي، فهو خطاب منفتح على العصر وعلى الحضارة الإنسانية. وما يلاحظ على الفكر العربي النهضوي، أنه قطع مع مقولات ومفاهيم الفكر الإسلامي الوسيط، فكر الآداب السلطانية والسياسة الشرعية، أما الفكر السياسي الإسلامي المعاصر فقد أعاد خطوط الاتصال مع مفاهيم ومقولات الفقه السياسي السنِّي الوسيط والسياسة الشرعية، أي مع فكر الماوردي والطرطوشي وابن تيمية والقرافي. الذي تتردد فيه مفاهيم ومقولات تراثية قروسطية، مثل الشورى، البيعة، وأهل الحل والعقد[8]. وزيادة في التوضيح نقول إن الفكر السياسي الإسلامي المعاصر رفض رفضًا قاطعًا مفاهيم الحداثة السياسية وناصبها العداء، وفي الوقت نفسه استعاد بقوة مفاهيم الفقه السياسي السنِّي، بل تبنى مسلّمة أساسية من مسلّمات الفقه السياسي الشيعي وهي أن الخلافة/الإمامة ركن من أركان الدين، بمعنى أنها مسألة عقدية لا فقهية[9].
هكذا نستنتج أن بدايات الفكر السياسي الإسلامي هي نفسها بدايات تأزُّمه، والمفارقة أن البداية كانت مع أحد رموز الإصلاحية وهو الشيخ محمد رشيد رضا في مقالاته التي نشرها في مجلة المنار، في أولى سنوات عشرينيات القرن الماضي. وبذلك يكون الشيخ الإصلاحي بكتابه عن الخلافة قد عاد القهقرى إلى الوراء، عندما قطع مع الخطاب العربي الحديث، خطاب النهضة العربية، خطاب الطهطاوي والتونسي والبستاني، الخطاب الذي اكتشف الدولة الحديثة، وأُعجب بهذا النموذج الأوروبي الحداثي وبهذه الدولة القوية، وانبهر بجيشها النظامي، واستحسن مؤسساتها السياسية/الدستورية. والحقيقة أن الخطاب النهضوي، هو خطاب يروم النهضة ويسعى للتقدم[10]، وليس غريبًا أن يكون سؤاله المركزي هو: كيف نتقدم؟ وما كانت تشغل الفكر النهضوي إطلاقًا، موضوعة الخلافة، بل كانت تحركه هواجس أخرى، من بينها كيفية غرس نموذج الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية، وكانت تؤرقه كيفية توطين مفاهيم الفلسفة السياسية الليبرالية، وبالأخص فلسفة القرن الثامن عشر الأنوارية. والمفارقة العجيبة، أن خطاب رشيد رضا «الشاب» يَنتمي فكريًا إلى الإصلاحية العربية، فهو تلميذ الشيخ محمد عبده، وبقي يسير في الاتجاه الإصلاحي نفسه حتى عام 1920 عندما غيّر الوجهة الأيديولوجية وتحول إلى الاتجاه السلفي/الوهابي، وانقلب رأسًا على عقب، ليس على فكر محمد عبده الإصلاحي/التربوي – الفقهي – المقاصدي فقط [11]، بل انقلب على خطاب الإصلاحية العربية برمَّته، وبذلك يكون قد أعطى إشارة الانطلاق لما يسمى في أدبيات تاريخ الأفكار: الفكر الإسلامي السياسي المعاصر، فكر الحركات الإسلامية، التي يسميها البعض من الدارسين تسميات جمّة، منها الإسلام السياسي، أو كما يطلق عليه عبد الإله بلقزيز اسم الإسلام الحزبي، أو الإحيائية الإسلامية كما يحب أن يسميها رضوان السيد[12].
ثالثًا: الماضي… هو المستقبل
لا نحتاج إلى شرح كبير للقول إن أزمة الفكر السياسي الإسلامي هي أزمة خِلْقِية وُلدت معه أي منذ نشأته، فهو بذلك فكر مأزوم بنيويًا، إذا جاز هذا القول، فكر سياسي تكوَّن أساسًا كردِّ فعل على الأحداث السياسية والتطورات الثقافية والتحولات الاجتماعية. وما لا شك فيه أن مفكري الإسلام السياسي بذلوا مجهودًا ضخمًا في محاولة إيقاف عقارب الساعة أولًا وفي العودة إلى الوراء ثانيًا، كما حاولوا من خلال سيل من الكتابات منذ ثلاثينيات القرن الماضي تبرير الدعوة إلى استعادة مجد الخلافة الضائع، بأي صورة من الصور وبأي صيغة من الصيغ، سواء أكانت بصيغة قديمة أم بصيغة معدلة. بعبارة أكثر صراحة، عبّر مفكرو الإسلام السياسي عن رغبتهم في العودة إلى الماضي، وفي الوقت نفسه عبّروا عن رفضهم الحاضر. وغني عن البيان القول إن أبرز وجوه أزمة الفكر الإسلامي، هي محاولته العبثية في استعادة نظام سياسي – سلطاني – إمبراطوري، نشأ وتكوَّن في سياقات تاريخية معيَّنة، كما تجلى هذا النظام في عدة صيغ وتسمى عدة مسميات. ومن مفارقات التاريخ، أن هذه الدولة السلطانية المسماة الخلافة، قامت في عدة مناطق في العالم الإسلامي وفي الحقبة الزمنية نفسها، في القرون الوسطى، والدليل على ذلك وجود ثلاث «خلافات» في الحقبة التاريخية نفسها، وهي الخلافة العباسية في العراق والخلافة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في مصر[13].
لكن الخلافة بوصفها نظامًا سياسيًا، استنفد دوره التاريخي، ووصل إلى مرحلة الشيخوخة بلغة ابن خلدون، بله مرحلة المرض العضال في نهاية القرن التاسع عشر! رغم محاولات الإصلاح الكبيرة التي قام بها السلاطين المسماة «التنظيمات» في النصف الأول من القرن التاسع عشر. نذكر فقط أن كتاب الخلافة أو الإمامة العظمى جاء ردًا على قرار الفصل بين السلطة الروحية والسلطة السياسية عام 1922، كما نسجل ملاحظة وهي أن رشيد رضا كان يراهن على إحياء نظام الخلافة العثمانية وبقائها ولو بصيغة مُعدلة. لكن يجب أن يبقى هذا النظام الإسلامي ويستمر مهما كان الثمن! خلاصة القول أن محمد رشيد رضا الشيخ لا يرى بديلًا من الخلافة الشرعية ولا يرى نموذجًا آخر صحيحًا غير الخلافة الراشدة، أما رشيد رضا الشاب (قبل الانقلاب) فقد كان يرى أن التقدم لن يتحقق إلا مع الدولة الليبرالية الحديثة، وتلك مفارقة من مفارقات الفكر السياسي الإسلامي المعاصر! لهذا كان متوقعًا أن يتم إخراج نصوص بعض «فقهاء السلطان السنّة» في العصر الوسيط من الأرشيف، وبالأخص فقه الماوردي والقرافي والطرطوشي، وأن يتم الاستناد إلى مبدأ الشورى وأن يتمسك بصيغة أهل الحل والعقد. واستدعاء مفاهيم ومقولات كهذه تعود إلى القرون الوسطى، لا بد من أن يقابله استبعاد مفاهيم ومقولات أخرى. بعبارة أفصح، استدعاء المعمار الفكري للفقه السياسي الآداب السلطانية والسياسة الشرعية، أقصد كتَّاب الدواوين ومن سار من الفقهاء على دربهم، أمثال ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب وابن قتيبة والطرطوشي المرادي وابن الأزرق، أو من فكر فقهاء الخلافة أمثال الماوردي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والقرافي، يؤدي وفي الوقت نفسه إلى إزاحة المنظومة الفكرية الليبرالية والفلسفة السياسية الحديثة، أي وضع إطار مرجعي إسلامي سني في مواجهة إطار مرجعي سياسي – حداثي – أوروبي. وهذا يقود حتمًا إلى تكريس الوعي الشقي في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، وعي مأزوم يتأرجح بين مجموعة الثنائيات المتناقضة، دولة الخلافة/الدولة الوطنية، الدولة الدينية/الدولة المدنية، الشريعة – القانون، ومن ثم تكريس الأزمة على المستوى النظري وعلى مستوى الواقع السياسي والاجتماعي، من خلال تفويت فرصة التفاعل مع الفكر السياسي الحديث وعدم الاستفادة من التجارب السياسية الأوروبية.
نرى من الضروري التوقف عند مسألة أخرى هنا، ونحن نحلل آليات التفكير في خطاب رشيد رضا وهي ربطه المحكم بين الدين والدولة، بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية. باختصار الشيخ السلفي هو أول من رفع شعار «الإسلام دين ودولة» وهو نفسه – أي الشعار – سيصبح إحدى المسلّمات الأساسية (أساس المشروعية) في خطاب الإسلام السياسي مثله مثل مسلّمة تطبيق الشريعة. وإذا حللنا معنى هذا الشعار وجدناه يقول إن الإسلام لا يستقيم إلا بوجود دولة والدولة تكون فاقدة للمعنى من دون الإسلام. بعبارة أخرى أصبح من مُسلمات الإسلام السياسي السني إقامة الخلافة ونصب الإمامة وبناء الدولة الإسلامية، أي أضحت الإمامة في الخطاب السني المعاصر، ركنًا من أركان الدين وأصلًا من أصول الدين، علمًا أن الأمر لم يكن كذلك في الخطاب السني القديم سواء في أصول الفقه أو في أصول العقيدة، على خلاف المذهب الشيعي الذي كان وما زال يرى أن الاعتقاد في الإمامة جزء لا يتجزأ من الإيمان. بعبارة أخرى ما كان في الإسلام السني من أصول الفقه أصبح من أصول الدين، ما كان من الفروع صار من الأصول، وهو تحول على مستوى التفكير، شديد الخطورة وبالغ الأهمية وكثيف الدلالة.
رابعًا: الدولة الإسلامية.. مقابل الدولة الوطنية
سوف تتكرس أزمة الفكر السياسي الإسلامي، بأنه ليس فقط لم يقم بإصلاح فكري، ولم يجدد في الفقه، ولم يجتهد في التشريع، ولم يتفاعل إيجابًا مع النزعة العقلانية التجديدية/النقدية الجديدة التي كانت تخطو خطواتها الأولى في الفكر العربي الحديث والمعاصر، بل إنه حارب بلا هوادة كل من تُسوّل له نفسه من مفكري تيار التحديث والتنوير في الفكر العربي. كما سعى مفكرو الإسلام السياسي إلى وأد هذا التيار الفكري الوليد في المهد، أقصد الخطاب الليبرالي العربي المتواصل مع خطاب الإصلاحية، الخطاب الذي انتقد التراث العربي – الإسلامي مع طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي، وانتقد نظام الخلافة مع الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، وانتقد الوضع الاجتماعي مع الطاهر الحداد. والحقيقة التي لا مراء فيها، أنه منذ بداية عشرينيات القرن الماضي تصاعدت حدة النقاش في قضايا الدولة والدين والخلافة والسياسة والعروبة والإسلام والتاريخ، وكانت بداية الاستقطاب بين تيارين أيديولوجيين، التيار العلماني/الليبرالي والتيار الإسلامي/الديني.
لن نأتي بجديد، إذا قلنا إن تأسيس جماعة الإخوان المسلمين على يد «المُعلم» حسن البنا (1906 – 1949) عام 1928 في مدينة الإسماعيلية في مصر، كانت من أهم تداعيات السقوط المدوي للخلافة العثمانية السنية، بالتزامن مع نشوء نظام سياسي جديد لم يعهده العرب ولا خطر ببال المسلمين، هو نظام الدولة الوطنية الناشئة، ليس في مصر والعراق وسورية فقط، بل في بلاد الترك في حد ذاتها، عندما أعلن مصطفى كمال عن قيام الجمهورية التركية عام 1924. والأمر المؤكد أن إعلان قيام الجمهورية التركية بحدودها الحالية، كان بمنزلة نهاية نظام الدولة السلطانية، القائمة على شرعية «سياسة الدنيا وحراسة الدين»، كما تزامن هذا الإعلان مع نشوء الدولة الوطنية القائمة على مبدأ المواطنة.
ومن المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين ظهرت في مناخ سياسي مشحون بالصراعات السياسية والحزبية والأيديولوجية في الداخل المصري، صراع من أجل دولة وطنية ليبرالية وملكية دستورية، وصراع الحركة الوطنية مع القوى الاستعمارية والإمبريالية من أجل الاستقلال. ومن البديهي القول، إن فكر حسن البنا هو فكر الجماعة وفكر الجماعة هو فكر حسن البنا. لهذا وعلى المستوى السياسي رفض الشيخ المؤسس تسمية جماعته باسم «حزب الإخوان» كما رفض تمامًا مصطلح الحزب، بدعوى أن الأحزاب السياسية عجزت عن تحقيق مطالب الأمة وتطلعاتها في الاستقلال والحرية والإصلاح[14].
والذي لا يختلف عليه اثنان، أن المطالبة بخنق الحريات ورفض الاختلاف السياسي وعدم هضم التنوع الثقافي والأيديولوجي، هو إشارة واضحة إلى عدم القبول بالنظام السياسي البرلماني الديمقراطي؛ نظام التعددية الحزبية وعدم الرضا بالمناخ الليبرالي السائد في المملكة المصرية، بل بلغ الأمر حد المطالبة بحل الأحزاب السياسية. ويكون بذلك حسن البنا، وجماعته، قد أعلن بوضوح عن كراهية غير مبررة للدولة الوطنية الناشئة وقتذاك، وعداءٍ غير مفهوم للفكر السياسي الديمقراطي الليبرالي[15]. لهذا أخذ الفكر الإسلامي عمومًا والسياسي منه خصوصًا، منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهاية الخمسينيات مَسلكَين؛ مَسلك راديكالي – عدائي متوجس خيفة من النظام السياسي الجديد الذي تمثله الدولة الوطنية في مصر وسورية والعراق، وما تحويه هذه الدولة من مبادئ سياسية ليبرالية لم يعهدها العرب والمسلمون منذ أن دخلوا معترك الدولة والسياسة والسلطان في القرون الوسطى، وما تتضمنه هذه المبادئ من فلسفة سياسية أوروبية ومن قيم ثقافية غربية[16].
ومن أهم مبادئ النظام الليبرالي، مبدأ سيادة الأمة ومبدأ المواطنة، كما أخذ الفكر الإسلامي مسلك العداء الشديد للغرب وحضارته وثقافته الذي يصل إلى حد المرض[17] بدعوى أن النظام الاجتماعي/الثقافي التقليدي في الوطن العربي يتعرض يومًا بعد يوم منذ بداية الاختراق الأوروبي، للانحلال والتفسخ والتفكك بسبب سياسات التغريب (Occidentalisation)، أو ما يسمى في أدبيات مفكري الإسلام السياسي «الغزو الثقافي»[18]. والغريب في الأمر أن حسن البنا، وهو يطالب بإلغاء الأحزاب السياسية ويُدين ويشجب الحركة الحزبية/السياسية الوليدة عقب ثورة 1919 الليبرالية التي تمخضت عن حزب الوفد الليبرالي والعلماني، وكذلك دستور 1923 الذي يعدّه البعض، الدستور الأكثر ديمقراطية في تاريخ مصر حتى يوم الناس هذا، كان هو وجماعته ينغمسون شيئًا فشيئًا في الحياة السياسية المصرية ويشاركون في الانتخابات البرلمانية بقوة، ويعقدون الصفقات مع القصر الملكي وحتى مع الاحتلال الإنكليزي، ويتحالفون مع هذا الحزب السياسي ضد ذاك الحزب[19]. ولا يختلف اثنان على أن حسن البنا هو التلميذ غير المباشر للشيخ محمد رشيد رضا، الذي أخذ منه وتأثر به كثيرًا، ومن بين ما أخذ منه فكرة ضرورة عودة دولة الخلافة كونها ركنًا من أركان الدين، أي أنها مسألة عقدية لا مسألة فقهية. لهذا كانت هذه الفكرة في البداية عند حسن البنا وجماعته وكل القوى الإسلامية وقتذاك، مسألة حياة أو موت، وعلى أساس الموقف منها يتحدد الأعداء والأصدقاء[20]. والحقيقة أن حسن البنا لم يؤرقه مشهد سقوط الخلافة ولا كانت تشغله فكرة دولة الخلافة الطوباوية كثيرًا، وإن أبدى في البداية حماسًا شديدًا في الدفاع عنها وفي توجيه سهام النقد لكل من تسول له نفسه التشكيك في قداسة فكرة الخلافة، فما كان يشغله أكثر هو فكرة الدولة الإسلامية. كان لا بد من رفع شعار عودة الخلافة في البداية لاكتساب نوع من الشرعية عند جمهور المسلمين، ثم سرعان ما رفع شعارًا آخر له علاقة بفكرة الخلافة، لكنه أكثر واقعية وممكن تجسيده على أرض الواقع، هو شعار الدولة الإسلامية[21].
وهكذا كانت فكرة الخلافة عند حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين، مجرد مقدمة ضرورية لها مهمتان، الأولى الجهر بمقولة «الدولة الإسلامية» ذات المرجعية الدينية حيث السيادة لله، إضافة إلى أنها فكرة أكثر واقعية وأكثر معقولية، كما أنها مقولة مشحونة بالعاطفة الدينية وهي من ثم الأكثر جذبًا للأنصار والأتباع. والمهمة الثانية هي العمل على القضاء قضاءً مبُرمًا على مقولة الدولة العلمانية الحديثة التي تتجلى في ما يسمى الدولة الوطنية ذات القيم والمبادئ المستمدة من فلسفة القرن الثامن عشر في أوروبا[22]. والحقيقة أن هذه الجماعة الدينية – السياسية التي بدأت بالدعوة الدينية ثم تحولت إلى دعوة سياسية، أقول هذه الجماعة كانت تكبر وتنتشر انتشار النار في الهشيم في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وبرفعها شعار «الدولة الإسلامية» تكون قد تخلت مؤقتًا عن فكرة عودة الخلافة، الفكرة المثالية الطوباوية، وفي الوقت نفسه تكون قد قطعت تمامًا ونهائيًا مع فكر النهضة المعجب بفكرة الدولة الحديثة والمهموم بالمسألة الدستورية، وتكون أيضًا قد أكدت رفضها التام للدولة الوطنية الناشئة[23].
لهذا، فالدعوة إلى الدولة الإسلامية معناها إعادة الارتباط بالتاريخ الإسلامي وإعادة خطوط الوصل مع التجربة السياسية النبوية في المدينة ومع دولة الإسلام المبكر[24]. خلاصة القول، ما يبغي حسن البنا قوله هو أن فكرة «الدولة الإسلامية» هي دولة المسلمين (المؤمنين)، دولة ليست غريبة عن المجتمع، بل إنها دولة تنتمي إلى التاريخ العربي – الإسلامي، هي دولة تنتمي إلى التراث الفقهي السياسي الإسلامي، أما هذه الدولة الوطنية الناشئة، فهي دولة الغرب الأوروبي، هي دولة أنشأها الاستعمار وتنتمي إلى فصيلة الأفكار المستوردة! ولا بد لهذه الدولة الوطنية المُفبركة أن تزول عاجلًا أم أجلًا! وكأن حسن البنا يريد أن يقول «من كان يؤمن بالخلافة فالخلافة قد ماتت ومن كان يؤمن بالدولة الإسلامية، فالدولة الإسلامية حية لا تموت»! وهكذا وكما يشير باحث معاصر، أزاح حسن البنا وجماعته لاهوت الخلافة شيئًا فشيئًا، واستبدل به لاهوتًا مختلفًا بعض الاختلاف، كما أنه أكثف من ناحية الرمزية والقداسة، هو النص الديني المؤسس، هو القرآن، من هنا ليست مصادفة أن يَعدَّ حسن البنا القرآنَ دستورَ المسلمين رافعًا شعار «القرآن دستورنا»، وذلك بقصد إطاحة دستور 1923 العلماني – الليبرالي – الوضعي، الدستور المستورد الذي من مبادئه الأساسية مبدأ سيادة الأمة، بينما دستور الدولة الإسلامية المتخيلة قائم على مبدأ السيادة الإلهية.
خامسًا: تسييس المُقدس… وتقديس المُسيس
ما يلاحَظ على الفكر السياسي الإسلامي المعاصر أن منحنى التطرف والانغلاق والتشدد كان يزداد مع مرور الزمن وتَعاقب الحقب، ومع التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها الوطن العربي، وبخاصة التحولات من طريق الحروب، ونخص بالذكر حقبة ما بين الحربين (1918 – 1939) وحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية (1945 – 1965)، وبالأخص قيام دولة إسرائيل اليهودية عام 1948، إضافة إلى تحولات ما بعد عدوان حزيران/يونيو 1967 وحرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. وسوف يدخل الفكر الإسلامي بـ«فضل» مقولات التكفير والتجهيل والحاكمية وحتمية الحل الإسلامي، في أزمة خانقة لم يخرج منها حتى اليوم[25]. والحقيقة أن كل ما فعله سيد قطب في بيان معالم في الطريق هو شرعنة العنف من أجل إقامة دولة ثيوقراطية، ولهذا لا بد من التوقف عنده، بتحليل مقتضب، بالدراسة والفحص. وما لا شك فيه أن سيد قطب قطع خط الرجعة تمامًا ونهائيًا مع الخطاب السياسي العربي النهضوي، خطاب محمد عبده الإصلاحي وعبد الرحمن الكواكبي الديمقراطي وقاسم أمين التحرري، والغريب في الأمر أن داعية الحاكمية قطع حتى مع خطاب «مرشده» حسن البنا نفسه[26].
ونحن نعلم أن خطاب وخطب ورسائل مؤسس جماعة الإخوان اتسمت بالواقعية والبراغماتية والاعتدال وانتهجت سياسة «خذ وطالب»[27]! لهذا، لا أحد يجادل في اعتدال مؤسس الجماعة السياسي وفي واقعيته، وفي قبوله بالنظام الدستوري وبترحيبه بالعمل السياسي العلني. والأغرب من كل ذلك أن أفكار سيد قطب «الشيخ» وتصوراته ومفاهيمه هي غير أفكار وتصورات ومفاهيم سيد قطب «الشاب»، كما أن ما كتبه في السجن غير ما كتبه وهو حر طليق. ومن المعلوم، أن سيد قطب، وتحت تأثُّر قراءاته في نهاية الأربعينيات بالفكر الإسلامي الباكستاني، ممثلًا بأبي الأعلى المودودي الذي أخذ منه مفهوم الحاكمية، وبأبي الحسن الندوي الذي أمَدّه بمقولة الجاهلية. والجدير بالذكر كذلك أن صاحب مقولات «الحاكمية» و«الجاهلية» دخل السجن عام 1954 مع المئات من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» عَقب محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشية في الإسكندرية في آذار/مارس 1954 محكومًا عليه بخمس عشرة سنة قضى معظمها في المستشفى الملحق بالسجن، وفي السجن كتب ونشر أهم مؤلفاته؛ في ظلال القرآن ومعالم في الطريق. وكتابات السجين هي غير كتابات الحر الطليق، وإن كنا نعتقد أن أهم أفكاره وتصوراته، وبعبارة أصح أيديولوجيته، قد تكونت قبل عام 1952، وظهر ذلك جليًا في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام الصادر عام 1949 وكتاب معركة الإسلام والرأسمالية، وكتاب السلام العالمي والإسلام، وكتاب هذا الدين، والمستقبل لهذا الدين، وكل ما في الأمر أنها ازدادت تصلبًا وتشددًا في السجن. ولا نحتاج إلى شرح كبير للقول بأن مانفيستو معالم في الطريق ليس مجرد نص سياسي – أيديولوجي بل هو شهادة ميلاد الإسلام السياسي. ومن خلال قراءة نص معالم في الطريق نجده يتضمن مفهومين رئيسيين، تنطلق منهما وتستند إليهما الحركات الإحيائية وجماعات التطرف الديني، هما مفهوم الجاهلية الذي أخذه من المفكر الباكستاني أبي الحسن الندوي ومفهوم الحاكمية الذي استقاه من الباكستاني الآخر أبي الأعلى المودودي. والقول بالجاهلية يؤزم الفكر الإسلامي أكثر مع المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ومفهوم الحاكمية يؤدي إلى صدام جماعات الإسلام الحزبي الراديكالي مع الأنظمة السياسية الحاكمة.
سادسًا: الحاكمية… أو الدولة الثيوقراطية!
يُعَدّ سيد قطب أول مفكر إخواني يصرح بـ«أن العالم يعيش اليوم في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها…»[28]. معنى هذه العبارة أن «الجاهلية» التي يعيشها العالم اليوم، أي جاهلية القرن العشرين، تشبه الجاهلية التي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام، وهي سائدة لا في العالم الغربي الرأسمالي فقط، بل في العالم الشرقي/الاشتراكي، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعبارة أخرى، كل المجتمعات المعاصرة هي مجتمعات جاهلية، بما في ذلك المجتمعات التي توصف أو تزعم لنفسها أنها إسلامية[29]، والسبب أنها نسيت أو تناست في الماضي أو تتناسى في الحاضر عبارة التوحيد «لا إله إلا الله» التي فصلت بين الشرك والإيمان، بين الحق والباطل. وزيادةً في توضيح فكرته يقول سيد قطب في نص صريح: «نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم… كل ما حولنا جاهلية…»[30]. فكل هذه المجتمعات القائمة اليوم قد ابتعدت تمامًا من المنهج الإسلامي الصحيح، منهج الرسول والصحابة؛ وقع هذا التباعد في الماضي مباشرة بعد النهاية الدامية للخلافة الراشدة، كما هو واقع اليوم، في القرن العشرين. ولم يجانب أحد المفكرين العرب الصواب عندما أكد فكرة أن سيد قطب تعرض لصدمة عنيفة عندما اكتشف أن الحاضر ليس وحده الذي انحرفت فيه الدولة عن الإسلام، بل إنها انحرفت كذلك في الماضي. واللافت للانتباه أن فكرة الانحراف التاريخية هي التي دفعت سيد قطب إلى تصور نظام سياسي هو غير الخلافة كما كانت في الماضي، فالتاريخ الإسلامي لم يعد صالحًا للقياس عليه ولا للبناء عليه، وبعبارة أدق لم يعد معيارًا[31]. لهذا كان لا بد لسيد قطب من أن يَسرح في الخيال ويتصور نظامًا سياسيًا مثاليًا ويحلم بجمهورية طوباوية وبدولة دينية ونظام حكم ثيوقراطي[32]، لو كان هذا النظام لم يتحقق في الواقع ولا في التاريخ الحقيقي للأمة، ويمكننا أن نضيف أن هذه الدولة التي حلم بها سيد قطب وتلامذته من المستحيل أن تتحقق في الحاضر ولا في المستقبل، لأنها بكل بساطة.. الدولة المستحيلة! وهذه الدولة ومحتواها الأيديولوجي، التي يحلم بها والتي لم تتحقق في الماضي، لأنها كانت مجرد شعار هو «لا حكم إلا لله» رفعه الخوارج منذ واقعة التحكيم بين جش العراق بقيادة علي بن أبي طالب وجيش الشام بزعامة معاوية بن أبي سفيان[33].
ومن الواضح أن سيد قطب عاد إلى الوراء، عاد إلى التاريخ، عاد إلى شعار الخوارج «لا حكم إلا لله». ومعنى هذا الشعار أن الحكم لله وليس للبشر ومن الضروري إقامة مملكة الله في الأرض على أنقاض مملكة البشر، ولا بد من إنتزاع السلطة السياسية من أيدي البشر ومن العباد الذين اغتصبوا الحكم، ولا بد من إرجاع الحق إلى صاحب الحق، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا بد من سيادة الإرادة الإلهية ولا مفر من تطبيق الشريعة الإلهية دون سواها من القوانين، وهذا يترتب عليه حتمًا إلغاء القوانين الوضعية التي سنّها البشر[34]. إنها الحاكمية التي هي من أهم خصائص الألوهية، فالله هو الحاكم الوحيد المطلق وهو وحده لا شريك له، هو رب العباد الذي يشرّع للعباد ويضع مناهج العباد وطرقهم وقواعد حياتهم، وهو كذلك من يحدد لهم المبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية التي يقوم عليها اجتماعهم[35].
وبناءً عليه يمنع على البشر تحديد المبادئ ووضع مناهج الحياة، فلا يحق لأحد من البشر فعل ذلك، ومن فعل فقد تعدى على حدود الله وافترى على الله وزعم لنفسه مهام إلهية. ولهذا فكل من يرفض مبدأ الحاكمية ولا يلتزم بها ولا يخضع لأوامرها ونواهيها، فهو من الروافض ويحسب من المتمردين على أوامر لله ونواهيه[36].
ولا نحتاج إلى شرح كبير للقول بأن سيد قطب من خلال مفهوم الحاكمية يُشرع للدولة الدينية، الدولة الثيوقراطية. دولة الحق الإلهي التي سادت في العصور الوسطى في أوروبا، والتي كانت فيها السيادة لا للأمة وإنما لله! وهذا النظام السياسي الديني/الثيوقراطي الذي دعا إليه سيد قطب، لم يرد أصلًا في الفكر السياسي العربي/الإسلامي الوسيط، وما قال به أحد في السياسة الشرعية ولا الفقه السياسي[37] ولا حتى فقهاء السلطان. ويتعارض تمامًا مع الدولة الوطنية الحديثة، دولة القانون والدستور التي تكون فيها السيادة العليا للشعب وتقوم على مبدأ التمثيل النيابي والفصل بين السلطات والأهم من ذلك تقوم على الفصل بين الدين والدولة. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الحاكمية هي دعوة إلى الدولة الدينية، وهي تؤكد أن السلطة السياسية تكون بيد رجال الدين، ومن ثم تنصيب سلطة الكهنوت، والقول بذلك يجر الدين الإسلامي إلى أتون الصراع السياسي، ويعمّق أزمة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ويجعله يدخل في حرب أهلية مدمرة مع فكر الأزمنة الحديثة ومع تيارات الفكر السياسي العربي المعاصر، أقصد التيارات القومية واليسارية والليبرالية.
ومن البداهة القول إن من مفاهيم الجاهلية والحاكمية التي تضمنها كتيب معالم في الطريق تناسلت الجماعات التكفيرية/الجهادية التي ذهبت بعيدًا ليس فقط في الدولة الوطنية الحديثة فقط، بل إلى حد تكفير وقتل كل من ليس معها بمنطق الفرقة الناجية. وما نخلص إليه أن الفكر السياسي الإسلامي ولد مأزومًا وانتهى مأزومًا، واشتدت أزمته مع التحولات السياسية والاقتصادية. وتكمن أزمته الحادة، في اعتقاده بامتلاك حقيقة الإسلام وحده دون سواه، وبأنه وحده الممثل الشرعي والوحيد للإسلام، كما تظهر أزمته في انغلاقه في وجه الفكر العالمي والعلوم الإنسانية وعدم استفادته من تطور الفكر السياسي الديمقراطي.
كتب ذات صلة:
الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر
الإنتاج الفلسفي في الفكر العربي المعاصر في أطروحات ناصيف نصار
المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 552 في شباط/فبراير 2025.
مصطفى دحماني: أستاذ الفكر العربي الحديث، جامعة بشار – الجزائر.
[1](*) في الأصل محاضرة ألقيت في الملتقى الدولي «أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي» المنعقد في جامعة وهران 2 يومي 22 – 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
جيرارد بورينغ، محرر، مدخل إلى الفكر السياسي الإسلامي، ترجمة عمرو بسيوني (الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع؛ بيروت: دار روافد الثقافية – ناشرون، 2020)، ص 13.
[2] مصطفى دحماني، «الحركات الإسلامية في الجزائر من الدعوة إلى الإرهاب، « دراسات عربية، السنة 33، العددان 9 – 10 (تموز/يوليو – آب/أغسطس 1997)، ص 78.
[3] عبد الإله بلقزيز، الدولة والدين في الاجتماع العربي – الإسلامي، سلسلة السياسة والدين؛ 1 (بيروت: منتدى المعارف، 2015)، ص 201.
[4] محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في المشرق العربي، عالم المعرفة؛ 35 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1980)، ص 7.
[5] Hamit Bosarslan, Histoire de la Turquie contemporaine (Alger: Hibre édition, 2012), p. 22.
[6] رضوان السيد وعبد الإله بلقزيز، أزمة الفكر السياسي العربي، حوارات القرن جديد (دمشق: دار الفكر، 2000)، ص 15.
[7] المصدر نفسه ص 47.
[8] السيد وبلقزيز، المصدر نفسه، ص 69.
[9] المصدر نفسه، ص 69.
[10] مصطفى دحماني، «الخطاب السياسي النهضوي العربي: الإطار التاريخي للانقسام الإيديولوجي،» موقع مركز دراسات الوحدة العربية، 24 أيار/مايو 2019، <https://tinyurl.com/4ehar2mj>.
[11] رضوان السيد، سياسات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العربي، 1997)، ص 165.
[12] المصدر نفسه، ص 209.
[13] نصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، ط 2 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005)، ص 45.
[14] علي أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1985)، ص 161
[15] السيد وبلقزيز، أزمة الفكر السياسي العربي، ص 70.
[16] المصدر نفسه، ص 70.
[17] فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، ط 5 (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014)، ص 387.
[18] السيد، سياسات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات، ص 163.
[19] عماد عبد الغني، حاكمية الله وسلطان الفقيه: قراءة في خطاب الحركات الاسلامية المعاصرة (بيروت: دار الطليعة، 1997)، ص 26 – 27.
[20] عبد الإله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2015)، ص 129.
[21] المصدر نفسه، ص 126.
[22] السيد وبلقزيز، أزمة الفكر السياسي العربي، ص 70.
[23] أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، ص 153.
[24] بلقزيز، الدولة والدين في الاجتماع العربي – الإسلامي، ص 32.
[25] محمد حافظ دياب، سيد قطب.. الخطاب والإيديولوجيا (الجزائر: موفم للنشر والتوزيع، 1991)، ص 101.
[26] السيد وبلقزيز، أزمة الفكر السياسي العربي، ص 72
[27] المصدر نفسه، ص 72.
[28] سيد قطب، معالم في الطريق (بيروت: دار الشروق، 2008)، ص 10.
[29] المصدر نفسه، ص 98.
[30] المصدر نفسه، ص 98.
[31] محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية، ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)، ص 72.
[32] نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ط 2 (القاهرة: سينا للنشر، 1994)، ص 105.
[33] هشام جعيط، الفتنة.. جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، ط 7 (بيروت: دار الطليعة، 2012)، ص 237.
[34] أبو زيد، المصدر نفسه، ص 105.
[35] المصدر نفسه، ص 105.
[36] المصدر نفسه، ص 105.
[37] أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية في الولايات الدينية، ط 3 (بيروت: دار الكتاب العربي، 1999)، ص 29.
مصطفى دحماني
باحث عربي من القطر الجزائري، يشغل حالياً أستاذ ورئيس قسم بجامعة بشار جنوب غرب الجزائر.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.