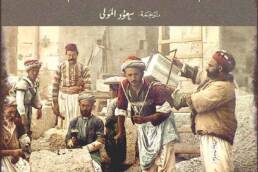بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.