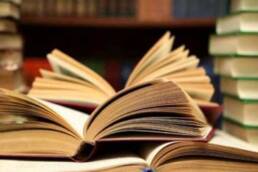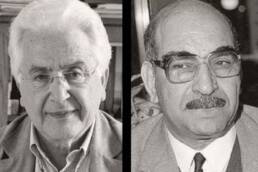أولًا: ترشح الهوية التونسية للتصدع
مرت إحدى عشرة سنة على «ثورة» تونس في الرابع عشر من الشهر الأول لعام 2011. لا يكاد يتحدث اليوم معظم التونسيين والتونسيات إلا عن الآثار السلبية لذلك الحدث، وبخاصة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت جائحة كورونا لتزيد الوضع سوءًا. في هذه الظروف المزعجة، يميل الكثير من هؤلاء إلى الاعتقاد بأن قضية الهوية التونسية قد وقع طيّها ولم تعدْ تمثل إشكالية في المجتمع التونسي. نرى أن مثل ذلك الاعتقاد يشير إلى محاولة هؤلاء لاشعوريًا تحاشي تجميع ثقل كثرة الأزمات، إذ لا تساند المعطيات الموضوعية ذلك الموقف، وبخاصة بين أغلبية النخب التونسية التي قادت مسيرة البلاد بعد الاستقلال. ندرس هنا ظاهرة ما نسميّه تصدّع الهويّة العربيّة الإسلاميّة لدى تلك النخب وفي المجتمع التونسي بعد الاستقلال. ترى مقولتنا أن هناك حضورًا قويًا لبعض معالم التصدع في الهوية التونسية العربية الإسلامية وذلك بسبب وجود خلل في علاقة معظم نخب المجتمع التونسي بعناصر رئيسية لثقافتهم الوطنية، ومنه جاء تأثيرها أفقيًا في كثير من الفئات الاجتماعية التونسية.
1 – مفهومان مبتكران رئيسيان
نستعمل مفهومَين عثر عليهما بحثنا وغوصنا في ظاهرة اللغة، ألا وهما ميثاق اللغة والحجْر اللغوي. يتكون ميثاق اللغة من أربعة بنود لميثاق اللغات: (1) استعمالهم لها وحدها بينهم في الحديث في كل شؤون حياتهم الشخصية والجماعية؛ (2) استعمالهم لها فقط بينهم في الكتابة؛ (3) المعرفة الوافية للغة، المتمثلة بمعرفة معاني مفرداتها والإلمام بقواعدها النحوية والصرفية والإملائية وغيرها؛ (4) تنشأ عن هذه العلاقة السليمة التفاعلية مع اللغة في 1 و2 و3 ما نسميها «العلاقة الحميمة» بتلك اللغة التي تتجلى في المواصفات النفسية والسلوكية التالية: حب للغة والغيرة عليها والدفاع عنها والاعتزاز بها قبل أي لغة أو لغات أخرى يمكن أن يتعلمها الأفراد في مجتمعاتهم.
أما الحجر اللغوي فنعرّفه على أنه اقتصار استعمال الناس ومجتمعاتهم للغاتهم فقط في كل شؤونهم الشخصية والاجتماعية، بما فيها التدريس في المدارس حتى نهاية التعليم الثانوي على الأقل. سيتجلى استعمال هذين المفهومين في أشكال مختلفة في معالم أقسام هذه الدراسة.
2 – الإسلام والعربية قطبا الهوية
نستعمل مفهوم الهويّة العربيّة الإسلاميّة لإلقاء الضوء، لا على حالة الإسلام فقط لدى كثير من النخب التونسية بعد على رحيل المستعمر الفرنسي عام 1956 وإنّما على وضع اللغة العربيّة أيضًا لدى تلك النخب والبلاد التونسية عمومًا. ترى منهجيتنا أنّ اللغة العربيّة والدّين الإسلامي هما قطبا منظومة الهويّة الجماعيّة التونسيّة أو الشخصيّة القاعديّة التونسيّة.
يرى المختصون في العلوم الاجتماعية الحديثة أن عاملَي اللغة والدين هما أكثر العوامل الثقافية المحددة للهوية الثقافية الجماعية للشعوب[1]؛ فالهوية الجماعية للمجتمع التونسي هي هوية عربية إسلاميّة في الصميم، بمعنى أنّ كلًا من اللغة العربية والدين الإسلامي هما العاملان الثقافيان المشتركان لدى الأغلبية السّاحقة من مواطني المجتمع التونسي. تلاحظ هذه الدراسة أن منظومة الهوية العربية الإسلامية لمعظم النخب التونسية أصابها التصدع على مستويي اللغة والدين منذ مجيء الاستعمار الفرنسي.
ثانيًا: معالم تشوّه العلمانية لدى النخب
يسمح هذا التصور للعلاقة السليمة باللغات بالحديث عن تشوّه مفهوم وممارسة العلمانية في المجتمع التونسي وذلك من خلال مؤشريْن رئيسيين ألا وهما ما نسميهما التصدع اللغوي والتصدع الديني كما سنبيّن لاحقًا. تكفي الإشارة هنا إلى بعض الملامح العامة التي تشوّه معنى العلمانية في هذا المجتمع. مقارنة بمفهوم العلمانية ذي البعد الواحد في المجتمعات الغربية (تهميش حضور الدين في الحياة العامة للمجتمع وأفراده)، فإن النخب التونسية تتبنى علمانية ذات بُعدين اثنين. أي أنه في الوقت الذي حصرت النخب الغربية ومجتمعاتها وتحصر تعاملها مع العلمانية في تهميش دور الدين في حياة الأفراد والمجتمعات، تميل النخب التونسية إلى تهميش كل من الدين الإسلامي واللغة العربية من حياة الناس الشخصية والحياة الاجتماعية. وهكذا، يجوز القول إن تقليد تلك النخب للعلمانية الغربية هي عملية مغشوشة وفي أحسن الأحوال منحرفة أو مشوَّهة، إذ إن تلك النخب انحرفت وتنحرف عن المثال الأصلي الغربي للعلمانية الذي يهمش الدين فقط، في حين أضافت تلك النخب عملية التهميش أيضًا إلى لغتها العربية.
1 – جذور وهن الصداقة للعربية والإسلام
تفيد الملاحظات المتكررة أن الكثير من النخب التونسية ضعيفة الصداقة أو فاقدة لها مع اللغة العربية والإسلام. يساعد علم النفس وعلم الاجتماع على معرفة أسباب ظاهرة ضعف أو فقدان تلك الصداقة؛ ففي ما يتعلق تلك العلاقة باللغة العربية فهو يعود أساسًا إلى غياب ما سميناه في ما تقدم بنود الميثاق مع اللغة بين الكثير من النخب التونسية قبل الاستقلال وبعده. فعدم امتثال معظم النخب التونسية وكثير من التونسيات والتونسيين المتعلمين لتلك البنود الأربعة مع لغتهم الوطنية/العربية لا يكسبهم معادلة العلاقة السليمة مع لغتهم العربية = 1+2+3 +4. ومنه، يُفهم ويُفسر ضُعف أو فقدان صداقتهم معها. تسود هذه العلاقة قبل 1956 بين خريجي المدرسة الصادقية (حيث لا تُستعمل اللغة العربية كلغة أولى في التدريس أو التواصل) ناهيك بخريجي مدارس البعثات الفرنسية. فغياب الحجر اللغوي كامل في هذين الصنفين من المدارس التونسية، علمًا أن خريجيهما هم الذين تصدروا قيادة المجتمع التونسي بعد الاستقلال، فأسسوا نظام تعليم تونسيًّا يعيد إنتاج نمط تعليمهم كما يعبر عن ذلك مفهوم Reproduction لعالم الاجتماع الفرنسي بورديو.
أما وهن صداقة خريجي المدرسة الصادقية ومدارس البعثات الفرنسية مع الإسلام، فيعود إلى تواضع أو ضُعف تكوينهم الثقافي الفكري في الثقافة الإسلامية. فكما طغى استعمال اللغة الفرنسية في تدريس التونسيين، طغى أيضًا تدريس الثقافة الفرنسية (التاريخ والجغرافيا والأدب والفلسفة…) في هذين النمطين من التعليم. ثم، توجه الكثير من هؤلاء التلاميذ التونسيين بعد نيلهم شهادة البكالوريا إلى الدراسة الجامعية في فرنسا، حيث للغة والثقافة الفرنسيتين وفكرهما نصيب الأسد في التكوين الثقافي لهؤلاء التونسيين. وهو تكوين لا يكاد يخلو من نقد للتراث الإسلامي الذي لا يستطيع هؤلاء الجامعيون التونسيون الدفاع عنه بسهولة، لأن ثقافتهم الإسلامية التي تلقوها في المدرسة الصادقية وفي مدارس البعثات الفرنسية غير متينة بصفة عامة. ومن ثم، يجوز القول إن علماء الاجتماع والنفس يرون أنه من الصعب انتظار صداقة قوية للإسلام بين النخب السياسية والثقافية التونسية خريجي الجامعات الفرنسية. فتأثير تلك النخب التي قادت مسيرة البلاد في المراحل الأولى من الاستقلال سيكون بارزًا بطريقة شبه حتمية بالنسبة إلى اللغة العربية والإسلام في المجتمع التونسي بعد رحيل المستعمر الفرنسي جسديًا لكن ليس لغويًا وثقافيًا.
2 – مشروعية العامل اللغوي في الحديث عن الدين
قد يتساءل البعض عن مشروعية إثارة قضية اللغة العربية في الحديث عن المسألة الدينية في المجتمع التونسي. وهو تساؤل مقبول لجهة من درسوا، مثلًا، المسيحية في المجتمعات الغربية. فالدين المسيحي هو عقيدة أغلبية تلك المجتمعات التي تتحدث عشرات اللغات المختلفة. أي أن المسيحية انتشرت كدين من دون أن يصاحبها نشر لغة الإنجيل. وهذه هي نقطة الاختلاف الكبيرة التي يتميز بها انتشار الإسلام في ما يسمى اليوم الوطن العربي. فالدين الإسلامي دخل مجتمعات ما بين الخليج والمحيط كعقيدة كتابها الأول هو القرآن الناطق باللغة العربية. فاعتناق الإسلام من طرف معظم سكان الوطن العربي لم يشجعهم على تعلم لغة الضاد فقط وإنما على تبنيها كلغة وطنية للشعوب العربية. ومنه، فالعلاقة وثيقة جدًا بين اللغة العربية والإسلام عند مسلمي الوطن العربي حتى كادت كلمة مسلم في حالة مجتمعات المغرب العربي تساوي كلمة عربي والعكس صحيح (مسلم = عربي، عربي = مسلم). بعبارة أخرى، فقد عُرّب لسان أغلبية سكان المنطقة العربية بعد أن اعتنقت الإسلام. وهكذا نرى أن العلاقة عضوية وقوية بين اللغة العربية والإسلام لدى المسلمين العرب، بحيث إن وضع كل منهما يؤثر في وضع الآخر سلبًا أو إيجابًا.
3 – أثر الفرنسية في العربية والإسلام عند النخب
يرجع تحيّز معظم التونسيّات والتونسييّن بعد الثّورة وقبلها إلى الفرنسية على حساب العربية منذ رحيل الاستعمار الفرنسي إلى أنّ أصحاب القرار السياسي والمثقفين والجامعيين في هذا المجتمع التونسي هم مفرنسو أو مزدوجو اللغة والثقافة، بحيث يغلب على الكثير منهم تفضيل اللغة الفرنسية وثقافتها على اللغة العربية وثقافتها كرمزين رئيسيين للوطنية والهويّة التونسية بحسب الدستور. يشير هذا الواقع التونسي إلى أن الاستعمار اللغوي الثقافي الفرنسي أفسد ويُفسد علاقة هؤلاء باللغة العربية وثقافتها كما رأينا في مفهوم العلمانية المغشوشة. فهم بذلك يختلفون عن بعض النخب القيادية في مجتمعات أخرى معاصرة كسبتْ فعلًا رهان الحداثة، وذلك بجعل لغاتها الوطنية وهوياتها الثقافية في صلب عمليّة التحديث كما هي الحال في اليابان وكوريا الجنوبية والصين ومقاطعة كيباك في كندا وإيران وتركيا وإسرائيل. بينما ينادي كثير من النّخب التونسية بتهميش اللغة العربيّة والثقافة الإسلاميّة العربيّة من عملية التحديث. بعبارة أخرى، يهيمن على أغلبية تلك النّخب الاغترابُ اللغوي الثقافي الذي يضر علاقاتهم بالهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي. لذا، يمكن القول إن التأثير السلبي لتعلم الفرنسية لغة المستعمر في اللغة العربيّة لدى تلك النخب أدى بدوره إلى تأثير سلبي في إسلام هؤلاء نظرًا إلى العلاقة الوطيدة بين اللغة العربية والدين الإسلامي عند المسلمين العرب. ومن ثم، عُرفت وتُعرف معظم النخب التونسية العلمانية/ الحداثية بما فيها اليسارية بأنها غير متحمسة للغة العربية ولا للإسلام.
ثالثًا: التصدع اللغوي في المجتمع التونسي
لتشخيص معالم هذا التصدع اللغوي أنشأنا بعض المفاهيم لقياس هذا التصدّع اللغوي بطريقة مجسمة شبه كميّة في المجتمع التونسي. نقتصر هنا على ذكر مفهومين: «الازدواجية اللغوية الأمارة» و«التعريب النفسي» فالازدواجية اللغوية الأمارة هي تلك التّي تجعل التونسيات والتونسيين قاصرين على الذود عن لغتهم الوطنية (العربية) وغير مبالين إزاء عدم استعمالها في شؤونهم الشخصيّة وفي ما بينهم وفي أسرهم ومؤسساتهم فتصبح عندهم في حالات كثيرة لغة ثانية أو ثالثة[2]. أمّا التّعريب النفسي فهو أن تكون للتونسيات والتونسيّين علاقة حميمة مع اللغة العربية فتكون لها المكانة الأولى في استعمالاتهم فيغارون عليها ويدافعون عنها بحماسة في الدوائر الخاصة والعامة. لكن، تبرز الملاحظات الميدانية للسلوكيّات اللغوية التونسية انتشارًا كبيرًا للازدواجية اللغوية الأمارة وغيابًا كبيرًا للتّعريب النّفسي لدى أغلبية الأجيال التونسية منذ الاستقلال في عام 1956.
1 – الحجر اللغوي وسلامة العلاقة مع اللغة
بفضل جائحة كورونا، اهتدينا إلى مفهوم جديد لا يكاد يخطر على بال الخاصة ناهيك بالعامة. إنه مفهوم الحجر اللغوي: استعمال اللغة الأم أو الوطنية فقط في كل شؤون الحياة، بما فيها التدريس، ابتداءً من حاضنات صغار الأطفال إلى نهاية التعليم الثانوي على الأقل. يساعد غيابُ الحجر اللغوي في المجتمع التونسي على تفسير سلوكيات التونسيات والتونسيين غير السليمة مع اللغة العربية/الوطنية أو الدارجة العربية التونسية النقية من الكلمات الأجنبية. يعود ذلك في المقام الأول إلى فقدان نظام التعليم للحجر اللغوي الكامل، كما تؤكد ذلك عينات ميدانية من المجتمع التونسي نذكر بعضها لاحقًا.
2 – الحجر الصحي واللغوي توأم متجانس
ما يزيد في مدى مصداقية تأثير الحجر اللغوي في سلامة العلاقة بلغة المجتمع هو مفهوم الحجر الصحي الذي تنادي به جائحة كورونا. يتشابه الحجر اللغوي مع الحجر الصحي في تأثيرات كل منهما إيجابًا في المحجور (الصحة أو اللغة). فالإجراءات الصحية الشديدة الصرامة ضد تفشي فيروس الكورونا ومتغيراته المتتالية (التباعد الاجتماعي ولباس الكمامات وغسل اليدين والعزل المنزلي…) تحمي الأفراد كثيرًا من الإصابة بالوباء. وبالمثل، يحمي الحجر اللغوي لغات الأم أو اللغات الوطنية وفروعها من تفشي فيروس انتشار استعمال اللغات الأجنبية في الحديث والكتابة. فالحجر اللغوي يؤدي بطريقة طبيعية إلى إنشاء الناس تلقائيًا وعفويًا لعلاقة سليمة مع لغاتهم تحميهم بقوة من انتشار وباء استعمال الكلمات والجمل باللغات الأجنبية في الحديث والكتابة بينهم وفي مجتمعهم، وهي سلوكيات لغوية تتناقض مع الدستور التونسي الذي يقول إن اللغة العربية هي اللغة الوطنية الوحيدة في المجتمع التونسي.
رابعًا: معالم التصدّع اللغوي لدى القمة والقاعدة
1 – السلوكيات اللغوية في تونس
يكفي هنا ذكر عشرة سلوكيّات لغويّة تونسيّة لدى القمّة والقاعدة تشير كلها إلى غياب ظلال الحجر اللغوي التي تحمي المجتمع التونسي من حرارة شمس الحضور القوي للاستعمار اللغوي الفرنسي:
1 – عُرف في العهد البورقيبي أنّ مَحاضر اجتماعات الوزراء كانت تُكتب في الغالب بالفرنسية. كما يشهد مرافقو الرئيس بورقيبة أنّه كان يستعمل الفرنسيّة عوضًا من العربيّة في لقاءاته مع القادة الأمريكيّين أو الألمان، على سبيل المثال. أي تقع ترجمة كلام الرئيس بورقيبة إلى مخاطَبيه من الفرنسية لا من اللغة العربية/الوطنية إلى الإنكليزية أو الألمانية. وبكل تأكيد لا يقتصر هذا السّلوك اللغوي على بورقيبة فقط، وإنما هذا الأخير هو مجرد رأس جبل الجليد للنّخب السياسيّة والثقافيّة التونسيّة والطّبقات الاجتماعيّة العليا والمتوسطة وبخاصة في المجتمع التونسي المعاصر. يفيد التحليل أن ذلك السلوك اللغوي غير الوطني عند الرئيس وغيره من النخب السياسية والثقافية وغيرهم يعود في المقام الأول إلى فقدانهم إلى التعليم الذي يسود فيه الحجر اللغوي.
2 – خاطب الرئيس المنصف المرزوقي في قصر قرطاج عام 2012 نظيره الإيطالي باللغة الفرنسية بدلًا من اللغة العربية/الوطنية.
3 – لقد صرّح وزير التربية محمود المسعدي في المرحلة البورقيبيّة في مقابلة مع مجلة الحزب الحاكم Dialogue يومئذ في خصوص عدم تعريب التّدريس باللغة العربية في المدارس التونسية قائلًا: يجب تدريس التلاميذ التونسيّين باللغة الفرنسيّة وتعليمهم اللغة العربيّة[3].
4 – تتعامل كتابيًا جل البنوك التونسيّة باللغة الفرنسية حتى يومنا هذا مع زبائنها التّونسيين.
5 – تُعوِّض اليوم كلمة «ماما» كلمة َأمي عند أغلبية الأطفال التونسيّين. ومنه، ينتظر أن تختفي تمامًا كلمة أمي من الاستعمال في المستقبل القريب.
6 – لا يكاد التونسيون يستعملون إلا اللغة الفرنسيّة في الحديث عن أرقام الأشياء. وهذا ما يشهد به، مثلًا، حديثهم عن شبكة المترو بالعاصمة.
7 – نظّمت النساء الديمقراطيات لقاءً في 28/1/2012 في بيت الحكمة (المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون…) ليتحدث فيه بخاصّة بعض النّساء المثقفات في العلوم الإنسانية والاجتماعية عن وضع المرأة في المنطقة العربية الإسلامية. اختارت جميع المتحدثات اللغة الفرنسيّة في القيام بمداخلاتهن رغم أن مكانة المرأة في القرآن والحديث ولدى الفقهاء كانت الموضوع الرئيسي.
8 – لا تكاد التونسيّات تستعملن إلا اللغة الفرنسيّة في الحديث عن ألوان الملابس ومقاييسها.
9 – لا تكتب الأغلبية السّاحقة من التونسيّات والتونسيّين صكوكها المصرفيّة/شيكاتها إلاّ باللغة الفرنسيّة.
10 – لا تكاد تُحصى مفارقات الرئيس قيس سعيد، من بينها أنه يبدو أنه متحمس إلى اللغة العربية لكنه سلوكيًا فشل في إصدار أي مرسوم – ومراسيمه كثيرة – مثلًا، لمصلحة اللغة العربية/الوطنية في كتابة اللافتات في الشوارع والمحلات العامة.
2 – التصدّع اللغوي تونسيّا ومغاربيّا
إنّ ظاهرة التصدّع اللغوي في المجتمع التونسي جزء من وضع اللغة العربية في مجتمعات المغرب العربي. ولوصف الأمر بمؤشرات ميدانيّة نقتصر على ذكر المثال التّالي:
لقد حضرنا ندوة حول نمو المدن المغاربية عبر العصور في 26 – 27/5/2005. أُقيمت هذه النّدوة من طرف المركز الأمريكي بتونس للدراسات المغاربية CEMAT. كانت أغلبية المشاركين من التونسيين والجزائريين والمغاربة. اختار هؤلاء اللغة الفرنسيّة للقيام بمداخلاتهم ما عدا مشاركة مغربية واحدة اختارت اللغة العربيّة لإلقاء ورقتها. لقد أثار ذلك حيرة وصدمة واستهزاءً بين زملائها وزميلاتها توحي بعدم استحسان الأمر بين معظم هؤلاء، وربما اللوم على تجاسر المشاركة المغربية على استعمال اللغة العربية في هذه النّدوة. يشير ذلك إلى مدى استمرار رواسب الاستعمار اللغوي الثقافي الفرنسي بين النخب الثقافية في هذه المجتمعات وذلك بعد عقود من الاستقلال. وهو تصدع لغوي بيّن المعالم لدى تلك النخب المثقفة.
خامسًا: مقياس سلامة وخلل العلاقة باللغات
يجوز القول إن الإطار الفكري اللغوي (البنود الأربعة للعلاقة باللغات المذكورة سابقًا) الذي نطرحه هنا هو نظرية ترتكز على أبجديات بسيطة لإقامة الناس علاقات سليمة بلغاتهم. نعتقد أن منهجية هذه الأبجديات تتضمن معالم جديدة في الطرح تسهل الحكم بشفافية وبساطة على وجود أو فقدان علاقة سليمة للناس والمجتمعات بلغاتهم. تؤكد هذه الأبجديات وتقول إن العلاقات الطبيعية بين الناس ولغاتهم تتمثل بالبنود الأربعة. وبناءً على تلك البنود الأربعة يسهل التعرّف إلى نوعية العلاقة التي يمارسها الناس بلغاتهم. فالذين يلبون بالكامل تلك البنود مع لغاتهم هم قوم يتمتعون بعلاقة سليمة معها. أما الذين لا يلبّونها، فهم صنوف متنوعة بحسب مدى تلبيتهم أي عدد من البنود الأربعة في التعامل مع لغاتهم. تسمح لنا، مثلًا، دراسةُ حال اللغة العربية الفصحى واللهجات العربية في المجتمعات العربية ببيان درجات فقدان العلاقة السليمة في هذه المجتمعات باللغة العربية الفصحى واللهجات العربية. بعبارة أخرى، فكأي رؤية فكرية، يساعد إطارنا الفكري ببنوده الأربعة على تفسير حالات علاقات الناس مع لغاتهم بكثير من الوضوح والدقة. وفي هذا الصدد، لم نعثر على مقاربة مشابهة لمقاربتنا حول محددات علاقات الناس والمجتمعات بلغاتهم لا في بعض المراجع العربية ولا الأجنبية الحديثة.
يساعد منظور علم اجتماع المعرفة على فهم العلاقة الحميمة التي تربط الناس باللغة إن هم استعملوها هي فقط بالكامل شفويًا وكتابة في كل شؤون حياتهم الفردية والجماعية منذ الطفولة وعرفوا مفرداتها وقواعدها النحوية والصرفية وغيرها. يجوز القول بكل بساطة إن تلك العلاقة الحميمة باللغة الأم أو اللغة الوطنية هي نتيجة لعملية الاستعمال المكثف لها (الحجر اللغوي) الذي يُنتظر أن ينشئ مثل تلك العلاقة النفسية القوية التي تخلق علاقة وثيقة ومتينة، أي حميمة باللغة. بعبارة علم الاجتماع، فمثل ذلك التفاعل الشديد الكثافة والتواصل والاستعمال للغة يؤدي إلى ما يسميه هذا العلم بالعلاقة الأولية باللغة. وهي علاقة نَدِّية بالعواطف والشعور والتحمس لمصلحة اللغة. كل ذلك هو حصيلة لتنشئة لغوية اجتماعية منذ الصغر تقتصر على استعمال اللغة الأم أو الوطنية على المستويين الشفوي والكتابي ووفقًا لمفرداتها وقواعدها النحوية والصرفية الصحيحة في كل شؤون الحياة الفردية والجماعية في المجتمعات (ممارسة الحجر اللغوي بالكامل). يمكن صوغ مقولة النظرية اللغوية المطروحة هنا في معادلتين شبه حسابيتين: 1 – الامتثال الكامل للبنود الأربعة = علاقة سليمة باللغة؛ 2 – الامتثال الجزئي أو عدم الامتثال الكامل بالمعالم الأربعة = علاقة غير سليمة كثيرًا أو قليلًا أو ما بينهما باللغة.
سادسًا: مقولة طرحنا الفكري
تقع دراسة موضوعنا هنا في إطار نظري فكري يستند على رؤية العلوم الاجتماعية، من ناحية، وعلى معطيات ميدانية من المجتمعات الغربية والمغاربية، من ناحية أخرى. ترى رؤيتنا النظرية أن طبيعة علاقات الناس باللغات (سليمة أو غير ذلك) تتأثر كثيرًا بمدى ودرجة استعمالهم لها. لا ينطبق هذا لا على اللغات الأم أو اللغات الوطنية فحسب وإنما على اللغات الأجنبية أيضًا؛ فعلاقات الناس الحميمة باللغات الأم أو الوطنية هي نتيجة لما نوّد تسميته قانون الاستعمال المكثف لتلك اللغات ابتداءً من الصغر حتى آخر مرحلة من الكبر. يفسر هذا القانون أيضًا علاقات الناس باللغات الأجنبية حيث تكون هذه الأخيرة، مثلًا، لغات التدريس في معظم أو كل مراحل التعليم للتلاميذ والطلبة الذين لا يستعملون في الغالب أبدًا أو قليلًا لغاتهم الوطنية في التدريس في بعض أو كل تلك المراحل الدراسية، كما هي الحال في معظم الجامعات العربية، وبخاصة في تدريس العلوم. ومنه، فمقولة نظريتنا في هذه المقالة ترى أن طبيعة نوعية علاقات الناس باللغات يحدّدها مدى ودرجة استعمالهم لها. أي أن الاستعمال الكامل للغة ما (الحجر اللغوي) في جميع شؤون الحياة الشخصية والاجتماعية يؤدي إلى كسب الناس رهان علاقة حميمة أي سليمة بتلك اللغة. في المقابل فالاستعمال الجزئي أو المحدود جدًا للغات لا يقود في الغالب إلى علاقة حميمة بها لدى الناس. ومن ثمّ، فطبيعة نوعية العلاقة التي تربط الناس باللغات يقع فهمها وتفسيرها من خلال معطيات معادلة درجة الاستعمال. يفسر جزء من تلك الملاحظات العلاقة غير السليمة بين التونسيات والتونسيين ومؤسسات مجتمعهم ولغتهم العربية.
1 – تشابه ميثاق اللغة مع قانون المطابقة الخلدوني
عُرف عن ابن خلدون أنه أنشأ علمًا جديدًا في القرن الرابع عشر سماه علم العمران البشري الذي تحدث عنه في مقدمته الشهيرة وحلّل أحداث التاريخ وحركة المجتمعات العربية الإسلامية على الخصوص. يمثل ما أطلق عليه صاحبُ المقدمة قانون المطابقة أهم قانون يميّز بين القول العلمي والقول غير العلمي في حديث المؤرخين عن أحداث التاريخ في المجتمعات البشرية. يصف ابن خلدون هذا القانون في العبارات التالية: «وأما الإخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة. فلذلك وجب أن ينظر في إمكانية وقوعه، وصار في ذلك أهم من التعديل ومقدَّمًا عليه، إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة… فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه «وكان ذلك لنا معيارًا صحيحًا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه» وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا»[4].
يمكن النظر إلى ميثاق بنود اللغة ومفهوم الحجر اللغوي المطروحَين في هذه الدراسة على أنهما معياران ذوا مصداقية عالية في الحكم على سلامة أو خلل علاقة الناس بلغاتهم. بحسب علمنا، فهما منظوران جديدان يرسمان بشفافية كبيرة حيثيات علاقات الناس بلغاتهم وغيرها من اللغات. تسمح تلك الشفافية بمعرفة الحق من الباطل، بالتعبير الخلدوني، في ما يتعلق بعلاقات الناس باللغات؛ فوفقًا لبنود الميثاق اللغوي ومفهوم الحجر اللغوي، لا يجوز القول إن للنخب التونسية علاقة سليمة بلغتهم الوطنية ألا وهي اللغة العربية. لقد وصف صاحب المقدمة حول قانون المطابقة بأنه «برهاني لا مدخل للشك فيه». ليس من المبالغة أن يصدق ذلك أيضًا على ميثاق اللغة ببنوده الأربعة ومفهوم الحجر اللغوي.
2 -سلامة العلاقة بالعربية والنهضة
العلمية العربية
ما يزيد في مشروعية مقولة ميثاق اللغة ومفهوم الحجر اللغوي هو دور سلامة العلاقة باللغة العربية في النهضة العلمية في الوطن العربي. يتطلّب ذلك استعمالها في كل الميادين بما فيها العلوم. فمثل هذه السياسة اللغوية لا تخدم تطبيع العلاقة باللغة العربية فقط وإنما تخدم أيضًا نهضة العلم في المجتمعات العربية. تقول آراء ونتائج بحوث الكثيرين إن البلدان العربية تحتاج إلى تعليم العلوم باللغة العربية كي ترسي الأساس الضروري لما يسمى البيئة المنتجة للعلم. أي أن البيئة الاجتماعية المساندة لإنتاج العلم هي تلك التي ينتشر فيها العلم بين عامة الناس ولا يقتصر على النخبة فقط. وبالتعبير السوسيولوجي، يُكتب للعلم بأن يصبح ظاهرة اجتماعية واسعة حين ينسجم مع الثقافة العامة للمجتمع ويتفاعل معها أفقيًا. وهذا يعني أن تعزيز العلم في أي بلد يتوقف كثيرًا على مدى انفتاح الثقافة العامة على العلم. وهذا مستحيل وفق علم الاجتماع، ما لم تكن لغة العلم والثقافة العامة لغة واحدة. أي أن استعمال الإنكليزية أو الفرنسية أو هما معًا في تعليم العلوم في المجتمعات العربية يحرم تلك المجتمعات من انتشار ثقافة علمية لدى سواد شعوبها. فأغلبية التونسيات والتونسيين لا يكادون يصدقون ذلك بسبب فقدانهم العلاقة السليمة بلغتهم الوطنية الذي ينشئ تصورًا خاطئًا للأشياء[5].
سابعًا: الهوية الإسلامية في الميزان
1 – العلاقة بين اللغة العربية والإسلام
تشير أدلة كثيرة من المجتمع التونسي وغيره من المجتمعات المغاربيّة إلى أنّ كثيرًا من المثقفين الفاقدين للتّعريب النّفسي – كما هي الحال أعلاه – نجدهم أيضًا غير متحمّسين للإسلام ناهيك بالدّفاع عنه. وفي مقابل ذلك، فإن النّخب الجزائريّة العروبيّة (المنادية بالتعريب وصاحبة التعريب النفسي) في بداية الاستقلال قامت بسياسات لمصلحة الإسلام، كجعل يوم الجمعة عطلة أسبوعيّة. وفلسفة الدّين الإسلامي لا تتناقض مع النموذج الاشتراكي للتنمية الذي كانت تتبناه القيادة السياسية الجزائرية بقيادة الرئيس هواري بومدين. وهذا ما لم تقم به القيادة السياسية البورقيبة وما بعدها من نخب ثقافية لمصلحة الإسلام، لأن تكوينها اللغوي الثقافي الفرنسي – كما رأينا – لا يشجع على ذلك. وهكذا تتجلى رؤية هذا المقالة التي تؤكد العلاقة العضوية بين اللغة العربية والإسلام في الوطن العربي ذي الأغلبية المسلمة. أي أنّهما قطبا الهويّة العربيّة الإسلاميّة اللذان يؤثّران سلبًا وإيجابًا بعضهما في بعض.
2 – معالم التصدّع الديني في المجتمع التونسي
حاولت فرنسا أيضًا تحقيق ما يمكن على مستوى تصدّع الجانب الدّيني في الهوية التونسيّة. وبسبب التّكوين اللغوي والثقافي الاستعماري للنّخب السياسيّة والثقافيّة التّي حكمت المجتمع التونسي بعد الاستقلال، اتُخذت في البلاد التونسيّة سلسلة من القرارات التي ليست في مصلحة بعض المعالم الرئيسية للعقيدة الإسلامية أو المساندة لها، وقد أذِن بورقيبة بها وأشرف عليها ومارسها شخصيًّا على الملأ بمساعدة رجال ونساء نظامه أصحاب التكوين اللغوي – الذي يمنع نظام تعليم الحجر اللغوي – الحط من مكانة جامع الزيتونة ودعوة الرئيس بورقيبة إلى إفطار رمضان وإلغاء نظام الحبس وإقصاء الزيتونيّين ومن لهم ثقافة عربيّة إسلاميّة مشرقيّة من المشاركة في الحكم على أعلى مستوى هرم السلطة السياسيّة بعد الاستقلال. وقد مُنع الإسلاميّون من النشاط السياسي في عهدَيْ بورقيبة وبن علي وسُجنوا ونُكّل بالذين لم يهربوا من البلاد إلى المنفى. فبورقيبة والنّخب السياسيّة والثقافيّة في عهده لم يكونوا متحمسين كثيرًا للإسلام ولا للّغة العربيّة (القطبين الرئيسيين للهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي). اعتمادًا على مؤشّرات التصدّع اللغوي والديني المذكورة، يمكن القول إنّنا أمام تصدّع فعلي في قطبَيْ هوية النخب التونسية في عهدَي الجمهورية الأولى 1956 – 2011. موضوعيًا، يعود هذا التصدع في المقام الأول إلى الاحتلال الاستعماري الفرنسي الذي نشر لغته ومدارس أفكاره، وبخاصة بين النخب الثقافية والسياسية والعسكرية المديرة لشؤون البلاد التونسية في العصر الحديث. يجوز القول إنها نخب سياسيّة وثقافيّة تونسيّة ضعيفة الصداقة والعمل لمصلحة تمتين عرى هوية الشعب التونسي (اللغة العربية والإسلام) كمَعلمَيْن أساسيَّين ومركزيين لمفهوم الوطنية التونسية السائدة قبل الاستقلال.
ثامنًا: مقولتنا ورؤية العلوم الاجتماعية
تنسجم مقولتنا في هذه الدراسة مع تحليل عالم الإنثربولوجيا الشهير كليفورد غيرتز[6] لمجتمعات العالم الثالث في كتابه المعروف تأويل الثقافات. فهو يرى أن جميع التجمّعات السكانيّة في «الدول الجديدة» تعيش حالة تمزق وتوتّر بين تيارين كبيرين، هما الرّغبة في المحافظة على مكوّنات الهويّة الذاتية من جهة، والرغبة في بناء مجتمع حديث والانخراط الفاعل في المجتمع الدولي، من جهة ثانية. يدعو غيرتز إلى ما يسمّيها «الثورة التكامليّة» التي تجمع بين التيارين، بحيث لا يتحقق أحدهما على حساب الآخر. ويرى غيرتز أن دور المستعمر الغربي كبير في خلق الانقسامات في تلك المجتمعات من طريق نشر ثقافته فيها، وبخاصة بين نخبها كما هي الحال اليوم في تونس.
1 – هويّة المجتمع التونسي قيد التساؤل
ما من شك أن مسألة هويّات الشعوب أصبحت اليوم من معالم خطابات وسياسات عصر العولمة الثقافيّة على الخصوص. ولكنّ قضيّة الانتماء الهوياتي للمجتمع التونسي الحديث طرحت منذ بداية الاستقلال على القيادة السياسية التّونسية الجديدة برئاسة الزعيم الحبيب بورقيبة. وبالطّبع يشير هذا التساؤل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى قضية موقف النّخب السياسيّة والثقافيّة من الهويّة العربيّة الإسلاميّة. فمعروف عن بورقيبة اختلافاته السياسية مع الكثير من القادة العرب، وفي طليعتهم الزعيم جمال عبد الناصر المنادي بقوة لمصلحة الهويّة العربيّة لكلّ الشّعوب العربيّة. وكان لذلك انعكاسات أدت إلى بعض الالتباس بالنّسبة إلى الانتماء الشفّاف وغير المرتبك للهوية العربية الإسلامية للمجتمع التّونسي. تبنى بورقيبة هذا الموقف السياسي بعد الاستقلال بعضُ النّخب الفكريّة التونسيّة (والناس وبعض النّخب أيضًا على دين ملوكهم كما يقال) التّي تدعو إلى مشروعيّة العمل على إبراز الجوانب الفينيقيّة والقرطاجنيّة في الانتماء الهوياتي للشعب التونسي. تتشابه هذه النّخب الفكريّة مع النّخب السياسيّة في كون أنّ كلاًّ منهما لا يرغب في إعطاء الأولويّة للمعالم العربيّة الإسلاميّة في تشكيل الهوية التونسية، ناهيك بتنكّر البعض من هذه النّخب تنكّرًا كاملًا لكل ما هو عربي وإسلامي. ومن ثمّ، انتشر عند الخاصة والعامّة شعار «عُمر الحضارة التونسية يساوي 3000 سنة» ويعني ذلك في المقام الأوّل عند الكثيرين من النّخب أنّ هوية تونس العربية الإسلامية لا ينبغي أن تكون ذات أولوية وفي الصدارة.
2 – العوامل الحاسمة في تحديد الهويّة الجماعيّة
نبين هنا، وباختصار شديد، أن تصور تلك النخب لمحددات الهويات الجماعية للشعوب تصور قاصر وخاطئ موضوعيًّا وعلميًّا. فبعض النخب في تونس، مثلًا، تؤكد أسبقيّة حضور الحضارة الفينيقية والقرطاجنيّة في الأرض التونسيّة قبل مجيء العرب والمسلمين بحضارتهم إلى أفريقية (تونس). وآثار الفينيقيّين والقرطاجنيين لا تزال ماثلة للعيان في أمكنة مختلفة من القطر التّونسي. وهذا أمر لا جدال في صحته تاريخيّا وفي معالم الآثار الباقية.
لكن السؤال المشروع في هذا الصدد هو: ما العوامل المحدّدة والحاسمة أكثر لهويات الشعوب والأمم؛ أهي العوامل الماديّة (الإرث المعماري ونوع الطّعام والشراب واللباس…) أم العوامل الرمزيّة الثقافيّة مثل اللغة والدّين والفكر والأساطير التّي تحملها الحضارات البشرية عبر العصور؟
يتجلّى من التحليل الموضوعي لمسألة الهوية أن ما نسمّيه الرّموز الثقافيّة هي الأكثر حسمًا في تحديد هويّات الأفراد والجماعات والشعوب. والأمثلة الشاهدة على ذلك متعددة. فحركة الهجرة من الجنوب إلى الشمال لا تسحب من المهاجرين هويّاتهم الثقافيّة بمجرد أن يحلّوا جغرافيًّا بالمجتمعات المستقبِلة لهم ذات الخلفيّات اللغوية والدينيّة/الثقافية المختلفة عنهم. ومن ثم، جاء مشكل الاندماج الثقافيّ للمهاجرين في قيم المجتمع المضيف في طليعة مشاكل عولمة الهجرة في الماضي والحاضر وسيكون الأمر كذلك في المستقبل.
تتفوّق عوامل اللغة والدّين والثقافة على العوامل الأخرى في تحديد هويات الأفراد والمجتمعات والشّعوب بسبب ما نطلق عليه مركزّية الرّموز الثقافيّة في هويّة الجنس البشري، نعني بهذا أنّ الجنس البشري يتميّز من غيره من الأجناس الأخرى بطريقة فاصلة وحاسمة بما نصطلح عليه بالرّموز الثقافيّة أو البعد الثالث للإنسان (اللغة المنطوقة والمكتوبة والفكر والمعرفة/العلم والدّين والأساطير والقوانين والقيم والأعراف الثقافية). أي أنّ الإنسان هو في المقام الأوّل كائن رموزيّ ثقافي بالطّبع. وللبرهنة على مصداقيّة هذه المقولة نقدم شرحًا مختصرًا بهذا الصدد.
3 – الهوية الفنيقيّة القرطاجنيّة في ميزان الرّموز الثقافيّة
عند الرجوع إلى فحص مدى مصداقية المنادين في تونس إلى تبني هوية فينيقية أو فينيقية قرطاجنيّة بدلًا من الهوية العربيّة الإسلاميّة، فإنّنا نجد مثل تلك الدعوة ضعيفة الأسس في إطارنا الفكري للرموز الثقافية الذي شرحنا معالمه للتو، إذ مع غياب، مثلًا، لغة/لغات ودين/ديانات القرطاجنيّين والفينيقيّين من الأرض التونسية بعد الفتوحات العربية الإسلامية على الخصوص، اندثرت منظومة الرّموز الثقافيّة القرطاجنيّة والفينيقيّة وعوضتها بطريقة شبه كاملة منظومة الرّموز الثقافيّة العربيّة الإسلاميّة منذ قرون متعددة بحيث أصبحت الشخصية القاعدية (Personnalité de Base) التونسيّة منصهرة تمامًا في بوتقة الرموز الثقافية العربية الإسلامية. تعكس هذا الانصهار الكبير في هذه الثقافة للمجتمع التونسي معالم كبيرة وصغيرة لا تكاد تحصى على مستويات السلوك الفردي والنظام المجتمعي والعقل الجماعي للتونسيّين. وكمثال على مدى تجلي التأثر الكبير للعقل الجماعي التونسي برموز الثقافة العربية ما رُوي في حادثة من الجنوب التونسي التّي تبرز، من ناحية، مدى حضور الثقافة العربية في الحياة اليومية للتونسيين وغياب أو ذبول الثقافة القرطاجنيّة الفينيقية، من ناحية ثانية. يحكي شاب من الجنوب التونسي بأن أمه عندما تغضب عليه وتريد توبيخه تصرخ قائلة: «أيّ متتعنترش (عنترة) عليّ» ولم تقل لي أبدًا «أي متتحنبلش (حنبعل) عليّ». يؤكد المفكر هشام جعيط بالكامل أن هويّة الشّعب التونسي هي هويّة عربيّة إسلاميّة منذ الفتوحات العربيّة الإسلاميّة لأفريقية/تونس: «لا ينبغي خداع النّفس بالنسبة لإمكانية استمرار الحضارة الفينيقية والثقافة اللاتينية والآثار اليونانية على الأرض التونسية. فالإسلام استطاع القضاء نهائيًا على الكل. فإفريقية/تونس القرن الثامن كانت كما هي اليوم: أي بلد مسلم عربي»[7]. وهكذا يتّضح أنّ المناداة بشعار تاريخ 3000 سنة لتونس بعد الاستقلال من طرف النّخب السياسية والثقافية منذ العهد البورقيبي تهدف إلى نكران انتماء الشعب التونسي إلى الهوية العربية الإسلامية كما أكّد ذلك الأستاذ هشام جعيط.
تاسعًا: العوامل الثقافية في خدمة ميلاد هوية جماعية رحبة
نظرًا إلى أهمية العوامل الثقافية في فهم وتفسير حركيّة المجتمعات والأمم وتكوّن هوياتها وفي طليعتها تكوّن الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي، كما جاء في كلمات المفكر هشام جعيط، وفي أقسام متن هذه المقالة، فإنّنا نرى من المناسب اختتام هذا البحث بإلقاء الأضواء على بعض إيجابيات العوامل الثقافية لمصلحة الجنس البشري.
فلو كان الأصل العرقيّ هو العامل الحاسم في تكوين هويّات الشّعوب لما كان ممكنًا تكوين أمم وشعوب تتألّف من خليط من السّلالات والأعراق البشريّة المتنوعة والمختلفة مثل الشعب التونسي أو الأمريكي أو الفرنسي. فرغم اختلاف الفئات المكوّنة لتلك الشّعوب وغيرها في ألوان بشرتها وأنواع وألوان شعرها وقِصر أو طول قاماتها، فإنّ أفرادها يعتبرون أنفسهم بطريقة عفويّة وجماعيّة أنّهم ينتمون إلى شعب واحد هو الشّعب التّونسي أو الأمريكي أو الفرنسي. لقد وجد الباحثون في العلوم الاجتماعية الحديثة أن اشتراك الفئات البشرية في لغة واحدة ودين واحد يؤهلها لكي تظفر بالانتماء إلى هويّة جماعيّة واحدة. فاللغة العربية والدين الإسلامي أو اللغة الإنكليزية والدين المسيحي البروتستانتي أو اللغة الفرنسية والدين المسيحي الكاثوليكي هما العاملان المحددان على التوالي لهوية المجتمع التونسي، فالمجتمع الأمريكي، فالمجتمع الفرنسي. وهكذا، يتجلى أنّ الأرض الصّلبة لبناء الهويّات الجماعيّة للجماعات والمجتمعات والشعوب تكمُن في الرموز الثقافيّة لتلك الشعوب وفي طليعتها رمزا اللغة والدّين. ومن ثم، فمناداة بعض التونسيّين أمس واليوم بالانتماء إلى هوية جماعيّة فينيقيَّة أو قرطاجنيّة فقدت أهم رموزها الثقافية (مثل اللغات والأديان) في المجتمع التونسي هي دعوة أساسها بكل بساطة الجهل بالمحدّدات المشكّلة للهويّات الجماعيّة عند الشعوب، كما أكد ذلك قول هشام جعيط وكما تبرزها بحوث ومفاهيم ونظريات العلوم الاجتماعية الحديثة.
وكما أكدنا سابقًا أن إنسانيّة الجنس البشري تتمثل بانفراده بمنظومة الرّموز الثقافيّة التّي مدته بمزايا كثيرة مكنته من السيادة على بقية الأجناس الأخرى، فإنها هي أيضًا التي تعطيه القدرة على تجاوز الانتماءات المحدودة والضّيقة بين بني البشر التي تفرضها عليهم أصولهم العرقيّة ولون بشرتهم وطول قاماتهم أو قِصرها. إنّ الرّموز الثقافيّة لها نوع من العصا السحريّة في قدرتها على فسْح الآفاق الواسعة أمام الفئات والمجتمعات والشعوب ذات الأصول العرقيّة المختلفة وألوان البشرة المتنوعة لكي تتجاوز حدود الانتماءات الضيقة إلى انتماءات رحبة تكاد تكون بلا حدود. أي أنّ الرّموز الثقافيّة تسمح للناس أن يبلغوا عبرها أوج إنسانيّتهم في التلاحم والتحالف والتآخي مع الآخرين، إذ تمنحهم تأشيرة خضراء لتجاوز حدود ومضايقات الفروق والاختلافات اللونيّة والعرقية التي يمكن أن توجد بينهم في المكان والزمان عبر العصور.
المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 551 في كانون الثاني/يناير 2025.
محمود الذوادي: أستاذ الاجتماع، جامعة تونس.
[1] Peter Kivisto, Multiculturalism in a Global Society (Oxford: Blackwell Publishing, 2002), p. 14.
[2] محمود الذوادي، الازدواجية اللغوية الأمارة: ارتباك الهوية وتصدعها في المغرب والمشرق (تونس: تبر الزمان، 2013).
[3] محمد هشام بوقمرة، القضية اللغوية في تونس، سلسلة الدراسات الأدبية؛ 6 (تونس: الجامعة التونسية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، 1985)، ج 1.
[4] أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، ص 29.
[5] Peter A. Kraus, A Union of Diversity: Language, Identity and Polity-Building in Europe, (New York: Cambridge University Press, 2008), pp. 76-110.
[6] كليفورد غيرتز، تأويل الثقافات، ترجمة محمد بدوي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009).
[7] صوفية بن حتيرة، الجسد والمجتمع: دراسة أنتروبولوجية لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسد (بيروت: الانتشار العربي، 2008).
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.