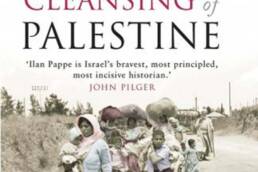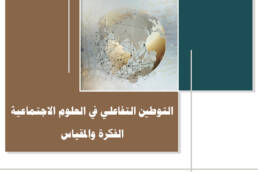المؤلف: أسامة المقدسي
ترجمة: علاء بريك؛ تدقيق: نسمة جويلي
مراجعة: قسم التوثيق والمعلومات في مركز دراسات الوحدة العربية
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
سنة النشر: 2024
عدد الصفحات: 304
يشرح هذا الكتاب – كما يأتي في مقدمته – كيف نشأت أول مرة ثقافة حديثة ومركبة عن العيش المشترك في الشرق الأوسط الحديث، الذي يبدو حاليًا مجرد مجموعة من البلدان والمجتمعات التي مزقتها الحرب. ويسائل بالتحديد سرديتين تقليديتين هيمنتا على التصورات عن الشرق الأوسط، تشدّد أولاها على تاريخ متواصل من الصراع الطائفي بين جماعات دينية وعرقية يُزعم بينها العداء، في حين تقدم الثانية العيش المشترك بوصفه حالة مثالية من الانسجام بين الجماعات الدينية والعرقية.
من هنا، يتناول مؤلف الكتاب السردية الأولى، فيؤكد أن الطائفية مشكلة حقيقية في الشرق الأوسط، والعالم العربي، بالتحديد، لكنها ليست أكثر حقيقية أو استعصاءً على التغيير من مشاكل العنصرية في الغرب والسياسات الطائفية في جنوب آسيا. ويوضح أن هناك فرقًا جوهريًا بين النظر إلى الشرق الأوسط بعيون استشراقية (حسبانه مكانًا غريبًا وشاذًا ومختلفًا بصورة خطيرة) وتأريخه (وضعه في سياق وحوار مع تجارب مماثلة في مناطق أخرى من العالم). وبمجرد أن نفهم هذا، يصبح من الممكن دراسة تاريخ العيش المشترك في الشرق الأوسط من دون الحاجة إلى إبداء مواقف دفاعية، أو اللجوء إلى وصاية غالبًا ما يتم اقحامها في التقارير التي تصدر حول المنطقة.
وبالنسبة إلى السردية الثانية، يرى أنها تتعلق بالاستخدام التقليدي لمصطلح «العيش المشترك» على نحو محدود، إذ غالبًا ما تشير بشيء من الرومانسية أو الحنين إلى السمات المميزة لأزمان طويلة من التاريخ العربي والإسلامي؛ ولا سيما العصر الذهبي للحكم الإسلامي في إسبانيا، في حين يشير الاستخدام المعاصر لمصطلح «التعايش» إلى وجود إطار وطني يضم جميع المواطنين ويقر بالمساواة بينهم بمعزل عن انتمائهم الديني.
وفي هذا السياق ارتبطت فكرة التعايش الحديث في المشرق العربي تحديدًا بالمساواة بين المسلمين وغير المسلمين. وبينما كان يُنظر إليها كضرب من الخيال في بداية القرن التاسع عشر تحولت إلى فكرة عادية بحلول منتصف القرن العشرين، يستحق تأريخها أن يُروى بأمانة، وذلك بهدف استكشاف طبيعة العيش المشترك ومساءلة شروط الإدماج السياسي في الشرق الأوسط الحديث، حيث ظهرت المواطنة العلمانية جنبًا إلى جنب مع قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى الدين، وكذلك بهدف تتبُّع مختلف بنى الإطار المسكوني أو الإطار المُوحد في أواخر الحكم العثماني، وفي لبنان والعراق بعد الحكم العثماني، وأخيرًا خلال الانتداب البريطاني على فلسطين التي أخضعت للصهيونية الاستعمارية.
يحيل المؤلف عند استخدامه مفهوم الإطار المسكوني على ثلاثة أمور: (1) مجموعة أفكار سعت إلى التوفيق بين مبدأ جديد من المساواة السياسية العلمانية وواقع نظام عثماني فضّل، على مدار تاريخه، المسلم على غيره، لكنه حاول دمج غير المسلمين كمواطنين؛ (2) نظام حكم طالما استبقى آثار السيادة الإسلامية وعلاماتها رغم تأكيده المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الانتماء الديني؛ (3) نظام سياسي وقانوني جديد شدًد دومًا على العلمانية الدستورية للمواطنين، وفي الوقت نفسه، على ضرورة وجود قوانين خاصة بكل دين تحكم الزواج والطلاق والميراث، والتي كان من شأنها أن تنفي على أرض الواقع العلمانية والمساواة بين المواطنين.
يعرض الكتاب للتسلسل الزمني للعيش المشترك في قسمين، يتناول الأول الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر حين صيغ الإطار المسكوني أول مرة، ويركز الثاني على المشرق العربي في القرن العشرين بعد المرحلة العثمانية، وإبان مرحلة الاستعمار الغربي.
يقدم القسم الأول صورة عن العيش المشترك في المرحلة العثمانية قبل القرن التاسع عشر، حين ساد منطق الحكم العثماني الإسلامي المنتصر، ويبين كيف تلاشى هذا المنطق بعد أن تراجع التفوق العثماني وشهدت المنطقة ثورات قومية وضغوط غربية لإلزام الإمبراطورية العثمانية بإجراء إصلاحات كبرى وحماية غير المسلمين، وذلك وصولًا إلى انقسام الإمبراطورية العثمانية بين شمالها البلقاني والأناضولي اللذين عصفت بهما مسائل القومية والتطير العرقي، وبين المشرق الناطق بالعربية الذي لم يشهد مثل هذه النزعة القومية.
أما القسم الثاني من الكتاب، فيعرض لمرحلة ما بعد العثمانيين، متناولًا مرحلة الانتداب الفرنسي والبريطاني في العراق وسورية والأردن ولبنان، حيث بُنيت هذه الدول على الإرث المسكوني العثماني المشترك، وقبلت إلى حد كبير بمحرماته رغم مصارعتها لتناقضاته، في ظل الانتداب الاستعماري. كما يقارن هذا القسم بين الدولة الطائفية في لبنان تحت الحماية الفرنسية والدولة القومية في العراق المرتبطة بالإمبراطورية البريطانية. ويركز على كيفية سعي شخصيتين رئيستين – ميشال شيحا في لبنان وساطع الحصري في العراق – إلى تحويل تصورات محددة عن العيش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين إلى أيديولوجيات متخالفة من الجماعاتية والقومية العلمانية.
ويظهر كيف تبنت كل من مصر وسورية ولبنان والعراق مفهومًا علمانيًا عن المواطنة لا يميّز دستوريًا بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات، مع محافظة تلك الأنظمة على قوانين أحوالها الشخصية منفصلة لكل دين في الوقت نفسه. وقد ميّزت هذه الازدواجية الإطار المسكوني الحديث في المشرق العربي، ومثلها محاولات صبغ الدين بطابع قومي ليكون دعامة للعيش المشترك والوحدة الوطنية. ويختم هذا القسم بتناول الصهيونية الاستعمارية المدعومة من بريطانيا التي قدمت إلى فلسطين بهدف تحويل أرضها المتعددة الأديان إلى دولة يهودية قومية يحكمها المستعمرون الأشكيناز الأوروبيون.
يمكنكم الحصول على الكتاب الكترونياً أو ورقياً عبر الضغط على الرابط:
المصادر:
نُشرت هذه المراجعة في مجلة المستقبل العربي العدد 552 الخاص بشهر شباط/فبراير 2025.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.