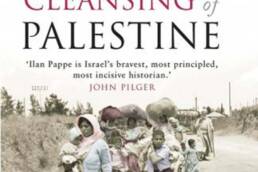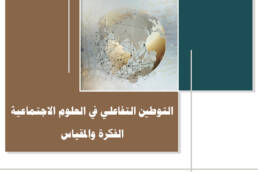المؤلف: بشرى زكاغ
مراجعة: ياسين حكان
الناشر: الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
سنة النشر: 2023
عدد الصفحات: 416
مقدمة
تواصل الباحثة المغربية بشرى زكاغ[1] بعد أطروحتها الأولى الأنترنت وصناعة الثقافة المغربية رقميًا: دراسة في سوسيولوجيا التواصل الرقمي[2]، دراساتها حول الإنترنت وعلم اجتماع الرقمي، وتتوقف هذه المرة عند الشبكات الرقمية في كتابها الشبكات الرقمية ودينامية الحقل الاجتماعي/السياسي بالمغرب. وقد قسمت المؤلفة كتابها من حيث الشكل إلى مقدمة عامة، وسبعة فصول، وخاتمة.
ينتمي كتاب الشبكات الرقمية إلى عينة من الكتب الأكاديمية والإصدارات العلمية التي يلمس فيها القارئ جهدًا بحثيًا وتمكنًا معرفيًا ومنهجًا مبتكرًا في دراسة الشبكات الرقمية. وهو يمثل امتدادًا لمشروعها العلمي، وتجديدًا في الأسئلة والمقاربات حول موضوع ما زال يعتمل في البحث السوسيولوجي، ويمثل تحديًا بالنسبة إلى علم الاجتماع، وخصوصًا أن الانتقال من الفضاء الفيزيائي إلى الفضاء الشبكي، هو انتقال من فضاء التفاعل بين الزمان والمكان والممارسات الاجتماعية، إلى فضاء تتدفق فيه تفاعلات وتبادلات مرقمنة ومرمزة. ويعُجُّ بالكثير من التدفقات والتشابكات، ولا سيما أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد وسيلة للتواصل فحسب، بل أصبحت تمثل واقعنا الفيزيائي والافتراضي، وتؤثر في خياراتنا وتوجهاتنا وتفاعلاتنا الاجتماعية داخل الفضاء الشبكي (ص 17).
يقدم الكتاب مقاربة نقدية جديدة، أو بالأحرى إطارًا مفاهيميًا ونظريًا جديدًا لفهم الشبكات الرقمية، وما يعتمل فيها، عبر اتخاذ مسار تحليل، يأخذ في حساباته ما يطرح من معطيات ومستجدات في الفضاء الرقمي، وبحق يمثل مساهمة جادة في فهم دينامية مجتمع الشبكات المغربي، وفهم أساليب فعل جيل الشبكيين، ورد فعلهم تجاه قضايا الشأن العام، وما يصدر عن المؤسسات والسياسيين من خطابات وقرارات.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة تداخلًا حاصلًا بين الفضاء الواقعي والافتراضي، حيث يبحث في إشكالية الحدود بين الفضاءين، ويركز على استكشاف محتوى التقصي السوسيولوجي الخاص بدراسة الظاهرة الاجتماعية الشبكية، والعمل على إبراز المواقع الميدانية الناشئة، وما ولّدته من ديناميات داخل الحقل السياسي والاجتماعي، إذ سمحت هذه الفضاءات لجيل الشبكيين، بانتزاع مساحات من الحرية والاستقلالية في هذا الفضاء الذي يوصف بأنه هجين.
ينتمي موضوع الشبكات الرقمية – موضوع الكتاب – إلى الموضوعات المستجدة التي على الباحث في علم الاجتماع أن يعمل على دراستها وفهمها، بغية تفسير الديناميات التي خلفتها في الحقل الاجتماعي والسياسي، ولا سيما أنه يجب استحضار في مستوى أول أن هذه الوسائط جاءت على حساب وسائل الإعلام التقليدية، وفي مستوى ثان هي نتيجة للثورة الرقمية، التي أفرزت هذه الأنماط الجديدة في التعبير، وفتحت إمكانات للتفاعل والنقاش عبر تكنولوجيا المعلومات. وقد سعت الباحثة في هذا العمل إلى دراسة مجتمع الشبكات في المغرب، ومساءلته سوسيولوجيًا وأنثروبولوجيًا عبر تعميق الأسئلة والإشكالات، حيث يدخل هذا العمل ضمن ما يعرف بـ «التحقيقات الاجتماعية»، إذ هو تخصص بحثي جديد ومركب، يجمع بين نظم الحاسوب والشبكات الرقمية من جهة، والبحث الاجتماعي من جهة أخرى (ص 24).
كيف تتفاعل الشبكات الرقمية التي يهيمن عليها الشباب مع دينامية التغير الاجتماعي/السياسي في المغرب (ص 20)؟
حاولت المؤلفة الإجابة عن السؤال الإشكالي التالي: من خلال الانطلاق من ملاحظات ميدانية عبر الفضاءات الحضرية والفضاءات الشبكية منذ سنة 2011، وفي المدة ما بين سنتي 2016 و2019، وقد اعتمدت على المنهج الكيفي والكمي في دراسة الظاهرة، من خلال اعتماد الملاحظة والملاحظة بالمشاركة، ومحاورة الفاعلين، وإجراء مقابلات موقعية معهم متصلة ومحددة في الزمان والمكان، وأخرى افتراضية وشبكية (ص 24) في مستوى أول. كما أجرت المؤلفة في مستوى ثانٍ بحثًا مع عينة من 410 نساء من جهة الشرق بالمغرب، ومن فئات عمرية متباينة، ومستويات تعليمية وأوضاع اقتصادية مختلفة، وذلك باعتماد أسلوب الاستمارة، والمقابلة لجمع المعطيات الميدانية (ص 25).
أهمية الكتاب: تكمن أهمية الكتاب في موضوعه من حيث تناوله للظاهرة الشبكية، من خلال إخضاعها للمنهج السوسيولوجي، على أساس أنها ظاهرة اجتماعية، تتمثل جدتها بانفتاحها على تخصص بحثي ناشئ في المغرب والوطن العربي، نقصد بذلك علم الاجتماع الرقمي (ص 21). وتبرز راهنيته بتناوله ما يروج في الواقع المغربي من دينامية وتوتر مسّت الاجتماعي والسياسي معًا، وذلك بفعل زيادة التشابك والتقارب بين الأفراد والهويات وإلغاء وساطة المؤسسات والهياكل التقليدية (ص 22).
ولا شك في أن منهجية الكتاب، من حيث سعيه للدمج بين تقنيات وأدوات الدراسة الاستقصائية في الواقع الفيزيائي والدراسة الاستقصائية في الفضاء الشبكي الرقمي (ص 22)، منحه أهمية أكبر ومرونة في سعيه لبحث واستقصاء واقع اجتماعي سائل ومتشابك أو هجين بمعنى من المعاني.
ولعل ما يميز الكتاب من غيره من الدراسات والبحوث، أنه تمكن من اقتراح مفاهيم ممكنة لوصف مجتمع الشبكات وتتبعه ميكروسوسيولوجيا وماكروسوسيولوجيا من قبيل: الفرد الشبكي، والجيل الشبكي، والهوية الشبكية، والفضاء العمومي الشبكي… إلخ.
والمؤكد أن مسألة الظاهرة الشبكية تستدعي استكشاف محتوى التقصي السوسيولوجي والإثنوغرافي الخاص بدراسة الظاهرة الاجتماعية الشبكية، عبر تحديد الاتجاه العام الذي يسير فيه هذا المجال الجديد، من خلال تقديم المواقع الميدانية الناشئة ومجالات الممارسة.
فضلًا عن ما سبق، تعود أهمية هذا الكتاب في أحد جوانبها، إلى الرهانات التي ينطوي عليها توسيع آفاق البحث والاستقصاء الاجتماعي والإثنوغرافي، في ما يخص تفسير دينامية الفضاءات الهجينة التي تبنّيها تكنولوجيا الشبكات، وما ينتج منها من تفاعلات وتداخلات، عبر اقتراح نماذج تفسيرية مستوحاة من تخصصات بحثية مختلفة (اللسانيات، وفيزياء المادة، وعلم الاجتماع).
وبحسب المؤلفة، فإن طريقتنا في النظر إلى الظاهرة الشبكية الاجتماعية وتعقّدها، تستلزم الإمساك بالرهان المشترك بين دراسة الحقل الشبابي في المغرب وتحليل ديناميته وتوتراته، والمتغير التكنولوجي الرقمي. ومن ثم، فهي تسعى إلى تمحيص مدى دقة وصدقية القول بأن الدينامية الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب منذ 2011، تعود بصورة أو بأخرى إلى زيادة حضور جيل الشبكيين في العوالم الافتراضية والشبكية (ص 22).
إشكالية الكتاب وأسئلته الرئيسة: تصوغ المؤلفة الأسئلة التي واجهتها في رحلة استكشافها للظاهرة الشبكية في المغرب والوطن العربي، كما يأتي:
– ما هي أشكال التقصي السوسيولوجي الجديدة، التي يمكن اعتمادها لتحقيق مجتمع الشبكات ودراسته؟ وكيف نشأ هذا الميدان البحثي؟ وكيف تعددت مداخله ومفهوماته؟
– هل يمكِّننا التقصي الإثنوغرافي الشبكي (متعدد المواقع) من التقاط صورة عامة عن مجتمع الشبكات الرقمية في صيغته المغربية، وخصوصًا ما تعلق منه بإشكالية الفضاء العمومي، وتجربة الزمن الميدياتيكي وسيبرنيطيقا التواصل؟
– كيف تتكون الهوية في سياق مجتمع الشبكات الرقمية؟ وهل هي هوية طبيعية مستقرة أم أنها دينامية وشبكية ومفتوحة على تعدد الخيارات؟ هل هي فردية مخصوصة؟ أم أنها جمعية وقبائلية؟
– ما الفاعلية الاجتماعية التي يقودها جيل الشبكيين منذ عام 2011؟ وهل لذلك علاقة بأشكال الحضور في الفضاء الشبكي؟
– هل مست أشكال الحضور هذه الفعلَ الاجتماعيَ فقط، أم أنها تعدّته إلى مستوى البنية والأطر التقليدية، دافعة إياها إلى إعادة تنظيم وجودها هي أيضًا في الفضاء الشبكي؟
– كيف تمكَّن جيل الشبكيين من الانتقال من تقاسم نزعاتهم الاجتماعية، إلى تقاسم غضبهم وآمالهم ونضالاتهم، مؤثرين في الرأي العام الوطني، فاعلين ومتدخلين في بنائه وتوجيهه؟
– لماذا أصبح جيل الشبكيين يدرك أنه «قادر» بالفعل على صنع التغيير، والتأثير في الرأي العام وفي الحياة السياسية؟
– في ما وراء دينامية الاجتماعي/السياسي، كيف يحضر جيل الشبكيين دينيًا وتضامنيًا في قلب الفضاء الشبكي؟ وهل يسمح هذا الفضاء للجميع بالحضور فيه؟ أم أنه منطوٍ على أشكال من الاستبعاد والتفاوت الاجتماعي؟
وتوضح المؤلفة في البداية أنه يتوجب علينا أن نكون حذرين من المغالاة في الحديث عن الآثار الاجتماعية لفضاء الشبكات، عندما يتعلق الأمر بمجتمعات لم تشارك في مغامرة الحداثة وصناعة الزمن الحديث كمجتمعنا، غير أن ذلك لم يمنع من وقوع الأزمنة الحديثة عليها (ص 20).
يعكس تعامل المؤلفة مع المراجع والمعطيات والبيانات التي اعتمدتها في معالجة أسئلتها الرئيسة وضوح رؤيتها وقدرتها على استثمار ما توافر من معطيات، رغم ما تظهره من تواضع، فهي تعترف بأنها ستحاول الإجابة عن هذه الأسئلة، في حدود الإمكانيات التي تتيحها المعطيات التي تمكنت من الاطلاع عليها.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة الظاهرة الشبكية بالنسبة إلى المؤلفة، لم تكن ميسّرة وخالية من الصعوبات، التي ارتبط «بعضها بطبيعة الموضوع وتعدد مقارباته، وبعضها الآخر مرتبط بتقنياته ومنهجيته» (ص 28).
وتشير المؤلفة إلى أن السرعة والآنية اللتين يتميز بهما موضوع الدراسة، جعلتا أحداث ومعطيات طيارة ومتبدلة بسرعة فائقة وباستمرار (ص 28)، دفعتها إلى إعادة مراجعة تحقيقاته واستقصاءاته الميدانية والإحصائية.
إضافة إلى أن الصعوبة الكبرى التي واجهتها في الميدان، هي الوصول إلى المبحوثين في أشكال الحراك والنضال موضوع الدراسة، وإحجام كثير منهم عن إجراء المقابلات عبر الشبكات والحديث عن الموضوع، بسبب حالات الحصار والرقابة الرقمية التي يخضعون لها، وكذا قرصنة عدد من الصفحات موضوع البحث والاستقصاء وضياع محتواها، أو دس محتويات غريبة أو مبتذلة فيه (ص 28).
أولًا: أطروحة الكتاب وأفكاره الرئيسية
يتعلق موضوع الكتاب بمجتمع الشبكات الرقمية بالمغرب وتحقيقه، ويدخل هذا النوع من الدراسة ضمن التحقيقات، وتحديدًا ضمن الدراسات الشبكية الرقمية، من حيث هي تخصص بحثي مركّب يجمع بين نظم الحاسوب والشبكات الرقمية من جهة، والبحث الاجتماعي بصفة عامة والسوسيولوجي بصفة خاصة من جهة ثانية.
كما يرصد الكتاب تكوّن الهويات الرقمية، وانتقالها من هويات فردية إلى هويات شبكية جمعية، وتأثير الدين والحركات الاحتجاجية في جيل الشبكيين. وفي السياق نفسه، حيث مع ظهور الإنترنت وثورة الأنفوميديا بحسب تعبير ألفين توفلر[3]، تحاول الباحثة تبيان التضامنات الناشئة في مواقع التواصل الاجتماعي والتشبيك الحاصل فيها، ولا سيما أن هذه المواقع توصف بأنها هجينة. بالموازاة مع سعي الكاتبة إلى فهم أساليب فعل وردات فعل جيل الشبكيين تجاه مختلف قضايا الرأي في المغرب والعالم العربي.
انطلاقًا من هذا الاهتمام البحثي، تقترح المؤلفة مجموعة من الفرضيات كوضعٍ للانطلاق، نجملها في ما يأتي:
– يتسم الحقل الشبابي بالمغرب بهجرة جماعية نحو وطن الشبكات الرقمية والنشاط السياسي السيبراني (Cyberactivisme).
– وجود القدر من التهميش والفقر والتشبيك عبر العقد الاتصالية، يمكن أن يوفر «الفرصة الاستطرادية» لدفع أشكال الاحتجاج والنضال الشبكي نحو الشوارع والميادين الموقعية.
– الحضور الديني والاجتماعي لجيل الشبكيين الشباب، هو نوع من البحث عن أطر وفضاءات أكثر قدرة على استيعاب نشاطية الشباب وفاعليتهم.
– نفاذ النساء إلى فضاء الشبكات واستخدامها أقل مما عليه الحال بالنسبة إلى الرجال.
– فضاء الاستقلالية أو ما يمكن نسميه الـ «بين – بين» الواقعي والافتراضي، ما زال واقعًا ضمن منطقة رمادية ودينامية غير قابلة للتشكل أو التحديد النهائي.
ثانيًا: فصول الكتاب
يتناول الفصل الأول، المحددات النظرية والمفاهيمية حول مجتمع الشبكات الرقمية، حيث ركزت الباحثة على المفاهيم الأساسية للدراسة من قبيل: إثنوغرافيا الإنترنت، والإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلوميات، والتواصل والاتصال، ومجتمع الشبكات والواقع الافتراضي وشبكات وفضاء التدفقات وفضاء الشبكات الرقمية وجيل الشبكيين ومجتمع الشبكيين، حيث عملت الباحثة في هذا الصدد. على تبيان الفروق بين المفاهيم وإبراز الحدود بينها، مشيرة إلى أن البحث في هذا الموضوع يحفل بالكثير من الغموض، والسرعة والآنية في تبدل هذه الوسائط، ونشوء مصطلحات جديدة (ص 29 – 35).
ثم تطرقت الباحثة إلى الدراسات السوسيولوجية الأولى حول مجتمع المعلومات، وعدّته امتدادًا لنظريات ما بعد الصناعة وتعديلًا لها في الوقت نفسه، كما ركزت على أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تسهم في دفع حركية الإنسانية إلى الأمام إذا تم استثمرها بطريقة ذكية (ص 35 – 37). ثم أشارت إلى الدراسات السابقة حول الموضوع (ص 39 – 48).
حاولت الكاتبة في الفصل الثاني أن تسلط الضوء على سياق بروز فرع جديد في علم الاجتماع، يدعى علم الاجتماع الرقمي، من خلال فحص آليات نشوء هذا الميدان البحثي، ومختلف التسميات التي رافقت توجهاته البحثية، منتقلين في ذلك من تطور مراحل النظرية السوسيولوجية حول أشكال التفاعل الاجتماعي المتوسط من مجتمع التواصل المباشر إلى مجتمع الاتصال ثم إلى مجتمع الشبكات (ص 50 – 66).
كما أبرزت آفاق النظرية العلمية في علم الاجتماع الرقمي، مشيرة إلى التقنيات الجديدة، من قبيل الاستبيان الرقمي، والمقابلة على الخط، والأدوات الإحصائية، كآليات جديدة أضحى يستعملها الباحث لتحليل الظواهر التي لها صلة مباشرة بالشبكات الرقمية (ص 77 – 81).
حاولت الباحثة من خلال هذا الفصل المعنون بـ: «مجتمع الشبكات الرقمية بالمغرب من الإثنوغرافية إلى النتنوغرافيا»، الإجابة عن سؤال مركزي حول ماهية المجتمع الشبكي الذي تحاول بحثه وتحليله باعتماد الرصد والملاحظة، ومن خلال المعايشة والحضور في مجتمع الشبكات، محاولين في ذلك فهم الثقافة الشبكية، وكيفية تفاعلها مع المنطق الشبكي (ص 85 – 89).
كما ترى الكاتبة أن هذه المتغيرات الناتجة من الممارسات الشبكية وتفاعل الشبكيين تم من خلالها الانتقال من فضاءات وأمكنة موضعية اعتادها المغاربة، إلى فضاء يتأسس على اللاخطية والانعكاسية والتفاعلية المفرطة، مع المواد التي تصدر فيها عكس وسائل الإعلام التقليدية (ص 112 – 113).
يرسم الفصل الرابع «إثنوغرافيا تشكل الهوية في مجتمع الشبكات الرقمية»، من خلال الإجابة عن مجموعة من أسئلة، منها: من أين يستمد الأفراد هويتهم؟ هل مصدر الهوية الرقمية شخصي أو علائقي؟ وما أهم العوامل المساهمة في تشكيل الهوية في سياق مجتمع الشبكات الرقمية؟ هل هي هوية طبيعية مستقرة أم أنها دينامية وشبكية ومفتوحة على تعدد الاختيارات؟ وهل هي هوية فردية مخصوصة أم أنها جمعية شبكية؟ (ص 117).
وخلصت الباحثة إلى أن هذا التعدد وطابع السيولة الذي رافق تمظهرات الهوية الافتراضية، قد أفرزت هوية شبكية مائعة وذات دينامية متقلبة، إذ أصبحت الانتماءات انتماءً، وتفكك المرجعيات الثقافية الكبرى وانتفاء مركبي المكان والزمان كمعطيين محددين للهوية (ص 153 – 156).
يتناول الفصل الخامس الأشكال الجديدة للمشاركة السياسية عبر فضاء الشبكات الرقمية، إذ يتدخل الشباب كفاعلين شبكيين موجودين في صلب دينامية الحقل الاجتماعي/السياسي، وما يظهر فيه من تحولات وتغيرات شملت السياسي والاحتجاجي والشبكي أيضًا (ص 117 – 119).
كما تؤكد الباحثة في هذا الصدد، أنه أصبح للشباب دور كبير في الشبكات الرقمية، إذ بحسب الدراسة الاستقصائية التي قامت بها مؤسسة «راند» الأمريكية للدراسات الاستخبارية حول جيل الألفية في أمريكا والعالم أن «أفراد جيل الألفية» كان لهم دور «في تشكيل مناطقهم ومجتمعاتهم حيثما يقيمون، وكان أفراد الألفية من بين المشاركين في حركات الربيع العربي التي انتشرت عبر الشرق الأوسط في العام 2010»[4].
ومن اللافت للانتباه أن حضور الشباب العربي في الفضاء الشبكي يضاهي أقرانه في العالم، حيث «قفز استخدام الهواتف الجوالة من مستوى 26 في المائة عام 2005 إلى نحو 108 في المائة عام 2015، وهو أعلى من المعدل العالمي. وبالمثل قفز استخدام الإنترنت من 8 في المائة عام 2005 إلى 37 في المائة عام 2015، وهي نسبة أعلى من بقية العالم النامي والمعدل العالمي»[5].
بناءً على ما تقدم، توصلت الباحثة في نهاية هذا الفصل إلى أن قوة الفاعلين الشبكيين تمثلت بصيغ التعبئة والحشد والتنظيم والاحتجاجات، التي تم إبداعها خارج الأطر التقليدية. وأن الديناميات التي تولدت عن استخدام الشباب أو المؤثرين لهذه المنصات الرقمية، لم تكن حكرًا على الفاعل الاجتماعي فقط، بل شملت التنظيمات السياسية مثل الوزارات والمؤسسات والأحزاب، والتي رأت في الفضاء الشبكي قدرة على تمديد وجودها وزيادة حضورها عبر هذه الشبكات.
وأشارت إلى أن هذه الفضاءات الشبكية قد أسهمت في إرساء حياة سياسية أكثر مشاركة والتزامًا واستجابة، ولا سيما البودكاست السياسي كنموذج للديمقراطية التشاركية التي يبنيها الصحافيون خاصة، والمواطنون عامة عبر فضاء الشبكات الرقمية.
يبحث الفصل السادس في إشكالية تشابك الواقع بالافتراضي، ومسارات التأثير في الرأي العام في فضاء الشبكات الرقمية، بالانطلاق من مجموعة من الأسئلة: كيف يتشابك الواقعي بالافتراضي منتجًا دينامية شبكية وريزومية؟ كيف تمكن جيل الشبكيين من تقاسم نزعاتهم الفردية إلى تقاسم غضبهم ونضالهم مؤثرين في الرأي العام الوطني متدخلين في بنائه وتوجيهه؟ ولماذا أصبح جيل الشبكيين عبر حراك «مقاطعون» قادرًا على صنع التغيير والتأثير في الحياة السياسية؟ وما الرسائل الرمزية القوية التي بعثها حراك «مقاطعون» في صوره الثلاث[6]؟ وخلصت الباحثة إلى أن الحديث عن التشابك الحاصل بين الواقعي والافتراضي يعبر عن العلاقة بين الدال والمدلول، وعن تفاعلات اجتماعية شبكية قريبة من تفاعلات حالة البلازما مفرطة في السيولة والتأين، وحياة جمعياتية وقوى ضاغطة، ومواطنة شبكية ورأي عام شبكي، وحركات اجتماعية شبكية. كما تطرقت إلى الديناميات الشبكية التي أحدثها تشابك الواقع بالافتراضي، مبرزة أن مجتمع الشبكات ليس افتراضيًا بحتًا، بل يجمع علاقات وروابط وثيقة الصلة بين الشبكات الرقمية والشبكات في الحياة الاجتماعية الواقعية، مركزة على أن الفضاء الاستقلالي الرقمي هجين مبني على الواقعي والافتراضي.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن من بين الخلاصات التي توصلت إليها الباحثة في هذا المضمار، هو أن توظيف جيل الشبكيين لمواقع التواصل الاجتماعي، جاء من أجل العودة السياسية والالتحام بقضاياها ومشاكلها، على النحو الذي يجعلهم قوة ضاغطة على المسؤولين وصانعي السياسات والسلطات، وهو النهج إياه الذي يسير عليه بعض الصحافيين تجاه قضايا بعينها، سواء تعلق الأمر بمحاربة الفساد أو غيره، إذ برز معه ما يسمى «الصحافي المناضل».
بهذا المعنى، أصبح فضاء الشبكات الرقمية الذي تنتجه وتبنيه شبكة الإنترنت اليوم، بمنزلة البنية الرئيسية للحوار والنقاش وتكوين رأي عام وطني من أسفل، ولا سيما أن أغلب الناس يلجون هذه الفضاءات من أجل إسماع صوتهم والتعبير عن غضبهم، كما هي حال الصحافيين مع قضايا الرأي العام.
يناقش الفصل السابع الديناميات الناتجة من الحضور في فضاء الشبكات الرقمية، من صعود ديني وتشبيك تضامني وتفاوت اجتماعي، من خلال تحليل المضامين والمعاني التي يهبها الفاعل في هذه الفضاءات الرقمية (ص 299 – 300).
وخلصت الباحثة في هذا السياق، إلى أن فضاء الاستقلالية أو ما يمكن أن تسميه الـ «بين – بين» الواقعي والافتراضي ما زال واقعًا ضمن منطقة رمادية ودينامية غير قابلة للتشكل أو للتحديد النهائي، فمن الديني إلى التضامني ومن الحضور والتفاعل إلى الاستبعاد والتفاوت (ص 354 – 370).
مناقشة ختامية
يثير كتاب الشبكات الرقمية ودينامية الحقل الاجتماعي/السياسي بالمغرب الكثير من الإشكالات والتساؤلات في خصوص الشبكات الاجتماعية بوصفها ظاهرة اجتماعية كلية، انتقلت من مجرد تمثل طبيعي في مجتمع بشري إلى فضاء أوسع وأكثر تقنية، ما أعطى للبعد الشبكي دورًا مهمًا في بناء الأنساق، وتكوين الأدوار والهويات (ص 379). وفي نظر المؤلفة، فالشبكات الرقمية أنتجت فضاءات اجتماعية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وهو أمر يدعونا إلى توسيع اهتمامنا بالظروف الاجتماعية والسياسية والجمالية لفضاء الشبكات.
وتتمثل الأهمية المعرفية لهذا العمل بمد الباحث في العلوم الاجتماعية بمادة معرفية، وبأن مدخل مجتمع الشبكات الرقمية في الدرس السوسيولوجي من أهم المداخل العلمية في الآونة الراهنة، من أجل فتح آفاق ومساحات فكرية داخل الدراسات الاجتماعية، وذلك من أجل فهم أوسع وأدق للشبكات الرقمية وتداخلها بين الواقعي والافتراضي.
أخيرًا، يبدو أن قراءة هذا العمل ممتعة ومفيدة نظرًا إلى غزارة المعلومات ودقة التحليل، إذ نجحت الباحثة، بمنهجية السوسيولوجي في سبر أغوار موضوع شائك ومعقد، ويعُجُّ بالكثير من المعطيات المثيرة، ولا سيما أنه مجال بحثي ناشئ وسائل ويتطور باستمرار.
المصادر:
نُشرت هذه المراجعة في مجلة المستقبل العربي العدد 551 في كانون الثاني/يناير 2025.
ياسين حكان: باحث في علم الاجتماع، حاصل على الماجستير في الهجرة والديمغرافيا والتنمية من جامعة ابن زهر، أكادير – المغرب.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.