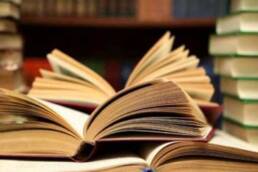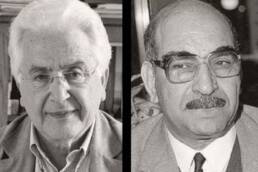المصادر:
نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 553 في آذار/مارس 2025.
سعيد شكاك: أستاذ باحث في جامعة شعيب الدكالي في الجديدة – المغرب.
[1] «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)،» 9 أيار/مايو 1992، <https://rebrand.ly/d2f834> (استرجع بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2022).
[2] Anne-Claude Ambroise-rendu, «Médias et protection de l’environnement (19e-21e siècles),» Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, <https://ehne.fr/fr/node/14144> (consulté le 10 septembre 2022).
[3] Ibid.
[4] وفق التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة في شأن تغيُّر المناخ، هو كل تغيُّر في المناخ يُعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يؤدي إلى تغيُّر في تكوين الغلاف الجوي العالمي الذي يلاحظ إضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى مدد زمنية مماثلة. كما يعد تغيُّرًا في المناخ كل تحول طويل الأجل في أحوال الطقس (بما في ذلك ارتفاع متوسط قيم درجة الحرارة وهطول الأمطار). للمزيد انظر: المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، نيويورك 9 أيار/مايو 1992.
[5] للمزيد انظر: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إدماج مقتضيات التغيرات المناخية في السياسات العمومية (فاس: مطبعة سيباما، 2015)، ص 29.
[6] أسمهان بنفرج، «الوعي البيئي وتشكل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس،» عمران للعلوم الاجتماعية، السنة 11، العدد 41 (صيف 2022)، ص 38.
[7] عبد الحميد العبيدي، «محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع نقد مسار نقد الحداثة،» عمران للعلوم الاجتماعية، السنة 8، العدد 31 (2020)، ص 118.
[8] بنفرج، المصدر نفسه، ص 38.
[9] صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب؛ تقديم صلاح قلنصوة (القاهرة: دار سطور، 1999)، ص 412.
[10] عبد الناصر هيجانة، «الإعلام الأخضر: دور الإعلام في تنمية الوعي البيئي،» مؤمنون بلا حدود، 9 أيلول/سبتمبر 2022، <https://cutt.us/CHV7p>.
[11] الحبيب استاتي زين الدين، «الحركات البيئية ورهان العدالة الإيكولوجية في المنطقة العربية: حالة لبنان وتونس والمغرب،» مجلة تجسير (مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قطر)، السنة 4، العدد 2 (2002)، ص 47.
[12] يقصد بالوعي البيئي الإدراك الثقافي للبيئة والإحساس بالمسؤولية تجاهها، والسعي لإيجاد السبل للعمل فرديًا وجماعيًا على المحافظة عليها. وحتى يكون الفرد مدركًا ومتفهمًا ومهتمًا بحمايتها من المخاطر، للمزيد، انظر: بنفرج، «الوعي البيئي وتشكل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس،» ص 43.
[13] للاستزادة، انظر: تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لسنة 2022: التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصف، ص 20.
[14] المصدر نفسه، ص 20.
[15] هيجانة، «الإعلام الأخضر: دور الإعلام في تنمية الوعي البيئي».
[16] الأمم المتحدة، تقرير حول التكيف مع التغيرات المناخية: التحدي الجديد للتنمية في العالم النامي (تموز/يوليو 2008)، ص 27.
[17] درويش مصطفى الشافعي، «الإعلام والبيئة: علاقة شائكة ومتباعدة،» الحوار اليوم (آذار/مارس – نيسان/أبريل 2012)، <https://www.alhiwartoday.net/node/10436> (استرجع بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2022).
[18] Deepti Ganapathy, Media and Climate Change Making Sense of Press Narratives (London: Routledge, 2022), p. 130.
[19] سعيد المتوكل، «التغيرات المناخية بالمغرب،» (رسالة ماستر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، 2003)، ص 15.
[20] تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. وتعدّ سلوكًا ملزمًا لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد. للمزيد انظر: القانون الإطار رقم 12 – 99 بمنزلة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 6240 (بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435، الموافق 20 آذار/مارس 2014).
[21] الأمم المتحدة، تقرير حول التكيف مع التغيرات المناخية: التحدي الجديد للتنمية في العالم النامي، ص 7.
[22] الحبيب استاتي زين الدين، «الحركات الخضراء.. والإعلام البيئي.. نحو عدالة إيكولوجية مستدامة،» مجلة الإذاعات العربية، العدد 1 (2022)، ص 122.
[23] الحبيب استاتي زين الدين، «المدرسة المغربية في ظل التحولات التكنولوجية والقيمية،» تبين، العدد 16 (2016)، ص 175.
[24] Mike S. Schäfer, Climate Change and the Media (Zürich, Switzerland: Universität Zürich, Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung, 2015), p. 853.
[25] سعيد شكاك، «الحق في الوصول للمعلومات برهان لتخليق الحياة الإدارية بالمغرب،» المستقبل العربي، السنة 44، العدد 516 (شباط/فبراير 2022)، ص 123.
[26] للاستزادة، انظر: شهيرة بولحية ودنيا زاد سويح، «الإعلام البيئي: مفهومه ودوره في نشر الوعي البيئي،» مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، السنة 3، العدد 1 (حزيران/يونيو 2020).
[27] James Painter, Climate Change in the Media Reporting Risk and Uncertainty (London: I. B. Tauris and Co. Ltd., 2013), p. 7.
[28] Ibid., p. 7.
[29] زين الدين، «الحركات الخضراء.. والإعلام البيئي.. نحو عدالة إيكولوجية مستدامة،» ص 121.
[30] مهدي بناني، «الإعلام الأمني أو الوظيفة الإعلامية للأمن،» مجلة الشرطة، العدد 12 (تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، ص 32.
[31] للمزيد، انظر: مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول «الحق في الحصول على المعلومات»، رقم التسجيل 21، تاريخ التسجيل بالبرلمان، 23 تموز/يوليو 2012، ص 2.
[32] حسام الدين الأهواني، «الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآلي،» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية (جامعة عين شمس)، العدد 1 (كانون الثاني/يناير 1990)، ص 1 – 5.
[33] للمزيد، انظر: حسني رفعت حسني، «قضية التغير المناخي في الإعلام العربي،» الجزيرة نت، 18 شباط/فبراير 2019، <https://rebrand.ly/43e84b> (استرجع بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022).
[34] زين الدين، «الحركات الخضراء.. والإعلام البيئي.. نحو عدالة إيكولوجية مستدامة،» ص 121.
[35] فادية عمر الجولاني، المجموعات الاجتماعية والمجتمعات المحلية، مبادئ علم الاجتماع (القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة 1993)، ص 304.
[36] سعيد بحير، التحليل السيكولوجي للذات السياسية، سلسلة الاستشارة السيكولوجية والمساعدة التربوية؛ الكتاب الثالث (الرباط: مطبعة طوب بريس، 2012)، ص 77.
[37] محمد الغالي، «الإعلام والديمقراطية المحلية: مداخل للفهم والتفسير،» مجلة نوافذ، العددان 45 – 46 (تشرين الثاني/نوفمبر 2010)، ص 51.
[38] جمال خلوق، «التدبير الترابي بين إكراهات الواقع وحتمية التنمية،» (رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق بسطات، 2007 – 2008)، ص 178.
[39] بنفرج، «الوعي البيئي وتشكل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس،» ص 38.
[40] المصدر نفسه، ص 38.
[41] عبد اللطيف بن صفية، «تحولات القطاع الإعلامي السمعي البصري بالمغرب ورهاناته المجتمعية،» فكر: مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية، العدد 7 (2016)، ص 97.
[42] محمد الرحماني، «وسائل الإعلام والأمن،» مجلة الشرطة، العدد 12 (تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، ص 32.
[43] المصدر نفسه، ص 31.
[44] المهدي المنجرة، قيمة القيم: لنا التلفزة التي نستحق (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2007)، ص 218.
[45] علي عبد الفتاح كنعان، الإعلام والمجتمع (عمّان: دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2014)، ص 9.
[46] Deepti Ganapathy, Media and Climate Change Making Sense of Press Narratives (London: Routledge, 2021), p. 130.
[47] زين الدين، «الحركات الخضراء.. والإعلام البيئي.. نحو عدالة إيكولوجية مستدامة،» ص 121.
[48] الشافعي، «الإعلام والبيئة: علاقة شائكة ومتباعدة».
[49] زين الدين، المصدر نفسه، ص 121.
[50] المصدر نفسه.
[51] للمزيد، انظر: المادة 25 من القانون الإطار الرقم 12 – 99 بمثابة «ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة»، الجريدة الرسمية، العدد 6240 (بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435، موافق 20 آذار/مارس 2014).
[52] للاستزادة، انظر: «الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة» في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والعشرين لتغير المناخ (COP23)، مدينة بون الألمانية، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، <https://rebrand.ly/0ac266> (استرجع بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2023).
[53] للمزيد، انظر: «رؤية مصر 2030،» <https://rebrand.ly/4331b2> (استرجع بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2022).
[54] للمزيد، انظر: قرار رئيس مجلس الوزراء الرقم 1129 لسنة 2019 المتعلق بـ «التغيرات المناخية»، الجريدة الرسمية، الرقم 18 مكرر في 7 أيار/مايو 2019، السنة الثانية والستون، جمهورية مصر العربية، ص 3.
[55] للمزيد، انظر: «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050 بالإمارات،» <https://rebrand.ly/55589e> (استرجع بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2022).
[56] المصدر نفسه.
[57] للاستزادة، انظر: «الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات،» <https://rebrand.ly/699a86> (استرجع بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2023).
[58] المصدر نفسه.
[59] المصدر نفسه.
[60] نزيهة وهابي، «الإعلام ودوره في تشكيل الوعي البيئي… نظرة شاملة حول جدلية العلاقة والتأثير،» مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، السنة 9، العدد 2 (2016)، ص 193.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.