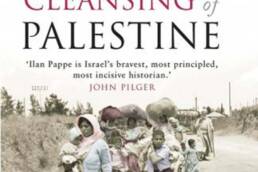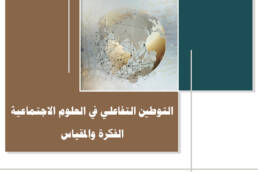المؤلف: نجيب عيسى
مراجعة: قسم التوثيق والمعلومات في مركز دراسات الوحدة العربية
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
سنة النشر: 2025
عدد الصفحات: 400
يرصد هذا الكتاب مسار الاقتصاد اللبناني وأداءه التنموي على مدى ثمانين عامًا بعد الاستقلال، وذلك في مقاربة تقع على طرف نقيض من الأدبيات التي تأخذ في الرؤية الشيحية (نسبة إلى ميشال شيحا) للاقتصاد اللبناني؛ تلك الرؤية التي سادت في أوساط النخب السياسية والاقتصادية قبل الحرب الأهلية وحتى اليوم، ومفادها أن الاقتصاد اللبناني كان منذ الأزل، وعليه أن يستمر، قائمًا على الأقانيم الثلاثة: أن يكون حصرًا اقتصاد تجارة وخدمات، وأن يستمر نشاط اللبنانيين الاقتصادي مع الخارج وفي الخارج، وأن هذا الاقتصاد لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا في ظل أعلى درجات الليبرالية وامتناع الدولة عن ممارسة أي دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا يصب في خدمة المبادرة الفردية والقطاع الخاص.
وفي تتبعه المسار التاريخي للاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي، يتناول الكتاب العوامل التي حكمت هذا المسار وتداخلت في مختلف المراحل التي مر بها وهي: الخارج، نظام الطائفية السياسية، ونموذج الاقتصاد غير المنتج، بحيث بات من غير الممكن فهم طبيعة الاقتصاد اللبناني ومساره، من خارج العلاقة العضوية/البنيوية التي ربطت العوامل الثلاثة.
يعرض مؤلف الكتاب لدور الخارج (الغرب الرأسمالي الاستعماري) منذ القرن التاسع عشر، في إنشاء الركيزتين الأساسيتين، أي نظام الطائفية السياسية في جبل لبنان والاقتصاد غير المنتج (واقتصاد الوساطة في بيروت) التي قام عليهما الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي. وكان ذلك من مقتضيات الدور الوظيفي الذي حدده الغرب لجبل لبنان وبيروت كمنصة ينطلق منها لبسط نفوذه السياسي والاقتصادي على الداخل العربي. ثم يتناول الانتداب الفرنسي الذي جاء لينشئ لبنان الكبير ويكرِّس، في الوقت نفسه، الدور الوظيفي للكيان الجديد بالتلازم مع نظام الطائفية السياسية على صعيد الحكم المحلي، وتعزيز اقتصاد الوساطة في بيروت. ويكشف عن سياسات سلطة انتداب لبنان الكبير التي أبقت لبنان مجالًا جغرافيًّا يجمع مناطق وطوائف متفاوتة كثيرًا في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، منقسمة حول هويتها الوطنية وتمارس فيه النخب (البرجوازية)، ولا سيَّما المسيحية منها، هيمنة على المستويين السياسي والاقتصادي. ويتناول بالتفصيل مسار الاقتصاد اللبناني وأداءه التنموي والعوامل الرئيسية التي تحكمت في هذا المسار بعد الاستقلال ولغاية أيامنا هذه. وفي هذا السياق، يوضح كيف أن النخب البرجوازية المسيحية في الجمهورية الأولى التي ترعرعت في ظل الانتداب الفرنسي وتشرَّبت الرؤية «الشيحية» لمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، هي نفسها التي أمسكت فعليًا بزمام السلطتين السياسية والاقتصادية. وعلى الرغم من النصوص التي تضمنها الدستور، وبيانات حكومات الاستقلال الأولى التي أعلنت الالتزام بالتخلص من نظام الطائفية السياسية ووضع لبنان على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فقد أعيد إنتاج النظام السياسي نفسه واقتصاد الوساطة عينه، في ظل أعلى درجات الليبرالية. وحصل ذلك بالتزامن مع تجدد وتوسع الدور الوظيفي الإقليمي السياسي والاقتصادي للبنان، نتيجة المتغيرات التي لحقت بعلاقات التبعية التي تشد المنطقة العربية إلى المراكز الرأسمالية الغربية. وقد استمرت التفاوتات الاقتصادية الاجتماعية العميقة بين مختلف المناطق والطبقات والطوائف في لبنان، إذ إن ما عُرف بـ «الازدهار الاقتصادي» لم يتركز فعليًا إلا في بيروت ومحيطها القريب من جبل لبنان، وهو ما زاد الأزمات حدةً وأخذت في نهاية الأمر الطابع السياسي الطائفي فسقطت الجمهورية الأولى في حرب أهلية مديدة ومدمرة لم تستطع تجربة فؤاد شهاب «الإصلاحية – التنموية» توفير المقومات اللازمة لتجنبها. وترافقت الحرب مع متغيرات اقتصادية واجتماعية ارتسمت خلالها المعالم الرئيسية للاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي في الجمهورية الثانية التي انبثقت من «اتفاق الطائف» أو وثيقة الوفاق الوطني.
ويؤكد المؤلف أنه على الرغم مما أُعلن من التزام بالعمل على التخلص التدريجي من نظام الطائفية السياسية ووضع لبنان على سكة الإنماء المتوازن، فإن الجمهورية الثانية، أعادت ثانيةً إنتاج النظام السياسي الطائفي والاقتصاد غير المنتج، ولو بأشكال مختلفة؛ فالنظام السياسي الذي كان برأس طائفي واحد (ماروني) بات برؤوس متعددة الانتماءات الطائفية. وجاءت الطبقة الحاكمة خليطًا من أمراء الحرب ورجال أعمال، تقاسموا الحصص والمواقع في مؤسسات الدولة السياسية والإدارية، وتمادوا في حسبان السلطة السياسية مصدرًا لاستخراج الريوع اللازمة لمراكمة ثرواتهم الشخصية وتعزيز مواقعهم داخل طوائفهم. ومع أفول دور لبنان الاقتصادي الوظيفي في المنطقة وفشل «الحريرية السياسية» في إعادة إحياء هذا الدور، لم ترَ الطبقة المذكورة من سبيل لتعزيز مواقعها سوى الاستمرار في نهب المال العام، والسير بالمخطط «البونزي» الذي يقضي بالاستمرار في الاستدانة لمعالجة العجز المالي المتزايد المتأتي من نهبها هذا المال وإهمالها المتعمد للنظام الضريبي التصاعدي على الدخل والثروة، والامتناع عن الاستثمار في قطاعات الإنتاج القابل للتداول في الأسواق العالمية. وأدى استمرار هذا الوضع إلى نشوء نموذج جديد من الاقتصاد غير المنتج، يغلب عليه الطابق الريعي، يقوم على الاستدانة التي تغذيها التدفقات المالية الخارجية والتي تمثل تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج رافدها الرئيسي.
ولم تعرف الجمهورية الثانية إلا استقرارًا نسبيًا تحت الوصاية السورية التي قامت بدور الضابط للتناقضات العميقة، والتي استمرت فاعلة داخل السلطة السياسية وخارجها، في حدود تجعلها لا تهدد السلم الأهلي. وبعد خروج الجيش السوري دخل لبنان في مسلسل من الأزمات، وصولًا إلى أزمة النظام السياسية الاقتصادية الاجتماعية العامة التي يعانيها لبنان في الوقت الحاضر. لكن أي تغيير نوعي مطلوب لم يحدث للشروع ببناء «الدولة التنموية» مع استمرار التفاعل بين العوامل الثلاثة (الخارج، الطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج) التي حكمت مسار الاجتماع اللبناني السياسي. وبالتالي استمر نظام الطائفية السياسية وتعثر وضع لبنان على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. لقد تزايدت الانقسامات العمودية في المجتمع اللبناني وبخاصة الطائفية منها، وطغت إلى حد بعيد، على الانقسامات الأفقية والطبقية منها بوجه خاص، وحالت في الوقت نفسه من دون توليد دينامية محلية ذاتية للتغيير. ومع الشلل المحلي عاد الخارج العامل الرئيس يتحكم بالمنحى الذي أخذه المسار التاريخي للاجتماع اللبناني بوجه عام وشقه الاقتصادي بنوع خاص.
وفي ضوء هذه الخلاصة، يحاول المؤلف استشراف ما يمكن أن تؤول إليه الأزمة التي يعانيها لبنان منذ انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 حتى الوقت الحاضر. وفي هذا السياق، يرى أن الظروف الملائمة لصعود قوة اجتماعية سياسية جديدة وازنة وقادرة على الإمساك بزمام السلطة السياسية والتعامل مع العوامل التي أعاقت التنمية في لبنان، لم تنضج بعد. لذا كان مصير هذه الأزمة الراهنة كمصير الأزمات التي سبقتها، إذ استمرت جزءًا لا يتجزأ من أزمة المنطقة السياسية والاقتصادية التي هي في جوهرها، أزمة حركة تحرر وطني لم تتوصل إلى تخليص هذه المنطقة من النفوذ الإمبريالي الغربي والاحتلال الصهيوني لفلسطين ووضعها على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستقلة ودولة المواطنة الديمقراطية. وإلى أن تنضج الظروف لتحقيق هذه المهمة التاريخية، فإن مآل الأزمة اللبنانية يرتبط بما سيرسو عليه الصراع الوجودي في المنطقة بين محور المقاومة والكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب عمومًا بعد «طوفان الأقصى» وحرب الإبادة المستمرة على غزة والعدوان على لبنان وسقوط النظام السابق في سورية. ولعل ما ينتظر لبنان تحديدًا، في المدى القريب، في ظل محاولة الولايات المتحدة تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية للشرق الأوسط على أسس طائفية وإثنية، ربما لا يتعدى بعض الاستقرار بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة يكون من ضمن مهماتها وضع «خطة تعافٍ» تحاول الجمع بين شروط صندوق النقد الدولي ومصالح القوى الاقتصادية والسياسية النافذة.
اضغطوا على الرابط للحصول على الكتاب ورقياً أو الكترونياً عبر موقعنا:
اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية: جدلية الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج
المصادر:
نُشرت هذه المراجعة في مجلة المستقبل العربي العدد 556 لشهر حزيران/يونيو 2025.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.