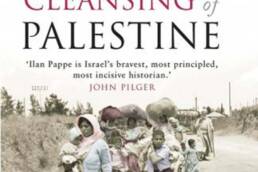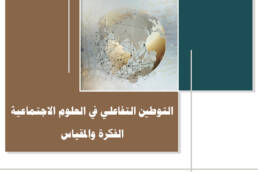المؤلف: أوليفييه مارتن
ترجمة: الزواوي بغورة وسماعين جلة
مراجعة: مبروك بوطقوقة
الناشر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت
سنة النشر: 2023
عدد الصفحات: 340
– 1 – نحنُ نعيش في عالمٍ تسيطر فيه الأرقام على جميع جوانِب حياتنا، من القياسات الكميَّة إلى الإحصاءات والمؤشرات. أصبحت الأرقام أداةً رئيسية لفهم العالم بما أدى إلى حالة من الاعتماد الكبير عليها في تفسير وتوجيه ماجريات الحياة، واستخدامها في مجموعة واسعة من السياقات، بدءًا من قياس الأطوال والأوزان والسرعات والكميات، وصولًا إلى تقييمات الأداء والتحليلات المالية والاجتماعية، وفي قياس الكميات والحجوم والمدد الزمنية والترددات، ولضبط النسب والحجوم في التحليلات البيولوجية، ولإعداد الترتيبات وسباقات الأداء، وفي المحاسبة والمالية، وفي تحديد المواقع عبر الهواتف… وغيرها. ويثيرُ هذا الاعتماد المتزايد على الأرقام تساؤلاتٍ حول فائدتها ودورها وأصلها وتأثيرها. يُصارحنا صاحب هذا المؤلَّف أولييفيه مارتن (وهو عالم اجتماع وخبيرٌ إحصائيٌّ ومحاضرٌ في علم الاجتماع في جامعة جامعة باريس 5 – ديكارت، ومدير مركز أبحاث الروابط الاجتماعية (CERLIS) والمتخصص في علم اجتماع القياس الكمّي (الإحصاء والمجتمع) وعلم اجتماع الأوساط الأكاديمية وعلم اجتماع العلوم وكذلك علم اجتماع التقنيات الجديدة واستخداماتها)، بأنه على الرغم من أن «إمبراطورية الأرقام» تبدو عظيمةً، إلا أنها تحملُ في طيَّاتها مفارقة؛ فهي قويَّةٌ وهشَّة في آنٍ واحد، وهي بالرغم من أنها تبدو فواعلَ قوية تُظهر الحقائق، وتُقلق، وتُخنق، وتُغضب، وتُطمئن، وتدفع إلى التفكير، فهي في الوقت نفسه يمكن التَّلاعبُ بها، والمبالغة فيها، وتشويهها؛ يمكن الاحتراز منها أو الوثوق فيها، واللعب بها أو الاختفاء وراءَها.
إن صفحات هذا العمل المترجم الذي نشرته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعكف على ترجمته الزواوي بغورة من جامعة الكويت وسماعين جلة من جامعة الجزائر بلغةٍ واضحة وسَلِسة القراءة، وتتدفق بشكل على نحوٍ من دون أيّ انقطاعات أو صعوبات في الفهم، مع استخدام مكافئات مناسبة وسليمة نحويًا، ومن طريق نقل المعنى الأصلي على نحو دقيق يحافظ على الأفكار الرئيسية والتفاصيل المهمة، تتوزَّع صفحات الكتاب على قسمين رئيسين يجمعان عشرة فصول تتضمن عرضًا مستفيضًا لتطور استخدام لغة الأرقام في القياس والتكميم، وتتضمن معلومات وتفسيرات وتواريخ تمسك بيد القارئ لتأخذه لاستكشاف أسرار «إمبراطورية الأرقام»؛ إمبراطورية لا يستطيع أحد الإفلات من سطوتها من حيث إنها تحاصرنا في كل مكان. فهذه الإمبراطورية أكثر شساعة وكثافة. ومع ذلك يتغيّا أوليفييه مارتن، وهو عالم الاجتماع والخبير الإحصائي، الكشف عن ملامحها ومنطقها في كتاب يضم أكثر من 300 صفحة منطلقًا من مجموعة من الأسئلة التي يحاول بمنهجية البحث الأكاديمي إيجاد أجوبة لها، ولكنها أجوبة تظل مفتوحة وقابلة للإضافة أو النقد، غير أنها تُشبع فضولنا في فهم الأرقام وقوتها وميادين استخداماتها. وقبل أن يبذل أوليفييه مارتن هذا الجهد في الشرح والتفسير والتدليل، ينطلق من فرضية أساسية تقوم على التعامل مع الأرقام بوصفها واقعة اجتماعية ودراستها بواسطة علم اجتماع خاص بالقياس الكمي (أو التكميم). ومن بين ما يثيره الكاتب من أسئلة: ما فائدة كل هذه الأرقام؟ وما دورها هنا؟ ومن أين أتَت؟ وما هي الآثار المترتبة عن حضورها في كل الأحوال؟ وهل يكون في وسعنا أن نتصوّر هذه الأرقام في مجملها؟ وهل تجمعها في طبيعتها نقاطٌ أو قواسم مشتركة، أم أنها تنتمي في جميع فئاتها إلى أنواع مختلفة من المنطق؟ أهيَ بياناتٌ تعكس أغوار الواقع لعالمنا هذا؟ أم هي بناءاتٌ ذهنية لمحاكاة هذا الواقع؟ عن مثل هذه الأسئلة وعن أسئلة أخرى، يطمح هذا الكتاب إلى تقديم إجابات بالاستناد إلى أعمال جماعة من علماء الاجتماع والمؤرخين والأنثروبولوجيين.
– 2 – في الفصل الأول، يتتبّع أوليفييه مارتن تاريخ التكميم ويؤكد أنه لا يخصّ المجتمعات المعاصرة وفقط، بل تعود آثاره إلى عهود غابرة استعمل فيها الإنسان البدائي العدّ والحساب. فلقد عرفت بلاد الرافدين الإشارة إلى الأرقام التي كانت تعبّر عنها اللغة المسمارية بحيث كانت الألواح الطينية المدوَّنة بالخط المسماري ترمز إلى عمليات حسابية وإلى مبادلات تجارية وأنشطة اقتصادية وأوزان أو إلى أعداد العبيد والجنود… إلخ. إضافة إلى ذلك، كانت شعوب هذه البلاد تستخدم القطع الدالة (jetons) لتحديد كمية الحبوب أو الماشية. وقد عَرفت الحضارة المصرية هي الأخرى استخدامات مُبتكَرة للترقيم والحساب مثل حساب ارتفاع مستوى فيضانات النيل وإحصاء الأراضي المزروعة ومسح الحقول… إلخ.
– 3 – أما الفصل الثاني، فيتناول تطور استخدامات الأرقام في قياس السلع والموارد منذ العصور القديمة وحتى العصور الحديثة. ويشير إلى أن القياسات كانت ضرورية لتبادل السلع والمواد الغذائية، وأنها كانت تتسم بتعقيد كبير بسبب التنوع الزمني والجغرافي. يعرض أولفييه مارتن هنا كيف أن الأنظمة القياسية لم تكن موحدة، وتغيرت وفق السلع والأقاليم والظروف الاجتماعية، بالقدر الذي يُبرز فيه أن القياسات كانت تعتمد على الجسم البشري كمصدر للوحدات، وأن تعدد الأنظمة لم يكن بالضرورة يعني الفوضى، بل كانت توفر الثقة والوضوح في التبادل التجاري. ثم تبلور بعد ذلك دور السلطة السياسية والاقتصادية في تحديد وتوحيد أنظمة القياس، إلى أن عرفت «أوزان القياس» شيئًا فشيئًا تطورًا عالميًّا صنعته حركتان: حركة التجريد – إضفاء الطابع العالمي، وحركة الاتجاه نحو توحيد الشكل. ويتضمن هذا الفصل مثالًا توضيحيًا في ذلك عن المتر والنظام المتري قبل أن يستعرض في ذات السياق الأصول الأولى للعوامل والممارسات التي تضمنتها هاتان الحركتان.
– 4 – يبحث الفصل الثالث أساسًا فرعًا رائجًا من التكميم، وهو قياس الزمن، بما تفصح عنه بعض الممارسات الحياتية اليومية كاستعمال رزنامة التواريخ والساعات وجداول التوقيت أو الوحدات التي ترمز إليها (ثانية، دقيقة، ساعة، الأيام، الفصول…). فالزمن عبارة عن واقعة اجتماعية، وهو ثمرة عمليات جماعية معقدة استطاعت أن ترسم في أذهان البشر وتمثّلاتهم «إيقاعاتٍ» عن الزمن تشتغلُ بوصفها معالم لتجاربهم ولتطوراتها. ويتضمن هذا الفصل تفسيرًا لتلك الإيقاعات بوصفها موضوعا فلسفيًا واجتماعيًا، وكيف أن الحاجة إلى القياس والتكميم لم تكن لضرروات علمية محضة، بل كانت، في المقام الأول، لحاجة اجتماعية. وقد كان من شأن التطورات الاقتصادية كالثورة الصناعية وما تبعها من حاجات اقتصادية وشؤون مهنية ومن تطور وسائل النقل والاتصالات كالسكك الحديد أن يدفع إلى قياس الزمن بدقة متناهية، فتطورت من جراء ذلك صناعة الساعات.
– 5 – يتضمن الفصل الرابع المعنون «التمثيل الإحصائي للمجتمعات» تحليلًا عميقًا لأهمية الإحصاء بوصفه أداةً لا غنى عنها في تطبيقات القياس الكمي للأفراد والمجتمعات، بالقدر الذي تستعمله يد الدولة لتعزيز سلطتها وإدارة شؤونها بفعالية. فمنذ العصور القديمة، استخدمت الدول الإحصاءات لتعداد السكان وتقدير الثروات بما مكَّنها من تنظيم الجيوش وجمع الضرائب وتوجيه الموارد بكفاءة. منحت هذه القدرة على جمع البيانات وتحليلها الدول نظرةً شاملة على مجتمعاتها، الأمر الذي ساعدها على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. ازدادت في العصر الحديث أهمية الإحصاء مع تعقُّد المجتمعات وتوسُّع نطاق الأعمال الحكومية، إذ أصبح يوفّر للحكومات معلومات دقيقة حول الصحة العامة، والتعليم، والاقتصاد، وهذا ما يساعد على صوغ السياسات العامة وتخصيص الموارد بصورة عادلة وفعالة.
وهكذا تُصبح الإحصاءات وسيلةً حيوية لتعزيز سلطة الدولة وضمان استقرارها وترسيخ تنميتها المستدامة. فتاريخيًا، مثَّل الإحصاء «علم إدارة الدولة»، الأهمية التي دفعت إلى تأسيس مراكز ومكاتب الإحصاء المركزية وظهور المجلَّات المتخصصة وإلى تطوير تقنيات الإحصاء والقياس التي انتقلت من مستوى كوْنها أداة علمية تستجيب للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطارئة إلى أداة مألوفة تخضع لروتين البحث العلمي.
– 6 – يغوض بنا الفصل الخامس في مناقشةٍ وإعادةَ تقييمٍ لفكرة شائعة تقول بأن العلم يفترض بالضرورة التكميم والقياس. فبعد «الثورة الكمية» التي شهدتها العلوم في القرون من السادس عشر إلى غاية التاسع عشر، تكرّس الاعتقاد بأنه يمكن لتطبيقات التكميم والقياس تحصيل «الدقة» العلمية المطلوبة وقياس مختلف الظواهر الطبيعية (الأرضية) والتعبير عنها بلغة عقلانيَّة ومعرفية وموحدة. لكن في حقيقة الأمر كانت – وما تزال – هناك اختلافات في الإحصاء بين المدارس الفرنسية والإنكليزية والألمانية، وفي تقاليد هذا الإحصاء بين نماذجه الوصفية والأدبية والأخرى الرياضية والتركيبية.
– 7 – أما الفصل السادس، فيناقش تطور مفهوم القياس الكمي وأهميته في المجالات العلمية المختلفة. يبدأ الفصل بشرح التحديات المرتبطة بقياس الظواهر الطبيعية، مثل درجة الحرارة، وأثر الثورات العلمية في القرن العشرين على مفاهيم القياس. ويبرز كيف قدم العلماء، مثل نورمان كامبل وستانلي سميث ستيفنز، أفكارًا جديدة حول تمثيل الخصائص الإمبريقية بالأعداد، ما وسع نطاق استخدام القياس الكمي. تُعرف نظرية «التمثيلية» التي طورها ستيفنز بفكرة أن القياس يتطلب بنى رياضية لتمثيل العلاقات بين الأشياء. وقد أثرت هذه الأفكار في مجالات متعددة، مثل الطب وعلم النفس، حيث أصبح القياس الكمي أداة أساسية لفهم وتحليل البيانات.
– 8 – يربط الفصل السابع بين تطوّر استخدام الأرقام وتطوّر مفهوم الدولة ومفهوم الفعل العام أو السياسات العامة. فقد فرضت استراتيجيات التحديث واللامركزية وعقْلنَة الموارد والإدارة الحديثة، وكل ما يشمله مصطلح «إعادة اختراع الحكومة»، كفاءةَ المنظمات والمؤسسات في حلبة التنافس الدولي في عصرِنا النيوليبرالي والثقافة السوسيو – تقنية. فرضت كل هذه العوامل إدارةَ العمل وتوجيهَ النشاطية وتقييمَ السياسات وكفاءةَ الأعمال بالاستناد إلى معطيات كمية، وأصبح كل شيء «قابلًا للحساب».
– 9 – يعالج الفصل الثامن إشكالية حياديَّة عمليات التكميم ووحدة أساليب القياس على المستوى العالمي. ويتوصل الكاتب بعد تتبّع الاختلافات في أساليب الحساب والقياس والتكميم عبر التاريخ إلى نتيجة مفادها أن «التكميم هو واقعةٌ اجتماعية» بحيث إن «الطابع الاجتماعي الذي يكون وراء هذه التطبيقات يثبت أن التكميم لا يكون بالضرورة، في بعض الأحوال والظروف، فعلًا لإنتاج المعرفة الحصيفة، فالتكميم يؤثر في المجتمع الذي – بدوره – يؤثر في التكميم». بالقدر نفسه، فإن القياس ليس فعلًا خالصًا، بل ينتج أحيانًا خيارات أكثر أو أقل وضوحًا. إن فعل التكميم هو في جانبه الآخر فعل مشروط بالخيارات، وهو ثمرةُ ثقافةٍ خاصة، وزمنٍ خاص، وسياق خاص. فليس هناك نموذج واحد للقياس، وليس التكميم معطىً طبيعيًا متاحًا للأفراد على نحو نهائي وثابت. عمومًا، فإن التكميم يُفرض أحيانًا على الأفراد في سياقات إضفاء الطابع العام وتوحيد الشكل والتعميم والقياس الموحد. لذلك ليست الأرقام – كما هو شائع – مصداقًا لـ «الحقيقة» الصرفة، وقد لا تكون صورًا حقيقة تقرأ واقعًا موضوعيًا بلغة الأرقام، بل قد تكون انعكاسًا لهذا الواقع والذي يساهم بطريقة أو بأخرى في بنائه، وتمثّله وتعريفه وتصنيفه.
– 10 – في الفصل التاسع، يغوص أوليفييه مارتن في إبراز دوافع التكميم، مُسلّطًا الضوء على تطوّر لغة الأرقام كأداةٍ أساسية للمعرفة الواضحة والعلمية، فيبيّن كيف ساهم التكميم في تبسيط الوقائع المعقدة وتفسيرها باستخدام القياس، من دون أن يغفل مناقشة عدم تطابقيَّة التكميم والعلمية على نحوٍ مُطلق. يسرد مارتن مسار ثقافة التكميم عبر مختلف الأنشطة العلمية والممارسات الاجتماعية أين ساهمت في توحيد الفهم بين الأفراد والمجتمعات والدول، مُغيّرةً من تمثُّلاتهم واعتقاداتهم حول الواقع المحيط. وفي هذا الصدد، يُسلّط الكاتب الضوء على دور الأرقام في عمل الحكومة وكفاءة الإدارة، مُبيّنًا كيف ساهمت في ممارسة السلطة من خلال لغة الأرقام التي بدورها أدت إلى تغيّرات في مفهوم القانون وحوْكمَة الأفراد، وتحوّل مفهوم الحكومة إلى مفهوم الحوْكَمة، والتشريع إلى التنظيم، والحكم إلى التقييم، والقاعدة إلى الموضوعي، والعدالة إلى الكفاءة، والحرية إلى المرونة، والقانون إلى البرنامج.
ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى وصف علاقة الأرقام بالعدالة، مُبيّنًا كيف يُمثّل القياس رمزًا لإحقاق العدالة وتحقيق المساواة، والأهم أنه يُشير هنا إلى آيات من القرآن الكريم تتحدث عن الوفاء في الميزان وإقامة الوزن بالقسط، مُؤكّدًا أنّ العدالة تكمن في القياس الصحيح الذي يشمل مختلف جوانب الحياة.
– 11 – يحاول أوليفييه مارتن في الفصل العاشر، بعد عرضه تاريخ «إمبراطورية الأرقام»، التأكيد أنّ التكميم يُمثّل لغةً وطريقةً لتمثيل العالم وتمثُّله، مُمكِّنًا الأفراد من التصرُّف آخذين في الحسبان الأرقام والإحصاءات والمؤشرات والتصنيفات في مختلف شؤونهم الحياتية. ويوضح في السياق ذاته كيف أنّ الأرقام تُمكّن من تحريك الفعل وردود الفعل وفق غاياتٍ مستقبليَّة محدَّدة واتجاهات معرَّفة وقياسات دقيقة. ومع ذلك، فالأرقام تمثل بالفعل خيارًا تعسفيًا في كثير من الأحيان، إذ نحن نقيس ونحسب ونُسلّط الضوء على ما نريد، بينما قد نتجاهل ما نرغب في حجبه. فالأرقام تمتلك قوةً سحريَّة في اختزال الشيء أو الواقعة الاجتماعية إلى رمزٍ، إلى رقمٍ أو مؤشّرٍ أو قياسٍ واحد.
– 12 – أخيرًا، يدعونا أوليفييه مارتن في مؤلفه هذا إلى التأمُّل في المكانة المتناميَة للأرقام في مجتمعاتنا، وهو عملٌ محفِّز وغنيٌّ بالمعلومات يقودنا إلى معرفة حقيقة «إمبراطورية الأرقام» التي تميّزها ثلاث سمات أساسية: القياس الكمي كأداة لتحقيق التنسيق والتبادل والتعاون؛ والقياس الكمي لأجل التصرف واتخاذ القرار والحُكم والحوكمة؛ وأخيرًا القياس الكمي بوصفه ممارسةً لأجل الدراية والمعرفة. إضافةً إلى ذلك، فقد تجاوز مارتن النهج التقني أو الإداري للأرقام من خلال تحليله البُعد السياسي الذي تستبطنه بما يجعلها تشتغل كوسائل للهيمنة الاجتماعية وليس فقط كأدواتٍ معرفيَّة وعلمية. غير أنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال تبنّي هذه الأطروحة التي قدمها مارتن بالمطلق، فالاعتماد على المؤشرات الكمية ليس شكلًا من أشكال الحوكمة التقنية والإدارة العامة الحديثة وفقط، ولا ينبغي تفسير ذلك كوسيلة صرفة للهيمنة، بل هي أيضًا جهودٌ حكوميَّة ومجتمعية متواصلة لتحسين الفعالية والشفافية والتغيير واتخاذ قراراتٍ مستنيرَة ورسم تخطيطٍ فعّال بما يساعد على التنسيق بين الأفراد والمؤسسات؛ ناهيك بأن صاحب الكتاب يتناول القيود أو التحديات المرتبطة بالتركيز المفرط على البيانات الكمية وفقط، وكان من المناسب التفكير في التكامل بين المناهج النوعية والكمية. إن ذلك لا ينفي أن أوليفييه استطاع الربط بين القضايا الفلسفية والمعرفية والتاريخية المتعلقة بالقياس الكمي، ولكن برَزت بعضُ المبالغةِ الطفيفة في النظر إلى الرقم كمحدّد أساسيّ وأوّليٍّ لميلاد السياسات وبروز الحضارات وحدوث التحولات الجوهرية في التاريخ.
عمومًا، يُقدم هذا النص تحليلًا شاملًا وعميقًا لموضوع القياس الكمي من منظور فلسفي واجتماعي؛ وهو يقدم رؤية متماسكة وموثَّقة حول أهمية هذا الموضوع وتطوره التاريخي. فهذه هي «إمبراطورية الأرقام» التي حاول مارتن التَّصدّي لدراستها وهو يستجمعُ خبرته العلمية والتكوينية ويتَّكئ على بيبليوغرافيا تضم نحو 542 مرجعًا من مختلف التخصصات عساهُ أن يكشِف عن لُغز الأرقام وسحرها وقوَّتها وأسرارها، وعسى أن تسمح هذه الترجمة للقارئ العربي باستكشاف تلك الخصائص والأسرار.
المصادر:
نُشرت هذه المراجعة في مجلة المستقبل العربي العدد 552 في شباط/فبراير 2025.
مبروك بوطقوقة: أستاذ محاضر، جامعة باتنة 1 – الجزائر.
مركز دراسات الوحدة العربية
فكرة تأسيس مركز للدراسات من جانب نخبة واسعة من المثقفين العرب في سبعينيات القرن الماضي كمشروع فكري وبحثي متخصص في قضايا الوحدة العربية
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.